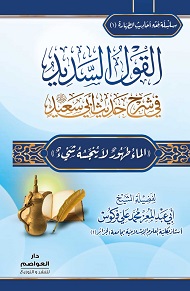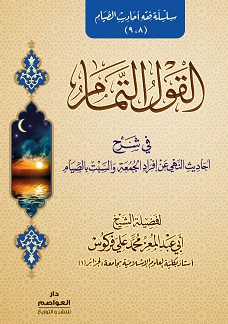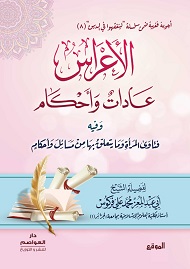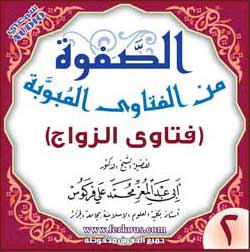الكلمة الشهرية رقم: ١٤٩

[الحلقة الثانية عشرة]
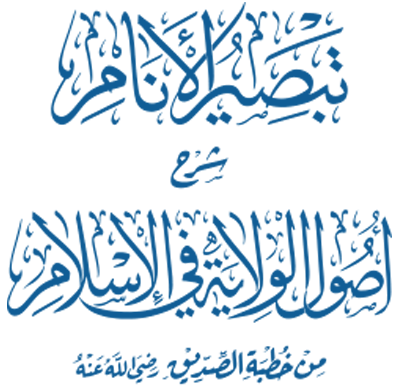
[ ١ ]
[الجزءُ الأَوَّلُ]
هذه أصولُ الولاية العامَّة مِنْ خُطبة أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه استخرجها الشَّيخُ عبدُ الحميد بنُ باديس ـ رحمه الله ـ حيث قال ما نصُّه:
«لَمَّا بُويِعَ لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه(٢) بالخلافة(٣) رَقِيَ المِنْبَرَ فخَطَب في النَّاس خُطبةً اشتملت على أصول الولاية العَامَّة في الإسلام(٤) ممَّا لم تحقِّقه بعض الأمم إلَّا مِنْ عهدٍ قريبٍ على اضطرابٍ منها فيه.
وهذا نصُّ الخُطبة:
«أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ؛ فَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِي؛ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ فِيكُمْ، فَإِذَا عَصَيْتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ؛ أَلَا إِنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ الحَقَّ لَهُ، وَأَضْعَفَكُمْ عِنْدِي القَوِيُّ حَتَّى آخُذَ الحَقَّ مِنْهُ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ»(٥)».
ـ يُتبَع ـ
(١) «الآثار» (٣/ ٤٠١).
(٢) هو الصَّحابيُّ الجليل: عبدُ الله بنُ عُثْمانَ بنِ عامرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبٍ التَّيْميُّ، أبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ بنُ أَبي قُحَافةَ رضي الله عنهما؛ خليفةُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وصاحبُه في الغار والهجرة، غَلَبَ عليه وعلى أبيه الكُنيةُ دُون الاسْمِ، وهو أوَّلُ مَنْ لُقِّب في الإسلام، وأوَّلُ مَنْ أَقام للمسلمين حَجَّهم في زمنِ النَّبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وأوَّلُ مَنْ دُعِيَ بخليفةٍ، وأوَّلُ مَنْ أمَّ في مِحرابِ رَسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ورَقِيَ مِنبرَه، وله مناقبُ وفضائلُ كثيرةٌ؛ تُوُفِّيَ قبل أبوَيْه سَنَةَ: (١٣ﻫ) عن ثلاثٍ وسِتِّين سَنَةً، ودَامَت خلافتُه سَنَتَيْن وثلاثةَ أشهرٍ وتسعةَ أيَّامٍ، ودُفِن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في بيتِ ابنته عائشةَ رضي الله عنها؛ [انظر ترجمته وأحاديثه في مُؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٢١)].
(٣) كانت خلافة أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه سَنَةَ إحدى عَشْرَةَ مِنَ الهجرة بعد وفاة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يومَ الإثنين ضُحًى، حيث اشتغل النَّاس ببيعة أبي بكرٍ رضي الله عنه في سَقِيفة بني سَاعِدَة مِنَ الأنصار، ثمَّ في المسجد بالبيعة العامَّة في بقية يوم الإثنين وصبيحةِ الثلاثاء، فلمَّا بُويِعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أقبل النَّاسُ على جهاز رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بقيةَ يومِ الثلاثاء، ودفنوه ليلةَ الأربعاء؛ [انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢/ ٣٢٥، ٣٣٢)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ٣٠١)].
(٤) والمراد بالوِلاية العامَّة ـ بالكسر ـ: السُّلطان والإمارة والمُلك، [انظر: «الكليات» لأبي البقاء (٩٤٠)، و«المعجم الوسيط» (٢/ ١٠٥٨)]؛ وهي رئاسةٌ عامَّةٌ ورعايةٌ تامَّةٌ وإمامةٌ كبرى موضوعةٌ لخلافةِ النُّبوَّة في حِراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا، [انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (٥)، «مقدِّمة ابن خلدون» (١٧٠ ـ ١٧١)].
ولا تخفى أهمِّيَّةُ منصب إمامة المسلمين باعتبارها أمانةً عُظمَى ومسؤوليةً كبرى ونيابةً خطيرةً عن صاحب الشريعة في حفظ الدِّين وسياسةِ الدُّنيا: «لأنَّ المقصود مِنْ نَصْبِ الإمام الأَعْظَمِ هو اجتماعُ الكلمةِ ولَمُّ الشَّمل، وإقامةُ الدِّينِ وتنفيذُ أحكام الله تعالى، ورَفْعُ الظُّلمِ ونَشْرُ العدل، وصيانةُ الأعراضِ واستِتْبَابُ الأمن، وفضُّ المُنازَعات، والأخذُ على يَدِ الظَّالم وإنصافُ المظلوم، وجهادُ أعداءِ الإسلام، وحمايةُ حوزةِ البلاد، وإقامةُ الحجِّ والجُمَع والأعيادِ، وحِفْظُ بَيْضةِ المسلمين، وقَمْعُ الشَّرِّ والفساد، وأَخْذُ الحقوقِ الواجبةِ على ما اقتضاهُ الشَّرعُ، ووَضْعُها في مَواضِعِها الشرعية»؛ [انظر مؤلَّفي: «منصب الإمامة» (١٥ ـ ١٦)]، وإلى غير ذلك مِنْ مقاصد الإمامة العُظمى التي لا يَسَعُ القيامُ بها والعمل على تحقيقها إلَّا تحت إمرةِ حاكم، ولا تنتظم مصالح الأُمَّة إلَّا بسلطةِ إمامٍ مُطاع، ولا يستطيع القيامَ بها إلَّا إذا كان على درجةٍ مِنَ التأهُّل تمكِّنُه مِن حملها.
قال أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ [في «الاقتصاد في الاعتقاد» (١٤٨ ـ ١٤٩)] ـ بيانًا لأهمِّية هذا المنصب وخطورة مسؤوليته وآثاره ـ ما نَصُّه: «إنَّ الدُّنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلَّا بسلطانٍ مُطاعٍ؛ فتشهد له مشاهدةُ أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمَّة، وإنَّ ذلك لو دام ولم يُتدارَك بنصب سُلطانٍ آخَرَ مُطاعٍ دام الهرْجُ وعمَّ السَّيف، وشَمِلَ القحطُ وهَلَكت المواشي، وتعطَّلَتِ الصناعات، وكان كلُّ مَن غَلَب سَلَب، ولم يتفرَّغ أحدٌ للعبادة والعِلم إن بقي حيًّا، والأكثرون يهلكون تحت ظِلال السُّيوف، ولهذا قيل: الدِّين والسُّلطان توأمان، ولهذا قيل: الدِّين أُسٌّ والسُّلطان حارسٌ، وما لا أُسَّ له فمهدوم، وما لا حارسَ له فضائعٌ.
وعلى الجُملة لا يتمارى العاقل في أنَّ الخَلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه مِن تشتُّتِ الأهواءِ وتبايُنِ الآراءِ لو خُلُّوا وشأنَهم ولم يكن لهم رأيٌ [كذا، ولعلَّ الصوابَ: رأسٌ] مُطاعٌ يَجمع شتاتَهم لهلكوا مِنْ عِند آخرِهم، وهذا داءٌ لا علاجَ له إلَّا بسلطانٍ قاهرٍ مُطاعٍ يجمع شتاتَ الآراءِ؛ فَبَانَ أنَّ السلطان ضروريٌّ في نظام الدِّين ونظامِ الدُّنيا، ونظامُ الدُّنيا ضروريٌّ في نظام الدِّين، ونظامُ الدِّين ضروريٌّ في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعًا؛ فكان وجوبُ نصب الإمام مِنْ ضروريَّات الشَّرع الذي لا سبيلَ إلى تركه».
وقد حكى غيرُ واحدٍ مِنْ أهل العلم كابن حزمٍ وابنِ تيمية والنَّوويِّ وابنِ خلدون والهيتميِّ ـ رحمهم الله ـ إجماعَ أهل السُّنَّة والجماعةِ قاطبةً، بل اتِّفاقَ السَّواد الأعظم مِنَ المسلمين ـ على اختلاف طوائفهم ـ على وجوب نصب الإمام الأعظم، ولم يَشُذَّ عن ذلك إلَّا النَّجداتُ مِنَ الخوارج ونفرٌ مِنَ المعتزلة.
وتقريرًا لهذا الإجماع قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ [في «الفصل» (٤/ ٨٧)]: «اتَّفق جَمِيع أهل السُّنَّة، وَجَمِيعُ المرجئة، وَجَمِيع الشِّيعَة، وَجَمِيع الخوَارِج على وجوب الإمَامَة، وَأَنَّ الأُمَّة وَاجِبٌ عَلَيهَا الانقيادُ لإِمَامٍ عَادل، يُقيم فيهم أَحكَامَ الله ويَسُوسُهم بِأَحكَام الشَّرِيعَة الَّتِي أَتَى بهَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم حاشا النَّجدات مِنَ الخوَارِج فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا يَلْزم النَّاسَ فرضُ الإِمَامَة، وَإِنَّمَا عَلَيهِم أَن يتعاطَوُا الحقَّ بَينهم، وَقَولُ هَذِه الفرْقَة سَاقِطٌ يَكفِي مِن الرَّد عَلَيهِ وإبطالِه إِجمَاعُ كلِّ مَن ذَكَرْنَا على بُطلَانه، وَالقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ قد ورد بِإِيجَاب الإِمَام»، ثمَّ ساق ـ رحمه الله ـ أدلةَ الإجماع في ذلك.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ [في «السياسة الشرعية» (١٢٩) و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٩٠)]: «يجب أن يُعرَف أنَّ ولايةَ أمر النَّاس مِنْ أعظم واجبات الدِّين بل لا قيامَ للدِّين ولا للدنيا إلَّا بها، فإنَّ بني آدم لا تتمُّ مصلحتُهم إلَّا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ».
وقال النووي ـ رحمه الله ـ [في «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٠٥)]: «وأجمعوا على أنَّه يجب على المسلمين نَصْبُ خليفةٍ، ووجوبُه بالشَّرع لا بالعقل، وأمَّا ما حُكِيَ عن الأصمِّ أنَّه قال: لا يجب، وعن غيره أنَّه يجب بالعقل لا بالشَّرع فباطلان، أمَّا الأصمُّ فمحجوجٌ بإجماعِ مَنْ قبله».
ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على الاشتغال بنصب الإمام بعد وفاة النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن دفنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقد جعلوه أهمَّ الواجبات، قال ابن خلدون ـ رحمه الله ـ [في «المقدمة» (٢٣٩)]: «إنَّ نَصْبَ الإمام واجبٌ قد عُرِفَ وُجوبُه في الشَّرع بإجماع الصَّحابة والتَّابعين؛ لأنَّ أصحابَ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكرٍ رضي الله عنه وتسليمِ النَّظر إليه في أمورهم، وكذا في كلِّ عصرٍ مِنْ بعد ذلك، ولم تُتْرَك النَّاسُ فَوْضَى في عصرٍ مِنَ الأعصار، واستقرَّ ذلك إجماعًا دالَّا على وجوب نَصْبِ الإمام»؛ وهو الإجماعُ الذي حكاه ابن حجر الهيتميُّ ـ رحمه الله ـ في «الصواعق المحرقة» (١/ ٧ ـ ٨): فقال: «اعلَم ـ أَيضًا ـ أَنَّ الصَّحابَة ـ رضوَانُ الله تعالَى علَيهِم أَجمعِينَ ـ أَجمعُوا على أَنَّ نَصْبَ الإمَامِ بعد انقِرَاض زَمَنِ النُّبوَّة وَاجِبٌ، بل جَعلوهُ أهمَّ الوَاجبَاتِ، حَيثُ اشتغلوا بِه عَن دَفن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وَاختِلَافُهُمْ فِي التَّعْيِين لَا يقدَح في الإِجمَاع المذْكُور»؛ [انظر ـ أيضًا ـ: «الأحكام السُّلطانية» للماوردي (٥)، «شرح السُّنَّة» للبَغَوي (١٠/ ٨٤)، «تفسير القرطبي» (١/ ٢٦٤)، «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٢/ ٢٠٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٢٠٨)].
(٥) رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١/ ٩٢، ٤/ ٣٦) وفي «غرائب الإمام مالك» (١٢)، مع اختلافٍ في ألفاظه ـ زيادةً ونَقصًا ـ مِن حديث فتيان بن أبي السمح عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: «فإنِّي وَلِيتُ أَمْرَكُم ولستُ بخيركم، أَلَا وإنَّ أقواكم عندي الضعيفُ حتى آخذ منه الحقَّ، وإنَّ أضعفكم عندي القويُّ حتى آخذ له الحقَّ، أيُّها النَّاسُ! إنَّما أنا مُتَّبِعٌ ولست بمبتدع، فإِنْ أنا أحسنت فأعينوني، وإن زِغْتُ فقوِّموني، أقول قولي هذا، وأستغفر اللهَ لي ولكم»، قال الدارقطني: «تفرَّد به فتيان عن مالك»؛ [انظر: «تخريج كشَّاف الزمخشري» للزيلعي (٢/ ٤٠٦)].
وأخرجه ابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٢٣٧)، وابن هشام في «السِّيرة النَّبوية» مِنْ طريق محمَّدِ بنِ إسحاق بن يسار عن الزُّهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ابنُ كثيرٍ [في «البداية والنهاية» (٥/ ٢٤٨، ٦/ ٣٠١)]: «وهذا إسناد صحيح»؛ ولفظه: «أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللهُ».
- قرئت 46959 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)