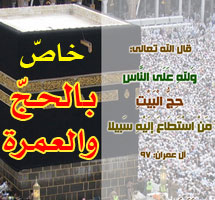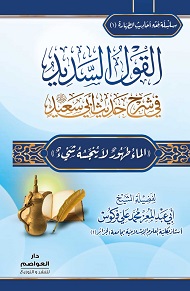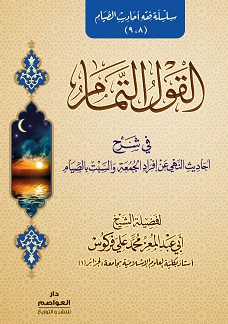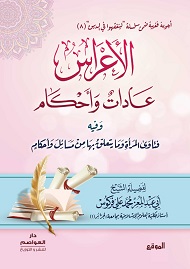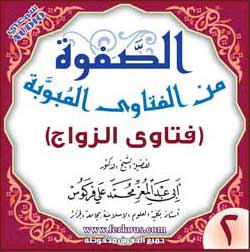الكلمة الشهرية رقم: ١٥٤

[الحلقةُ السَّابعةَ عَشْرَةَ]
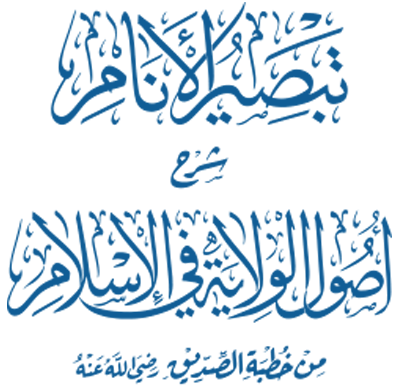
[الجزءُ السَّادِسُ]
قالَ الشَّيخُ عبدُ الحَميدِ بنُ بَاديسَ ـ رحمهُ اللهُ ـ:
«الأصلُ السَّادس
[نصح ولي الأمر وإرشاده إلى الحق]
حَقُّ الوَالِي عَلَى الأُمَّةِ فِي نُصْحِهِ وَإِرْشَادِهِ وَدَلَالَتِهِ عَلَى الحَقِّ إِذَا ضَلَّ عَنْهُ، وَتَقْوِيمِهِ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا زَاغَ فِي سُلُوكِهِ(١).
وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ: «وَإِذَا رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِي»».
ـ يُتبَع ـ
(١) كنت أشرتُ في «الأصلِ الخامسِ» إلى جُملةٍ مِنَ الحقوقِ على الأُمَّة تُؤدِّيها إلى الإمامِ الأعظمِ قَدْ دَلَّتِ النُّصوصُ الشَّرعِيَّةُ عليها، منها: السَّمعُ والطَّاعةُ في المَعروفِ، وتَركُ إهانتِهِ والخروجِ عليه وإِنْ جارَ، ووجوبُ توقيرِهِ وتعزيرِه في طاعةِ اللهِ تعالى، والدُّعاءُ له بالصَّلاحِ، والتَّضامُنُ معه، وتأييدُهُ في الحَقِّ، ونصرتُهُ في مَواقِفِ العَدْلِ، والاعتدالُ معه بما يَخدُمُ المَصلحَةَ الدِّينِيَّةَ والدُّنيويَّةَ؛ لأنَّ الأُمَّةَ شَريكةٌ له في المَسؤولِيَّةِ أمامَ الله، تَقِفُ معه على الحَقِّ، وتتعاون معه على البِرِّ والتَّقوى، وما إلى ذلك مِنَ الحقوقِ التي تقدَّم ذِكرُها.
كما دَلَّتِ النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ـ أيضًا ـ على وجوبِ بَذْلِ النَّصيحةِ لأئمَّةِ المُسلمِينَ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»؛ [أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (٢/ ٣٦) بابُ بيانِ أنَّ الدِّينَ النصيحةُ، مِنْ حديثِ تميمِ بنِ أوسٍ الداريِّ رضي الله عنه]، ولقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ»؛ [أخرجه أحمدُ في «المسند» (٨٧٩٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٨٩٥)].
ومِنْ هذا المُنطلَقِ الشَّرعِيِّ كان واجبًا على الأُمَّةِ ـ مِنْ خِلالِ أهلِ الإرشادِ والدَّلالَةِ ـ أَنْ تَنصحَ وَليَّ الأَمرِ وتُرشِدَهُ إلى الخَيرِ وتُعينَهُ عليه، وتُذكِّرَهُ باللهِ وأحكامِهِ وحِكَمِهِ ومواعظِهِ، وتُعْلِمَهُ بحقوقِ المُسلمين عليه إذا عُمِّيَ الأَمرُ عليه أو لم يَنكشِفْ له أو غَفَل عنه، وتَدُلَّهُ على الحَقِّ والهُدَى إذا فاتَتْه إصابةُ الحُكمِ الشَّرعيِّ باجتهادِه أو ضَلَّ عنه إلى الباطلِ بجهلٍ، وتُقوِّمَهُ على سواءِ الطَّريقِ إذا زاغَ عن خُلُق الاعتدالِ في سُلوكِهِ والاسْتِقامَةِ في مَواقِفِه بهوًى؛ قال ابنُ دقيق العيد ـ رحمه الله ـ [في «شرح الأربعين النَّوويَّة» (٥٣)]: «وأمَّا النَّصيحةُ لأئمَّةِ المُسلمين: فمُعاوَنَتُهم على الحقِّ وطاعتُهم وأَمْرُهم به، وتنبيهُهم وتذكيرُهم برِفْقٍ ولُطْفٍ، وإعلامُهم بما غَفَلوا عنه، وتبليغُهم مِنْ حقوق المُسلمين، وتركُ الخروجِ عليهم بالسَّيفِ، وتأليفُ قلوبِ النَّاس لطاعتِهم، والصَّلاةُ خَلْفَهم، والجهادُ معهم، وأَنْ يَدْعُوَ لهم بالصَّلاح».
فالحاصِلُ: أنَّ حَقَّ وَلِيِّ الأَمرِ على الأُمَّةِ أنَّه إِنْ رأَتْ فيهِ خطأً صَوَّبتْهُ أو اعْوِجاجًا قَوَّمتْهُ، أو غَفلةً نَبَّهتْهُ وأَيقظَتْ هِمَّتَهُ، أو باطلًا سَدَّدَتْهُ بالنَّصيحةِ والدَّلالَةِ والإرشاد.
غيرَ أَنَّ طريقةَ النَّصيحةِ التي يَحصُلُ بها المَقصودُ، وتَسلَمُ مِنَ المَحذورِ هي تلك الَّتِي تُحاطُ بِجُملةٍ مِنَ الضَّوابِطِ تصونُها عن الانحرافِ والمَيلِ عن الحَقِّ في القَولِ والعَمَلِ، وقد ذَكَرْتُ مِنْ هذه الضَّوابطِ جُملةً مُفصَّلةً في مُؤَلَّفِي «مَنصِبِ الإِمامَةِ الكُبْرَى» (٣١) أَنقُلُها ـ في هذا المَقامِ ـ لِتَستَبِينَ طَريقَةُ النَّصِيحَةِ الشَّرعيَّةِ فيما يأتي مع شيءٍ مِنَ التصرُّف لغرض الإفادة:
• أوَّلًا: الإخلاصُ في النَّصيحةِ وابتغاءُ وجهِ الله بها؛ لأنَّ النَّصيحةَ عِبادةٌ وإحسانٌ وشَفَقةٌ وغَيْرةٌ على المَنصوحِ، وقد سمَّاها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم دِينًا في قوله: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»؛ [سبق تخريجه قريبًا]؛ لذلك ينبغي أَنْ يكون المُرادُ منها وجهَ الله تعالى ورِضاهُ والإحسانَ إلى خَلْقِه، والحذرُ مِنِ اتِّباعِ سُبُلِ الهَوَى والْتِماسِ حظوظِ النَّفسِ بالتَّأنيبِ الَّذي يَقْصِدُ به الإهانةَ والشَّتمَ في صورةِ النُّصحِ.
• ثانيًا: تطهيرُ القلبِ مِنَ الغِلِّ والغِشِّ في مُناصَحةِ أئمَّةِ المُسلمين؛ فيُحِبُّ لهم ما يُحِبُّ لنَفْسِهِ مِنَ الخير، ويَكْرَهُ لهم ما يَكْرَهُ لنَفْسِه مِنَ الشَّرِّ؛ لأنَّ النَّصيحةَ مُنافِيةٌ للغِلِّ والغِشِّ ولا تُجامِعُهما بحالٍ، وقد أَخبرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك بقوله: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ ـ وفي لفظٍ: طَاعَةُ ذَوِي الأَمْرِ ـ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»؛ [أخرجه الترمذيُّ في «العلم» (٥/ ٣٤) بابُ ما جاء في الحثِّ على تبليغ السماع، مِنْ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قال التِّرمذيُّ: «حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ»، وروى هذا الأصلَ بِضْعَةٌ وعشرون صَحابيًّا، وهو معدودٌ مِنَ المُتواتِر كما بيَّنه الكتَّانيُّ في «نظم المُتناثِر» (٢٤ ـ ٢٥)، انظر: «السِّلسلة الصَّحيحة» للألبانيِّ (١/ ٧٦٠)، وروايةُ: «طاعةُ ذَوِي الأَمْرِ»: أخرجها أحمد (١٦٧٥٤)، والدَّارميُّ في «سننه» (١/ ٧٤) باب الاقتداء بالعُلَماء، مِنْ حديثِ جُبَيْر بنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه]؛ ذلك لأنَّ هذه الثلاثَ تنفي الغِلَّ والغِشَّ ومُفْسِداتِ القلبِ وسَخائِمَه كما بَيَّن ذلك ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ؛ [انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيِّم (١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨)].
• ثالثًا: التأكُّد مِنْ وقوعِ المَنصوحِ في مُخالَفةٍ أو مُنْكَرٍ قَضَتْ بذَمِّه النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ، أو دَلَّتْ على حُكْمِهِ الأصولُ المَرْعيَّةُ؛ فإِنْ تَثَبَّتَ النَّاصِحُ مِنْ تحقُّق المُخالَفةِ أو عينِ المُنْكَرِ وعَرَفَ مُرادَهم منه نَظَرَ إلى سيرتهم في حُكْمِهم ودعوتِهم، فإِنْ كانَتْ حَسَنةً أَحسنَ الظَّنَّ بهم والْتَمسَ لهم العذرَ وحَمَلَ كلامَهم وأفعالَهم على الوجه الحَسَنِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٨]، وإِنْ كانَتْ سيرتُهم غيرَ مَرْضِيَّةٍ حَمَلَ كلامَهم وأفعالَهم على الوجهِ السَّيِّئِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا﴾ [الأعراف: ٥٨]، وفي كِلَا الحالتين يُبَيِّنُ الحقَّ بدليلِهِ على وجهِ النَّصيحَةِ؛ لا التَّشفِّي أو الاحتقار.
أمَّا إذا عَرَفَ مُرادَ كلامِهم ولكنَّه جَهِلَ حُكْمَ الشرعِ فيه فالواجبُ أَنْ لا يَبذُلَ نصيحةً ضعيفةً غيرَ مُصْطَبِغَةٍ بالحقِّ حتَّى يعلم حُكْمَ ما يَنصَحُه فيه، وأنه على غير المشروع؛ ذلك لأنَّ العلمَ ما قامَ عليه الدليلُ وشَهِدَ له البرهانُ وأيَّدَتْهُ الحُجَّةُ.
• رابعًا: ومِنْ وجوهِ النَّصيحةِ لأئمَّةِ المُسلمين:
١ ـ مَحَبَّةُ صلاحِهم ورُشْدِهم وعَدْلِهم وما يحملونه مِنْ علمٍ وتَقْوَى، ومَحَبَّةُ اجتماعِ الأُمَّةِ عليهم، وكراهةُ افتراقِ الأُمَّةِ عليهم، والتَّعاونُ معهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه، والدُّعاءُ لهم بالثَّباتِ والتَّقوَى والصَّلاحِ والتَّوفيقِ والسَّدادِ؛ قال محمَّد بنُ نصرٍ المَرْوَزِيُّ [في «تعظيم قَدْرِ الصَّلاة» (٢/ ٦٩٤)]: «النَّصيحةُ لأئمَّةِ المُسلمينَ: حُبُّ طاعتِهم ورُشدِهم وعَدلِهِم، وحُبُّ اجتماعِ الأُمَّةِ كُلِّهم، وكَراهِيَةُ افتراقِ الأُمَّةِ عليهم، والتَّديُّنُ بطاعَتِهم في طاعةِ اللهِ، والبُغضُ لِمَن رأى الخُروجَ عليهم، وحُبُّ إعزازِهم في طاعةِ اللهِ» [بتصرُّف].
٢ ـ تصديقُهم بما يَرْوُونهُ مِنَ الأحاديثِ وما أدلَوْا به مِنَ الآراءِ والأقوالِ النَّابعةِ مِنَ الاجتهاد المَبنيِّ على مَصادِرِ التَّشريع ومَدارِكِه ما داموا وُعَاةً للعِلم وأهلًا للثِّقَةِ، أو أسَّسُوا أحكامَهم على شُورَى أهلِ العلم إِنْ لم يكونوا منهم.
وبناءً عليه، فليس مِنْ حقِّ النَّاصحِ ـ بالضَّرورةِ ـ أَنْ يَجِدَ قَبولًا لنَصيحته؛ فإِنْ تَضَمَّنَتْ نصيحتُهُ حُكمًا عَقَديًّا ثابتًا عند أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، أو حُكمًا شرعيًّا مُجْمَعًا عليه، أو حُكمًا راجحًا مُؤيَّدًا بقُوَّةِ الأدلَّةِ، فإِنْ قَبِلوا نصيحتَهُ فإنَّه يحمد اللهَ على الأَخْذِ بها وقَبولِهَا ويَتعاوَنُ معهم عليها، وإِنْ كانَتِ الأخرى فعزاؤُه أنَّه أَدَّى الواجبَ نحوَهم، ولا يَتعاوَنُ معهم فيما خالَفُوا فيه الحقَّ؛ إذ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»؛ [صحيح: تقدَّم تخريجه في «الأصل الخامس»]، والنَّاصحُ لا يُعادي مَنْ يَنْصحُه إذا لم يَقْبَلْ نصيحتَه، بل يدعو له بالهدايةِ والسَّداد، بخلافِ المُؤنِّبِ فإنَّه بضِدِّ ذلك؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ [في «الروح» (٢٥٨)]: «ومِنَ الفروق بين النَّاصح والمُؤنِّبِ: أنَّ النَّاصحَ لا يُعاديكَ إذا لم تَقْبَلْ نصيحتَه، وقال: «قد وَقَعَ أجري على الله، قَبِلْتَ أو لم تَقْبَلْ»، ويدعو لك بظَهْرِ الغَيب، ولا يذكرُ عيوبَك ولا يُبيِّنُها في النَّاس، والمُؤنِّبُ بضِدِّ ذلك».
أمَّا إذا كانَتْ نصيحتُه غيرَ مُؤسَّسةٍ على ما سَبَقَ تقريرُه فلا يَتحامَلُ عليهم إذا تركوا العملَ بنصيحته؛ لاحتمالِ عَدَمِ تَضمُّنِها ـ في نَظَرِهم ـ فِقهًا سليمًا أو حُكمًا واجِبَ الأخذِ به، أو كانَتِ النَّصيحةُ خارجةً عن المَوضوع الذي قرَّروه فتَقَعُ على غيرِ وجهِها ومَرْمَاها، أو أَلْزَمَهُمْ بمقتضَى حديثٍ لم يعملوا به لِعِلَّةِ ضَعْفِه عندهم أو العكس، أو تَرَكوا العملَ بها بما لا مَبْلَغَ له مِنَ العلم ونحو ذلك؛ فلا تُرْفَعُ إليهم نصيحةٌ حُكْمُ مضمونِها منسوخٌ أو مرجوحٌ أو مردودٌ بالنُّصوص الشَّرعيَّة، أو مدفوعٌ بالإجماع، أو مُخالِفٌ للقياس والمَصلحة والاعتبار.
٣ ـ تذكيرُهم بالمَسؤوليَّةِ المُلْقاةِ على عاتِقِهم، وتعريفُهم بالأخطاء والمُخالَفات التي وَقَعوا فيها برِفقٍ وحِكمةٍ ولُطْفٍ، والأصلُ في وَعْظِهم أَنْ يكون سِرًّا عند الإمكانِ مِنْ غيرِ فضحٍ ولا توبيخٍ ولا تشنيعٍ؛ قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: «مَنْ وَعَظَ أخاهُ سِرًّا فقَدْ نَصَحَه وَزَانَه، ومَنْ وَعَظَه عَلَانِيَةً فقَدْ فَضَحَه وشانَهُ»؛ [«حلية الأولياء» لأبي نُعَيْم (٩/ ١٤٠)، «شرح مسلم» للنَّوويِّ (٢/ ٢٤)]؛ وقال ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ [في «جامِع العلوم والحِكَم» (٧٧)]: «وكان السَّلفُ إذا أرادوا نصيحةَ أحَدٍ وَعَظوهُ سرًّا، حتَّى قال بعضُهم: «مَنْ وَعَظَ أخاهُ فيما بينه وبينه فهي نصيحةٌ، ومَنْ وَعَظَهُ على رؤوسِ النَّاس فإنَّما وبَّخهُ»، وقال الفضيلُ ـ رحمه الله ـ: «المُؤمنُ يَسْتُرُ ويَنصَحُ، والفاجرُ يَهْتِكُ ويُعيِّرُ»، وقال عبد العزيز بنُ أبي روَّادٍ ـ رحمه الله ـ: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرَّجلُ مِنْ أخيه شيئًا يأمره في رِفقٍ فيُؤْجَرُ في أَمْرِه ونَهْيِه، وإنَّ أَحَدَ هؤلاء يخرق بصاحِبِه فيَسْتَغْضِبُ أخاهُ ويَهْتِكُ سِتْرَهُ»، وسُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما عن أَمْرِ السُّلطان بالمَعروف ونَهْيِه عن المُنْكَرِ فقال: «إِنْ كُنْتَ فاعلًا ـ ولا بُدَّ ـ ففيما بينك وبينه»»؛ وقال يحيى بنُ مَعِينٍ: «مَا رَأَيْتُ عَلَى رَجُلٍ خَطَأً إِلَّا سَتَرْتُهُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُزَيِّنَ أَمرَهُ، وَمَا اسْتَقْبَلْتُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِأَمرٍ يَكْرَهُهُ، وَلَكِنْ أُبَيِّنُ لَهُ خَطَأَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ، وَإِلَّا تَرَكْتُهُ»؛ [انظر: «سِيَر أعلام النُّبلاء» للذَّهبي (١١/ ٨٣)].
ويتمُّ وَعْظُهم سِرًّا إمَّا عن طريقِ خِطابٍ سِرِّيٍّ مُرْسَلٍ إليهم عبرَ البريدِ الخاصِّ أو الإلكترونيِّ، وإمَّا بتسليمِه إليهم يدويًّا بواسطةِ ثِقَةٍ، أو بطلبِ لقاءٍ أَخَويٍّ ـ إِنْ أَمكنَ ـ يُسِرُّ إليهم فيه بالنَّصيحةِ، ونحوِ ذلك مِنْ أسبابِ حُصولِ الانتفاعِ بالنَّصيحةِ في مَجالِ الدَّعوةِ والتَّعليمِ والإعلامِ؛ وعلى هذا يُحمَل حديثُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ»؛ [أخرجه ابنُ أبي عاصمٍ في «السُّنَّة» (٢/ ٥٢١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «ظلال الجنَّة» (١٠٩٦)].
أمَّا إذا لم يُمكِنْ وَعظُهُم سِرًّا في إزالةِ مُنكَرٍ وقَعوا فيه علنًا، وغَلَبَ على الظَّنِّ تحصيلُ الخيرِ بالإنكارِ العَلَنيِّ مِنْ غيرِ تَرَتُّبِ أيِّ مفسدةٍ فإنَّه يجوزُ ـ والحالُ هذه ـ نصيحتُهم والإنكارُ عليهم عَلَنًا دون هتكٍ ولا تعييرٍ ولا تشنيعٍ، وهو ما تقتضيه الحِكمةُ مِنْ إنكارِ المُنكَرِ وإحقاقِ الحقِّ وتحصيلِ الخيرِ، فقَدْ أَنكرَ الصَّحابيُّ الجليلُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي الله عنه على مروانَ بنِ الحَكَمِ تقديمَهُ الخُطبةَ على صلاة العيد مِنْ غيرِ تشهيرٍ ولا تأليبٍ، ولكنَّه كان علنًا وعلى مَرْأًى وَمَسْمَعٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم مِنْ غيرِ نكيرٍ؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «أبواب العيدين» (٢/ ٤٤٩) باب الخروج إلى المُصلَّى بغير منبرٍ، ومسلمٌ في «الإيمان» (٢/ ٢١) باب بيانِ كونِ النَّهيِ عن المُنكَرِ مِنَ الإيمانِ، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه]، ويؤيِّدُه ما أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١١/ ١٢) باب الرِّبا، عن أبي قِلابةَ أنَّه قال: «كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟!»، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: «لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ـ أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ ـ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ»»؛ وقد كان عُبادةُ رضي الله عنه في هذه القصَّةِ مُطبِّقًا لمقتضى المبايعةِ في حديثِهِ الآخَرِ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» (١٣/ ١٩٢) باب: كيف يبايع الإمامُ الناسَ؟ (٧١٩٩)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٢/ ٢٢٨) بابُ وجوبِ طاعة الأُمَراء في غيرِ معصيةٍ، وتحريمِها في المعصية]؛ فصَدَع رضي الله عنه بالحقِّ بيانًا للحكم الشرعيِّ دون هَوَادةٍ، وأَنكرَ المُنكَرَ بحسَبِ قُدرتِه حيث لا يؤدِّي إنكارُه إلى مُنكَرٍ أكبرَ، مِنْ غيرِ أَنْ يُنازِعَ الأمرَ أهلَه أو ينزع يدًا ممَّا يَلْزَمُه فيه طاعتُه.
كما قد جاء في الحديثِ عند الطبرانيِّ وأبي يعلى الموصليِّ وغيرهما: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلٍ، يَأْثُرُ [أَثَرَ الحديثَ عن القوم يَأثِرُه ويَأثُره: أنبأهم بما سَبَقوا فيه مِنَ الأثر، وقِيلَ: حدَّث به عنهم؛ «تاج العروس» للزَّبيدي (٦/ ٨)] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ صَعِدَ المِنْبَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ عِنْدَ خُطْبَتِهِ: «إِنَّمَا المَالُ مَالُنَا، وَالفَيْءُ فَيْئُنَا، فَمَنْ شَاءَ [كذا عند الطبرانيِّ، و«شِئْنَا» عند أبي يعلى] أَعْطَيْنَاهُ وَمَنْ شِئْنَا مَنَعْنَاهُ»، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ الجُمُعَة الثَّانِيَة قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ الجُمُعَة الثَّالِثَة قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ حَضَرَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: «كَلَّا، إِنَّمَا المَالُ مَالُنَا وَالفَيْءُ فَيْئُنَا، فَمَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ [حَاكَمْنَاهُ إِلَى اللهِ بِأَسْيَافِنَا]»، فَنَزَلَ مُعَاوِيَةُ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَدْخَلَهُ، فَقَالَ القَوْمُ: «هَلَكَ الرَّجُلُ»، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَوَجَدُوا الرَّجُلَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلنَّاسِ: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَحْيَانِي ـ أَحْيَاهُ اللهُ ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَتَقَاحَمُ القِرَدَةُ»، وَإِنِّي تَكَلَّمْتُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَكَلَّمْتُ فِي الجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: إِنِّي مِنَ القَوْمِ، ثُمَّ تَكَلَّمْتُ فِي الجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ فَقَامَ هَذَا الرَّجُلُ فَرَدَّ عَلَيَّ فَأَحْيَانِي ـ أَحْيَاهُ اللهُ ـ»»؛ [أخرجه الطَّبَرَانِيُّ في «المُعجَم الكبير» (١٩/ ٣٩٣)، و«الأوسط» (٥/ ٢٧٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣/ ٣٧٣)، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٩/ ١٦٨)، والحديث صَحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٤/ ٣٩٨)، وحسين أسد مُحقِّق «مسند أبي يعلى» (١٣/ ٣٧٣)].
وعبارةُ: «حَاكَمْنَاهُ إِلَى اللهِ بِأَسْيَافِنَا»: أسلوبٌ لغويٌّ قائمٌ على المُبالغةِ كما ذَكَره الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ ولا يُفهَم منه الخروجُ على السُّلطانِ بالسَّيفِ الذي دلَّتِ النصوصُ عن الله ورسوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على عدمِ جوازه، فإنَّ المحاكمة إلى الله تقتضي عدمَ المقاتلةِ والصبرَ على الجَوْر، كما أمَرَ به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في أحاديثَ كثيرة.
ويشهَدُ لهذه الآثارِ السلفيَّةِ الموقوفةِ المتقدِّمة ما ذكرتُه ـ أيضًا ـ في الاعتراض الحادي والسِّتِّين مِنْ «تيسير الباري» الموسوم ﺑ: «تفنيد شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»»، منها: إنكارُ ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم قَتْلَه مَنْ قال: «صَبَأْنا» مِنْ رجالِ بني جَذِيمةَ، وإنكارُ ابنِ مسعودٍ على عثمان رضي الله عنهما إتمامَه الصلاةَ بمِنًى، وإنكارُ عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما نهيَه عن نُسُكَيِ التمتُّع والقِرَان، وإنكارُ عائشةَ رضي الله عنها على مروانَ في حضوره، وإنكارُ أخيها عبدِ الرحمن على معاوية رضي الله عنهما في غَيْبته، وغيرها.
فضلًا عن إنكارِ كعب بنِ عُجرةَ رضي الله عنه ـ علنًا ـ على عبد الرَّحمن بنِ أمِّ الحَكَم حين «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗا﴾ [الجمعة: ١١]»»؛ [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٦/ ١٥٢) بابٌ في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗا﴾ [الجمعة: ١١]]؛ قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ [في «شرح مسلم» (٦/ ١٥٢)]: «هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المُنكَر، والإنكارَ على وُلَاة الأمور إذا خالفوا السُّنَّةَ»؛ ومِثلُه عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى المِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ؛ [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٦/ ١٦٢) بابُ تخفيف الصلاة والخُطبة (٨٧٤)].
وهذا غيضٌ مِنْ فَيْضٍ مِنْ إنكارِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم على الأمراءِ والوُلاةِ، وفي هذا السِّياقِ قال ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ [في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ١١٠)]: «ما قالَه عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: بايَعْنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أَنْ نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ، ونحن نشهدُ [بالله] أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مَخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَنْ تَأمَّلَهُ مِنْ هديِهم وسِيرتِهم، فقَدْ أَنكرَ أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأَنكرَ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو خليفةٌ [كذا، والصَّوابُ: أميرٌ لأنَّ عُبادةَ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٤ﻫ زمنَ عثمان رضي الله عنهما]، وأَنكرَ ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأَنكرَ على عمرِو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِنْ إنكارِهم على الأمراءِ والوُلَاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ: لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَنْ بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلَاةِ الظُّلم وأُمَراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أَنْ يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم».
عِلمًا أنَّ النَّصيحةَ العَلَنيَّةَ تُؤدَّى مِنْ غيرِ هَتْكٍ ولا تعييرٍ لمُنافاتِهما للجانب الأخلاقيِّ، ولا خروجٍ بالقول والفِعلِ لمُخالَفتِه لِمَنهجِ الإسلامِ في الحُكمِ والسِّياسةِ، بَلْهَ إذا أجازوا تقديمَ النَّصيحةِ أمامَهم عَلَنًا وفَتَحوا على أَنْفُسهم بابَ إبداءِ الرَّأي والانتقادِ وأَذِنوا فيه؛ قال النَّوويُّ [في «شرح مسلم» (١٨/ ١١٨)]: «وَفيهِ الأَدبُ مع الأُمَرَاءِ، واللُّطفُ بِهم، وَوَعْظُهُمْ سِرًّا، وتبليغُهُمْ ما يقولُ النَّاسُ فيهم لِيَنْكَفُّوا عنه، وهذا كُلُّه إذا أَمكَنَ ذلك؛ فإِنْ لم يُمكِنِ الوَعظُ سِرًّا وَالإِنكارُ فَلْيَفْعَلْهُ عَلانِيَةً لِئَلَّا يَضِيعَ أَصلُ الحَقِّ»، مع إخلاصِ القصد ورحمةِ المنصوح دون تَشَفٍّ.
وجديرٌ بالتنبيه: أنَّه إذا غَلَبَ على الظَّنِّ عدمُ زوالِ المَفسدةِ والمُنكَرِ بالوعظِ العَلَنيِّ، بل قد يترتَّبُ عليه نتائجُ عكسيَّةٌ مُضِرَّةٌ بالدَّعوةِ إلى اللهِ وبالنَّاصحين علنًا، فإنَّ ما تقتضيه المَصلحةُ ـ والحالُ هذه ـ تجنُّبُ الإنكارِ العَلَنيِّ والاكتفاءُ بوعظهم سِرًّا عند الإمكان؛ قال ابنُ العثيمين ـ رحمه الله ـ [في «لقاء الباب المفتوح» (٦٢/ ١٠)]: «فإذا رأينا أنَّ الإنكارَ علنًا يزولُ به المُنكَرُ ويحصلُ به الخيرُ فلنُنْكِرْ عَلَنًا، وإذا رأَيْنا أنَّ الإنكارَ علنًا لا يزول به الشَّرُّ، ولا يحصل به الخيرُ، بل يزدادُ ضغطُ الوُلَاةِ على المُنكِرينَ وأهلِ الخيرِ، فإنَّ الخيرَ أَنْ نُنكِرَ سِرًّا، وبهذا تجتمعُ الأدلَّة، فتكونُ الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكون علنًا فيما إذا كُنَّا نتوقَّعُ فيه المَصلحةَ، وهي حصولُ الخيرِ وزوالُ الشَّرِّ، والنُّصوصُ الدَّالَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكونُ سِرًّا فيما إذا كان إعلانُ الإنكارِ يزدادُ به الشَّرُّ ولا يحصلُ به الخيرُ».
وبالمقابل فإنَّ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ أيضًا ـ إذا كان يُحدِثُ إنكارُه مفسدةً ويترتَّب عليه شرٌّ، فإنَّ حُكْمَه منعُ الإنكارِ السِّرِّيِّ، وسقوطُ وجوبِه في هذه الحالِ مع بقاء الإنكار القلبيِّ، لكِنْ يزول حكمُ المنعِ بزوال عِلَّته وهي خشيةُ المفسدةِ، أي: ليس معنَى ذلك سوى سقوطِ وجوب الإنكار السِّرِّي مع بقاءِ أصلِه، ومتى زالت عِلَّةُ المفسدةِ عاد حكمُه في وجوب الإنكار السِّرِّيِّ إذا تحقَّقَتْ شروطُه وانتفَتْ موانعُه، فهو كمُقابِله لا يجوز نفيُه مُطلَقًا لنفسِ العلَّة المذكورة آنفًا، وإلَّا كان نفيًا للأمر بإنكار المُنكَر، وردُّ النصوصِ جريمةٌ وصنيعُ أهلِ الأهواء، لأنَّ المعلوم أنَّ الشيء يُعطَى حُكمَ نظيرِه، ويُنفَى عنه حكمُ مُخالِفه، فهو مِنْ قبيل الجمع بين المتماثلات لا التفريقِ بينها، وما ذُكِر مِنَ المعارضة ـ في هذا الباب ـ فغيرُ صحيحةٍ لأنها تُؤدِّي إلى ترك العمل بالنَّصِّ عند انتفاءِ عِلَّةِ التَّرْك مع عدمِ اطِّرادها، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ يخالف المنقولَ ومُقتضَيَاتِ المعقول، إذ المعارضةُ الصحيحة هي التي يمكن طَرْدُها، وليس أمرُ المُعترِضين كذلك، ولهذا لمَّا قال سعيد بنُ جُبَيْرٍ لابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ؟» فَقَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»، وفي روايةٍ أنَّه قال رجلٌ لابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟»، قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الإِمَامَ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»؛ [أخرجه ابنُ أبي شيبة (٣٧٣٠٧)، وابنُ عبدِ البَرِّ في «التمهيد» (٢٣/ ٢٨٢) وغيرهما، عن سعيد بنِ جُبَير]، فهو رضي الله عنه لم يَنْفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد الإنكارَ ـ علنًا كان أو سرًّا ـ بالأمن مِنَ القتل والتهلكة وبعدم التَّأنيب والفتنة.
ونظيرُه قولُ أسامة رضي الله عنه: «إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ، إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»، فهو رضي الله عنه لم يَنفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، ولكِنْ خَشِيَ فَتْحَ بابِ التهلكة؛ والحقيقةُ أنَّ ظاهِرَ قولِ أسامةَ رضي الله عنه أنه لم يَنفِ عن نفسِه مُكالَمَتَه أمامَ الناس، بل نفى حَصْرَ مُكالَمِته في كونها أمامَ الناسِ، فكأنه يقول: هل تظنُّون أنِّي لا أُكلِّمه إلَّا وأنتم تسمعون أو إذا كان ذلك بمَسمعِكم ـ كما في بعض الروايات: بسمعِكم ـ أو بمرأًى منكم أو إذا أَخبرتُكم أنِّي كلَّمْتُه؟! إنِّي لَأكلِّمه ـ علاوةً على ذلك ـ فيما بيني وبينه، وهذا كما أنه أقرَبُ إلى الاستصلاح وأدرأُ للفتنة فهو أبعدُ عن الرِّياء في الحال التي كان فيها عثمانُ رضي الله عنه؛ يشهد لهذا لفظُ مسلمٍ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قِيلَ لَهُ: «أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟» فَقَالَ: «أَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟! أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟! فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «بدء الخَلْق» (٦/ ٣٣١) بابُ صفة النار وأنَّها مخلوقةٌ، ومسلمٌ في «الزهد والرقائق» (١٨/ ١١٧) بابُ حفظِ اللِّسان].
٤ ـ صيانةُ اللِّسانِ عن ذَمِّهم وتجريحِهم وإهانتِهم، والامتناعُ عن سَبِّهم ولَعْنِهم والتَّشهيرِ بعيوبهم ومَساوِئِهم؛ لأنَّ ذلك يُوجِبُ عداوَتَهم والحطَّ مِنْ قَدْرِهم والانتقاصَ مِنْ شأنِهم؛ إذ فَتْحُ مَجالِ الإغارةِ عليهم بالقَدْحِ والطَّعنِ يُفْقِدُهم الهَيْبَةَ ويَجعلُهم مَحَلَّ التُّهمَةِ؛ الأمرُ الذي يُخْشَى مِنْ ورائه ضَياعُ الأُمَّةِ شريعةً وأمنًا؛ علمًا أنَّ في اتِّهامِ العُلَماءِ في أقوالهم ومَعارِفِهم تضييعًا للشَّريعَةِ ـ لكونهم أهلَ الإرشادِ والدَّلالة ـ وفي فَقْدِ الثِّقةِ في الأُمَراءِ والحُكَّام تضييعًا للأَمنِ والاستقرارِ ـ لكونهم أهلَ اليد والسلطان ـ.
وضِمْنَ هذا المَعنى قال الشَّيخُ ابنُ عثيمين ـ رحمه الله ـ [في «لقاء الباب المفتوح» (٣٢/ ١٠)]: «ولهذا نرى أنَّ مِنَ الخطإ الفاحشِ ما يقوم به بعضُ النَّاسِ مِنَ الكلام على العُلَماء أو على الأُمَراءِ؛ فيملأُ قلوبَ النَّاسِ عليهم بُغْضًا وحِقْدًا، وإذا رأى شيئًا مِنْ هؤلاء يرى أنَّه مُنْكَرٌ فالواجبُ عليه النَّصيحةُ، وليس الواجبُ عليه إفشاءَ هذا المُنْكَرِ أو هذه المُخالَفة، ونحن لا نَشُكُّ أنه يُوجَدُ خطأٌ مِنَ العُلَماءِ ويُوجَدُ خطأٌ مِنَ الأُمَراء، سواءٌ كان مُتعمَّدًا أو غيرَ مُتعمَّدٍ، لكِنْ ليس دواءُ المَرضِ بإحداثِ مَرضٍ أَعْظَمَ منه، ولا زوالُ الشَّرِّ بِشَرٍّ أَشَرَّ منه أبدًا، ولم يَضُرَّ الأُمَّةَ الإسلاميةَ إلَّا كلامُها في عُلَمائِها وأُمَرائِها، وإلَّا فما الذي أَوْجَبَ قَتْلَ عثمان؟ هو الكلام فيه: تكلَّموا فيه، وأنَّه يُحابي أقارِبَه وأنَّه يفعل كذا ويفعل كذا؛ فحَمَلَتِ النَّاسُ في قلوبها عليه، ثمَّ تَولَّدَ مِنْ هذا الحملِ كراهةٌ وبَغْضاءُ وأهواءٌ وعدَاءٌ، حتَّى وَصَلَ الأمرُ إلى أَنْ قَتَلُوهُ في بيته، وتَفرَّقَتِ الأُمَّةُ بعد ذلك، وما الذي أَوْجَبَ قَتْلَ أميرِ المؤمنين عليِّ بنِ أبي طالبٍ إلَّا هذا؟ خرجوا عليه وقالوا: إنَّه خالَفَ الشَّرعَ، وكفَّروه وكَفَّروا المُسلمين معه، وحَصَلَ ما حَصَلَ مِنَ الشرِّ.. وأرى أنَّه يجب الكفُّ عن نَشْرِ مَساوِئِ النَّاسِ ولا سيَّما العُلَماء والأُمَراء، وأنه يجب إصلاحُ الخطإ بقَدْرِ الإمكان، ولكِنْ بالطَّريقة التي يحصلُ بها المَقصودُ ونَسْلَمُ فيها مِنَ المَحذور».
- قرئت 24272 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)