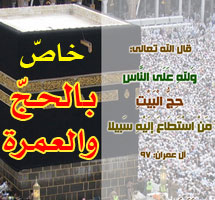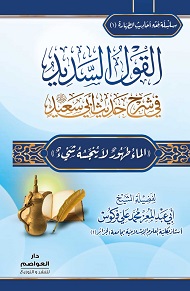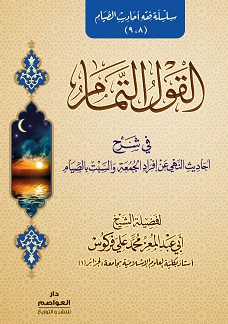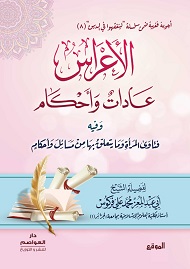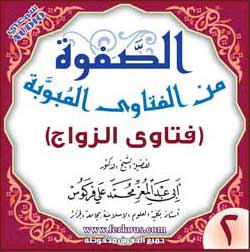الكلمة الشهرية رقم: ٧٥
الدعائم الإيمانية للداعية
«الحلقة الثالثة الأخيرة»
الدِّعامة الثالثة: الاعتماد القلبي الموصول بالله.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمراد بالاعتماد القلبيِّ أَنْ يفوِّض الداعيةُ أَمْرَ الدعوة ولواحقَها مِنَ النصر والتأييد والتمكين إلى مولاه وناصِرِه، ﴿بَلِ ٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ١٥٠﴾ [آل عمران]، ويعتمدَ عليه سبحانه في تحصيلِ هذه المَطالبِ العالية، يسعى لتحقيقها والظَّفَرِ بها؛ فهو يَدِينُ اللهَ بالتوكُّلِ عليه والاطِّراحِ الكامل بين يديه؛ فالتوكُّلُ المُطلَقُ على الله تعالى هو جزءٌ مِنْ عقيدة المؤمن، لا يجوز ـ بحالٍ ـ أَنْ يكون لغيره، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١٢٢﴾ [آل عمران وغيرها]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٣﴾ [المائدة].
ولا ينبغي للداعية أَنْ يفهم التوكُّلَ بمعنى التواكل أو كلمةً يَلُوكُ بها لسانَه دون فهمٍ لمعناها أو وعيٍ لمَرْماها؛ فينبذَ الأسبابَ ويتركَ العمل، ويقنعَ بالهُون والدُّون، ويرضى بما تجري به الأقدارُ بدعوى التوكُّل على الله؛ فمُجرَّدُ الظنِّ بأنَّ التوكُّلَ يُغني عن الأسباب المطلوبةِ ضلالٌ؛ فهو ظنُّ خصوم العقيدة والمحجوبين بمَعاصيهم، وإنما الداعيةُ المؤمن يُوثِّقُ الصلةَ بربِّه بالطاعة والتقوى، ويُعمِّقُ الرباطَ بالتوكُّل عليه وتفويضِ أعماله الدعويَّة وسائرِ شؤونه إليه؛ وذلك بإعداد الأسباب المطلوبة لها، وتسخيرِ طاقته في إحضارها، واستفراغِ وُسْعِه في إكمالها؛ فيعملُ ولا يَعْجَز ولا يَكْسَل، ويحرِصُ على ما ينفعه؛ فإنَّ العَجْزَ والكسل خُلُقان ذميمان استعاذ منهما رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ»(١)، وأوصى بالعمل والحرص على ما ينفعه في دنياه وأُخراه، فقال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ»(٢)، مع اعتقاده الجازم أنَّ تحصيل الأسبابِ والسعيَ إلى إيجادها فيما أَمَرَه اللهُ به عبادةٌ لله وطاعةٌ له، واللهُ تعالى فَرَضَ على العباد أَنْ يعبدوه ويتوكَّلوا عليه؛ قال تعالى: ﴿فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِۚ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا ٨ رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا ٩﴾ [المزَّمِّل]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ﴾ [الطلاق: ٢ ـ ٣]؛ والعبدُ لا يكون مطيعًا لله إلَّا بفعلِ ما أَمَر به اللهُ تعالى وتركِ ما نهى عنه، ويدخل التوكُّلُ في هذا المعنى مِنَ الإنابة إلى الله والمَتابِ إليه، قال تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ مَتَابِ ٣٠﴾ [الرعد]، وقال الله تعالى عن شعيبٍ عليه السلام: ﴿عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ٨٨﴾ [هود].
فالداعية يؤمن بأنَّ الأسباب ليست بمُفْرَدها كفيلةً بإنجاحِ المساعي وتحصيلِ المبتغى وتحقيقِ الأمل؛ فإنَّ الاعتماد عليها لوحدها ينافي التوحيدَ، وإهمالَها مع القدرة على إحضارها وإعدادِها فسقٌ ومعصيةٌ.
وإنما يتعلَّق قلبُه بخالِقِ الأسباب ومُوجِدِها؛ فيَكِلُ الداعيةُ أَمْرَه إليه في تحصيل النتائج والفوزِ بالرغائب دون الخَلْق الذين لا يملكون لأَنْفُسِهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًّا؛ قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فالالتفات إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومحوُ الأسباب أَنْ تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، والإعراضُ عن الأسباب المأمورِ بها قَدْحٌ في الشرع؛ فعلى العبد أَنْ يكون قلبُه مُعتمِدًا على الله لا على سببٍ مِنَ الأسباب، واللهُ يُيَسِّر له مِنَ الأسباب ما يُصْلِحه في الدنيا والآخرة: فإِنْ كانَتِ الأسبابُ مقدورةً له وهو مأمورٌ بها فَعَلَها مع التوكُّل على الله: كما يؤدِّي الفرائضَ وكما يُجاهِد العدوَّ ويحمل السلاحَ ويَلْبَس جُنَّةَ الحرب، ولا يكتفي في دفعِ العدوِّ على مجرَّدِ تَوَكُّلِه بدونِ أَنْ يفعل ما أُمِر به مِنَ الجهاد، ومَنْ تَرَك الأسبابَ المأمورَ بها فهو عاجزٌ مفرِّطٌ مذمومٌ»(٣).
وكذلك كان التعليم النبويُّ؛ فقَدْ كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يجمع بين الأسباب الإيمانيَّة والمادِّيَّة في مَعارِكِه وقتاله؛ فلا يخوض حربًا حتَّى يُعِدَّ لها عُدَّتَها ويهيِّئَ لها أسبابَها: فيرسمُ الخطَّةَ ويُنظِّمُ الصفوفَ ويختار الزمنَ والمكانَ المناسبَيْن؛ إذ نظامُ الأسباب مِنَ السنن الكونيَّة لا ينافي التوكُّلَ، بل هي أسبابٌ مأمورٌ بها شرعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ﴾ [الأنفال: ٦٠]، والإعراضُ عنها قَدْحٌ في الشرع، وكان صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لا يُعلِّق نَصْرَه إلَّا على الله ولا يُنيط فلاحَه وفوزَه إلَّا بمشيئة مولاه؛ فيرفع يديه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سائلًا اللهَ تعالى النصرَ والتمكينَ بقوله: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»(٤).
فالداعية إذا ما اسْتَمَدَّ نظرتَه إلى الأسباب مِنْ روح الإسلام ومِنْ هدي سيِّد الأنام عليه الصلاةُ والسلام؛ تَيقَّنَ أنَّ التوكُّل على الله عملٌ وأملٌ، وأنَّ ما شاء اللهُ كان وما لم يَشَأْ لم يكن، وأنَّ الله لا يُضيع ﴿أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا ٣٠﴾ [الكهف]، وأنَّ ﴿ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨﴾ [النحل]، وكُلَّما ازداد تعلُّقُه بخالِقِه ورازِقِه ومولاه وناصِرِه أَكْسَبَه قُربًا وتأييدًا، وزاده رفعةً وتمجيدًا، وكفاهُ ما يريد، وحقَّق له ما يصبو إليه مِنْ عزٍّ وكمالٍ؛ فينال به الرغائبَ، ويحصل به على المطالب، ويحفظه مِنَ المصائب، ويدافع عنه ويؤيِّده ويمكِّن له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ ١٧٢ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ١٧٣﴾ [الصافَّات]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠﴾ [الحج]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ ٣٨﴾ [الحج].
وعلى الداعية أَنْ يتيقَّن أنَّ نَصْرَ الله لعباده المؤمنين وعَوْنَه لهم وانتقامَه ممَّنْ حادَّهم أو شاقَّهم أو آذاهم أو كذَّبهم في دعوتهم أو نفَّر الناسَ عنهم وصدَّهم عن دعوة الحقِّ وعن هدايَتِهم لهم إلى صراطٍ مستقيمٍ آتٍ في الحياة الدنيا لا مَحالةَ، سواءٌ كان ذلك بحَضْرَتِهم أو في غَيْبَتِهم أو بعد موتهم، ونصرُ اللهِ يومَ القيامة حاصلٌ يشهده الملائكةُ والأنبياء والمؤمنون على أُمَمِهم المكذِّبة(٥)، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [غافر]؛ قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ: «المراد بالنصر الانتصارُ لهم ممَّنْ آذاهم، وسواءٌ كان ذلك بحضرتهم أو في غَيْبَتِهم أو بعد موتهم كما فَعَلَ بقَتَلَةِ يحيى وزكريَّا وشِعْيَا: سلَّط عليهم مِنْ أعدائهم مَنْ أهانَهم وسَفَكَ دماءَهم... وأمَّا الذين راموا صَلْبَ المسيحِ عليه السلام مِنَ اليهود فسلَّط اللهُ تعالى عليهم الرومَ فأهانوهم وأذلُّوهم، وأَظْهَرَهُمُ اللهُ تعالى عليهم، ثمَّ قبل يومِ القيامة سينزل عيسى ابنُ مريم عليه الصلاةُ والسلام إمامًا عادلًا وحَكَمًا مُقْسِطًا؛ فيقتل المسيحَ الدجَّال وجنودَه مِنَ اليهود، ويقتل الخنزيرَ ويكسر الصليبَ، ويضع الجزيةَ فلا يقبل إلَّا الإسلامَ، وهذه نصرةٌ عظيمةٌ، وهذه سُنَّةُ الله تعالى في خَلْقه في قديمِ الدهر وحديثِه: أنه ينصر عِبادَه المؤمنين في الدنيا ويُقِرُّ أَعْيُنَهم ممَّنْ آذاهم.
ففي «صحيح البخاريِّ» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنه قال: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالحَرْبِ»(٦)، وفي الحديث الآخَر: «إِنِّي لَأَثْأَرُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَثْأَرُ اللَّيْثُ الحَرِبُ»(٧)؛ ولهذا أَهْلَكَ اللهُ عزَّ وجلَّ قومَ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وأصحابَ الرَّسِّ وقومَ لوطٍ وأهلَ مَدْيَنَ وأشباهَهم وأضرابَهم ممَّنْ كذَّب الرسلَ وخالَفَ الحقَّ، وأنجى اللهُ تعالى مِنْ بينهم المؤمنين فلم يُهْلِك منهم أَحَدًا، وعذَّب الكافرين فلم يُفْلِتْ منهم أَحَدًا.
قال السُّدِّيُّ: «لم يبعَثِ اللهُ عزَّ وجلَّ رسولًا قطُّ إلى قومٍ فيقتلونه، أو قومًا مِنَ المؤمنين يَدْعون إلى الحقِّ فيُقتلون، فيذهب ذلك القرنُ حتَّى يبعثَ اللهُ تبارك وتعالى لهم مَنْ ينصرهم فيطلبُ بدمائهم ممَّنْ فَعَلَ ذلك بهم في الدنيا»، قال: «فكانَتِ الأنبياءُ والمؤمنون يُقْتَلون في الدنيا وهُمْ منصورون فيها».
وهكذا نَصَرَ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وأصحابَه على مَنْ خالَفَه وناوأه وكذَّبه وعاداه؛ فجَعَلَ كلمتَه هي العُليا، ودِينَه هو الظاهرَ على سائرِ الأديان، وأَمَره بالهجرة مِنْ بينِ ظهرانَيْ قومه إلى المدينة النبويَّة، وجَعَلَ له فيها أنصارًا وأعوانًا، ثمَّ مَنَحه أكتافَ المشركين يومَ بدرٍ فنَصَره عليهم وخَذَلَهم له، وقَتَلَ صناديدَهم وأسَرَ سَرَاتَهم؛ فاسْتَاقهم مُقرَّنين في الأصفاد، ثمَّ مَنَّ عليهم بأَخْذِه الفداءَ منهم، ثمَّ بعد مدَّةٍ قريبةٍ فَتَحَ عليه مكَّةَ فقرَّتْ عينُه ببلده وهو البلدُ المحرَّم الحرامُ المشرَّف المعظَّم؛ فأَنْقَذَهُ اللهُ تعالى به ممَّا كان فيه مِنَ الكفر والشرك، وفَتَح له اليمنَ ودانَتْ له جزيرةُ العرب بكامِلِها، ودَخَلَ الناسُ في دِينِ الله أفواجًا، ثمَّ قَبَضه اللهُ تعالى إليه لِمَا له عنده مِنَ الكرامة العظيمة؛ فأقام اللهُ تبارَكَ وتعالى أصحابَه خُلَفاءَ بعده؛ فبلَّغوا عنه دِينَ الله عزَّ وجلَّ ودعَوْا عبادَ الله تعالى إلى الله جلَّ وعلا، وفتحوا البلادَ والرساتيقَ(٨) والأقاليمَ والمدائنَ والقرى والقلوبَ، حتَّى انتشرَتِ الدعوةُ المحمَّديَّةُ في مَشارِقِ الأرض ومَغارِبِها، ثمَّ لا يَزال هذا الدِّينُ قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [غافر] أي: يومَ القيامة تكون النصرةُ أَعْظَمَ وأَكْبَرَ وأَجَلَّ»(٩).
هذا، وقلبُ الداعيةِ الموصولُ بالله المُعتمِدُ عليه المقتدي بالهدي النبويِّ والمؤتسي بالتعليم المحمَّديِّ يشعر بحلاوة الإيمان ويُحِسُّ بعزَّة الإسلام، ويَعْظُمُ في نَفْسِه الحقُّ وحُبُّ أهله، ويصغر في عينيه الباطلُ ورُوَّاده؛ فيُنتزَعُ مِنْ قلبه مَخافةُ الناسِ ويحتمل أذاهم في ذات الله؛ فلا يضرُّه فِعالُ المُبْطِلين الصادِّين، ولا يخشى كيدَ الكائدين والحاسدين، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣﴾ [آل عمران].
فهذه ـ إذن ـ الدعائمُ الإيمانيَّة للداعية، وهي مُقوِّماتُ زادِه في الدعوة إلى الله تعالى، وكُلَّما قَوِيَتْ مَعانيها في نَفْسِ الداعية كانَتْ علامةً ظاهرةً على عُمْقِ إيمانه وصحَّةِ منهجه وصدقِ دعوته، سالكًا فيها دَرْبَ العلماء العاملين، وماضيًا فيها على سنن المُرْسَلين والصدِّيقين.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: أوَّل جمادى الثانية ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ أفريل ٢٠١٢م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» بابُ ما يُتعوَّذ مِنَ الجبن (٢٨٢٣)، ومسلمٌ في «الذِّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (٢٧٠٦)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «القَدَر» (٢٦٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٥٢٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» باب: كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إذا لم يُقاتِلْ أوَّلَ النهارِ أخَّرَ القتالَ حتَّى تزول الشمسُ (٢٩٦٦)، ومسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٧٤٢)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ أبي أَوْفى رضي الله عنهما.
(٥) انظر: «جامِع البيان» للطبري (٢٤/ ٧٤).
(٦) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٦٣٩٥)، وأخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» بابُ التواضع (٦٥٠٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظُ البخاريِّ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ».
(٧) أخرجه البَغَويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٢٤٩) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه بلفظ: «وَإِنِّي لَأَغْضَبُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَغْضَبُ اللَّيْثُ الحَرِدُ». وضعَّف الألبانيُّ إسنادَه في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ٢٥٦).
(٨) الرُّزتاق والرُّستاق واحدٌ، فارسيٌّ مُعَرَّبٌ، ألحقوه بقرطاسٍ، ويقال: رزداقٌ ورستاقٌ، والجمع الرساتيق، وهي السواد، [انظر: «لسان العرب» (١٠/ ١١٦)]. وقال في باب «خلف»: (٩/ ٨٤): «قال ابنُ برِّي: المَخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام، والكُوَرِ لأهل العراق، والرساتيقِ لأهل الجبال، والطساسيجِ لأهل الأهواز».
(٩) «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧٣ ـ ٨٤).
- قرئت 18923 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)