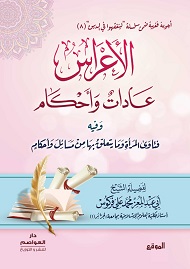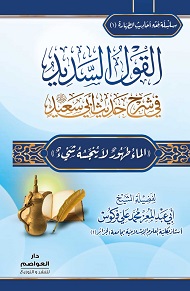العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف الحادي عشر: بيانُ معنَى الإيمان (٥)»
وَيَضْعُفُ بِضِدِّ ذَلِكَ(١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠](٢)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِينَ ٧٥﴾ [الأنعام](٣)، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ(٤) كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى(٥) مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ(٦) طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ(٧) إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ(٨) بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٩)، وَلِحَدِيثِ حَنْظَلَةَ(١٠) الأُسَيِّدِيِّ(١١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟» قَالَ: قُلْتُ: «نَافَقَ حَنْظَلَةُ!» قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟!» قَالَ: قُلْتُ: «نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا(١٢) الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَوَاللهِ(١٣) إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا!»، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: «نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ!!» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ(١٤)حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ [ﻓَ]نَسِينَا(١٥) كَثِيرًا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ(١٦) لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَ(١٧)فِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ المَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ ـ يَا حَنْظَلَةُ ـ سَاعَةً وَسَاعَةً ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ(١٨)»» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١٩).
(١) ذَكَر المصنِّف ـ رحمه الله ـ أنَّ الإيمان «يضعف بضِدِّ ذلك» أي: بترك النظر في آيات الله الكونية والتأمُّلِ فيها، وعدمِ التدبُّر لآياته السمعية، وتركِ التقرُّب بالعبادات الشرعية، واستشهد على ذلك بالنصوص الشرعية مِنَ الكتاب والسُّنَّة، والمعلومُ أنَّ كُلَّ دليلٍ دلَّ على زيادة الإيمان فهو يدلُّ على نقصانه باللزوم؛ لأنَّ الزيادة تَستلزِمُ النقصَ ولا تكون إلَّا منه، وبالعكس ـ أيضًا ـ فإنَّ كُلَّ دليلٍ دلَّ على نقصان الإيمان فهو يدلُّ على زيادته.
هذا، وقد تَرِدُ أسبابٌ أخرى غيرُ التي ذَكَرها المصنِّف ـ رحمه الله ـ لها تأثيرٌ في الإيمان بالنقصان، ومِنْ أعظمِها: الجهلُ المُضادُّ للعلم؛ لأنَّ الجهل وفسادَ العلم يُفْضِيان ـ بالضرورة ـ إلى فسادِ الأعمال ونقصِ الإيمان.
ومنها: الأعداء الباطنيون: كالشيطان ووسوستِه، والهوى، والنفسِ الأمَّارة بالسوء.
ومنها: اللهوُ واللعب، والغفلة والنسيان، والإعراض، وارتكابُ الذنوب وفعلُ المعاصي.
ومنها: الاشتغالُ بعَرَضِ الحياة الدنيا، والانهماكُ في طلبها، والسعيُ في فتنتها، والجريُ خلف مَلَذَّاتها ومُغْرِيَاتها.
ومنها: مخالَطةُ الأشرارِ وصحبةُ قُرَناءِ السوء.
فهذه الأسبابُ المُضادَّةُ لزيادة الإيمان وغيرُها مِنْ أعظمِ المؤثِّرات على نقصانه، بل قد يضعف إيمانُ قلبِ العبد إلى غايةِ الاضمحلال والتلاشي. والمسلمُ الحريصُ على دِينِه والخائفُ مِنْ ضعفِ إيمانه مُطالَبٌ بأَنْ يعرف هذه الأسبابَ؛ ليكون على حذرٍ منها، وليُجاهِدَ نَفْسَه ويُبْعِدَها عن الوقوع فيها.
(٢) جزءٌ مِنَ الآية: ٢٦٠ مِنْ سورة البقرة.
والآية في قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] تدلُّ على ازديادِ اليقين وتقويةِ الإيمان بالرؤية البصرية والمشاهَدةِ الواقعية لكيفيةِ إحياءِ الموتى، وذلك معدودٌ مِنْ آيات الله الكونية.
قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في [«فتح الباري» (١/ ٤٧)]: «روى ابنُ جريرٍ بسنده الصحيح إلى سعيدٍ قال: قولُه: ﴿لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِي﴾ أي: يزدادَ يقيني، وعن مجاهدٍ قال: لأزداد إيمانًا إلى إيماني، وإذا ثَبَتَ ذلك عن إبراهيم عليه السلام ـ مع أنَّ نبيَّنا صلَّى الله عليه وسلَّم قد أُمِر باتِّباعِ مِلَّته ـ كان كأنَّه ثَبَتَ عن نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك».
ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الآية السالفةَ الذِّكْرِ تدلُّ على مرتبتَيِ اليقين، حيث أراد إبراهيمُ الخليل عليه السلام الانتقالَ مِنْ «علمِ اليقين» الذي يعلمه الإنسانُ بالدليل الشرعيِّ أو العقليِّ إلى «عين اليقين» الذي يحصل بمشاهَدةِ الشيء بعد العلم اليقينيِّ به، وهذا الانتقالُ مِنْ «علم اليقين» إلى «عين اليقين» أنفى للشكِّ؛ لأنَّ معنى الحديثِ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]» [أخرجه البخاريُّ في «الأنبياء» (٦/ ٤١٠ ـ ٤١١) بابُ قولِه: ﴿وَنَبِّئۡهُمۡ عَن ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٥١﴾ [الحِجْر]، ومسلمٌ في «الفضائل» (١٥/ ١٢٣) بابُ فضائلِ إبراهيمَ الخليلِ عليه السلام، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه] معناه ـ على الصحيح ـ: نحن أحقُّ بالشكِّ مِنْ إبراهيم؛ فإذا كُنَّا نحن لم نَشُكَّ فإبراهيمُ أَوْلى بنفيِ الشكِّ عنه، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في بيانِ هذا المعنى ما نصُّه في [«فتح الباري» (٦/ ٤١٢)]: «أي: «لو كان الشكُّ متطرِّقًا إلى الأنبياء لَكنتُ أنا أحَقَّ به منهم، وقد علمتم أنِّي لم أشكَّ؛ فاعلموا أنه لم يشكَّ»، وإنما قال ذلك تواضعًا منه، أو مِنْ قبلِ أَنْ يُعْلِمه اللهُ بأنه أفضلُ مِنْ إبراهيم .. وقِيلَ: إنَّ سبب هذا الحديثِ أنَّ الآية لمَّا نزلَتْ قال بعضُ الناس: «شكَّ إبراهيمُ ولم يشكَّ نبيُّنا»، فبَلَغه ذلك فقال: «نحن أحقُّ بالشكِّ مِنْ إبراهيمَ»، وأراد ما جَرَتْ به العادةُ في المخاطَبةِ لمَنْ أراد أَنْ يدفع عن آخَرَ شيئًا قال: «مهما أرَدْتَ أَنْ تقوله لفلان فقُلْه لي»، ومقصودُه: «لا تَقُلْ ذلك»، وقِيلَ: أراد بقوله: «نحن» أمَّتَه الذين يجوز عليهم الشكُّ، وإخراجه هو منه بدلالة العصمة، وقِيلَ: معناه: «هذا الذي ترَوْنَ أنه شكٌّ أنا أَوْلى به؛ لأنه ليس بشكٍّ، إنما هو طلبٌ لمزيدِ البيان»، وحكى بعضُ علماءِ العربية أنَّ «أفعل» ربَّما جاءَتْ لنفيِ المعنى عن الشيئين نحوَ قولِه تعالى: ﴿أَهُمۡ خَيۡرٌ أَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٖ﴾ [الدخان: ٣٧]، أي: لا خيرَ في الفريقين، ونحوُ قولِ القائل: «الشيطان خيرٌ مِنْ فلان» أي: لا خيرَ فيهما؛ فعلى هذا فمعنَى قولِه: «نحن أحقُّ بالشكِّ مِنْ إبراهيمَ»: لا شكَّ عندنا جميعًا»، وفي المسألةِ أقوالٌ مختلفةٌ في بيانِ المُراد بنفي الشكِّ عن إبراهيمَ في الحديث، مبسوطةٌ في موضعها لا تخلو مِنْ مَقالٍ.
ولليقين مرتبةٌ ثالثةٌ تحصل بمُباشَرةِ الشيء بعد العلم اليقينيِّ به ومشاهَدتِه له بعد العلمِ به، وتُسمَّى هذه المرتبةُ ﺑ «حقِّ اليقين».
(٣) الآية: ٧٥ مِنْ سورة الأنعام.
ومعنى الآية: أنَّ الله تعالى وفَّق إبراهيمَ الخليلَ عليه السلام للتوحيد ليرى ـ بنظره ـ بديعَ صُنْعِه وعظيمَ مَلَكوتِه، وما اشتمل عليه مِنَ الأدلَّةِ الساطعة على وحدانية الله تعالى في مُلْكه وخَلْقِه؛ فيحصل له اليقينُ ويزداد له الإيمانُ بحسَبِ التأمُّل في تلك الآياتِ الكونية الظاهرة، [انظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٢٤٧)، «تفسيرَ ابنِ كثير» (٢/ ١٥٠)، «تفسير السعدي» (٢٩٢)]، وهذا مِنْ فوائدِ العلم الذي «يُثْمِرُ اليقينَ الذي هو أعظمُ حياةِ القلب، وبه طمأنينتُه وقوَّتُه ونشاطُه وسائرُ لوازمِ الحياة» كما قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«مفتاح دار السعادة» (١/ ٤٧٦)].
(٤) كذا في روايةِ مسلمٍ، وفي النسخة المطبوعة: «مُسْلِمٍ»، وهي روايةُ الترمذيِّ وابنِ ماجه.
(٥) كذا في كُلِّ الروايات، وفي النسخة المطبوعة: «عَنْ»، ولا تُوجَدُ في أيٍّ مِنَ الروايات.
(٦) ساقطةٌ مِنَ النسخة المطبوعة مُوافَقةً لروايةِ الترمذيِّ، وهي ثابتةٌ في روايةِ مسلمٍ.
(٧) كذا في روايةِ مسلمٍ، وفي النسخة المطبوعة: «فيما بينهم»، وهي غيرُ مُثْبَتةٍ في المرويَّات المخرَّجة.
(٨) كذا في روايةِ مسلمٍ: «بطَّأ» مِنَ التبطئة، وفي المطبوعة: «أبطأ» كما ثَبَتَتْ في رواية الترمذيِّ وابنِ ماجه والطبرانيِّ، مِنَ الإبطاء، وهما ضِدُّ التعجُّل، والبطوءُ: نقيضُ السرعة، [انظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (٨/ ٢٦٩)]. قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح مسلم» (١٧/ ٢٢)]: «معناه: مَنْ كان عملُه ناقصًا لم يُلْحِقْه بمرتبةِ أصحاب الأعمال، فينبغي أَنْ لا يَتَّكِلَ على شرفِ النسب وفضيلةِ الآباء ويقصِّرَ في العمل».
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الذِّكْر والدعاء» (١٧/ ٢١) بابُ فضلِ الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكْر، كما أخرجه الترمذيُّ في «القراءات» (٥/ ١٩٥) باب (١٢)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٨٢) بابُ فضلِ العلماء والحثِّ على طلب العلم، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا، والحديث استدلَّ به المصنِّف ـ رحمه الله ـ على تقويةِ الجزء الأصليِّ في الإيمان ـ وهو: التصديق بالقلب والإقرارُ به ـ وذلك بالتقرُّب بالطاعات، ومنها: طلبُ العلم الشرعيِّ، وما يجني مِنْ ثمراتِ مجالَسةِ الصالحين مِنْ أهل التقوى والإيمان المتَّبِعين للهدي النبويِّ المُلْتزِمين بالسنَّة، وما يحصل مِنْ فضلِ مجالسِ الذِّكر والذاكرين المُشتمِلةِ على تلاوة القرآن وتدبُّره ومُدارَستِه، وما تحويه مِنْ عمومِ الذِّكْر الواردِ مِنْ: تسبيحٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ وغيرِها، كما تَشتمِلُ على الدعاء بخيرَيِ الدنيا والآخرة، وقراءةِ الحديث النبويِّ، ودراسةِ العلم الشرعيِّ والمناظَرةِ فيه، مِنْ جملةِ ما يدخل تحت مسمَّى ذِكْرِ الله تعالى، [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢١٢)]، على أَنْ تكون هذه المجالسُ مُنعقِدةً على الوجه الشرعيِّ، ومقيَّدةً باتِّباعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيها، مِنْ غيرِ ابتداعٍ في هيئاتها وأشكالِهَا وصُوَرِها كما هو الشأنُ في القراءة الجماعية؛ حتَّى تتَّصِفَ بالصلاح ويُجْنى منها الخيرُ والبَرَكةُ؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في [«تفسيره» (١/ ٣٦٩)]: «هذه الآيةُ الكريمةُ حاكمةٌ على كُلِّ مَنِ ادَّعى محبَّةَ اللهِ وليس هو على الطريقةِ المحمَّدية؛ فإنه كاذبٌ في دعواهُ في نفس الأمر حتَّى يتَّبِعَ الشرعَ المحمَّديَّ والدِّينَ النبويَّ في جميعِ أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثَبَتَ في الصحيح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٢/ ١٦) بابُ نقضِ الأحكام الباطلة وردِّ مُحْدَثاتِ الأمور، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها]».
(١٠) هو الصحابيُّ أبو ربعيٍّ حنظلةُ بنُ الربيع الصيفيُّ الأُسَيِّديُّ التميميُّ، يقال له: الكاتب، وهو أحَدُ الذين كتبوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وروى عنه، وشَهِد القادسيةَ، ونَزَل الكوفةَ، وتخلَّف عن عليٍّ رضي الله عنه في قتال أهل البصرة يومَ الجمل، وتُوُفِّيَ في خلافةِ معاويةَ بنِ أبي سفيان رضي الله عنهم ولا عَقِبَ له.
انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (١/ ٣٧٩)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٥٨)، «الإصابة» لابن حجر (١/ ٣٥٩)، «الرياض المستطابة» للعامري (٥٦).
(١١) الأُسَيِّديُّ: نسبةٌ إلى أُسَيِّد بنِ عمرو بنِ تميمٍ، وهُم مِنْ أشرافِ بني تميمٍ العدنانية، [انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٢١٠)، «نهاية الأرب» للقلقشندي (٤٩ ـ ٥٠)، «اللباب» لابن الأثير (١/ ٦١)].
(١٢) مِنَ المعافسة: المُعالجة والممارسة والمُلاعبة، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٢٦٣)].
قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح مسلم» (١٧/ ٦٦)]: «معناه: حاوَلْنا ذلك ومارَسْناه واشتغَلْنا به، أي: عالَجْنا مَعايِشَنا وحظوظَنا، والضَّيْعاتُ: جمعُ ضَيْعةٍ ـ بالضاد المعجمة ـ وهي مَعاشُ الرَّجُل مِنْ مالٍ أو حرفةٍ أو صناعةٍ».
(١٣) ساقطةٌ مِنَ النسخة المطبوعة، وهي ثابتةٌ في روايةِ مسلمٍ والترمذيِّ.
(١٤) وفي النسخة المطبوعة: Mبِالجَنَّةِ وَالنَّارِL.
(١٥) كذا في النسخة المطبوعة، وفي مسلمٍ: «نسينا»، وعند الترمذيِّ: «ونسينا».
(١٦) ساقطةٌ مِنَ النسخة المطبوعة، وأثبَتْناها موافَقةً لروايةِ مسلمٍ.
(١٧) كذا ـ بالواو ـ في روايةِ مسلمٍ، وهي ساقطةٌ مِنَ النسخة المطبوعة.
(١٨) وفي النسخة المطبوعة بتكريرِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «سَاعَةً وَسَاعَةً» ثلاثَ مرَّاتٍ.
(١٩) أخرجه مسلمٌ في «التوبة» (١٧/ ٦٥ ـ ٦٧) بابُ فضلِ دوامِ الذِّكْرِ والفكر في أمور الآخرة، وأخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة» (٤/ ٦٦٦) باب: (٥٩). وابنُ ماجه في «الزهد» (٢/ ١٤١٦) بابُ المداوَمة على العمل، مِنْ حديثِ حنظلة بنِ الربيع الأُسَيِّديِّ رضي الله عنه. وأخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» في «البرِّ والإحسان» (٢/ ٥٥) بابُ ما جاء في الطاعات وثوابها، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
ووجه استدلال المصنِّف ـ رحمه الله ـ بهذا الحديث: أنَّ حنظلة بنَ الربيع رضي الله عنه خاف مِنَ النفاق، والخوفُ إنما حَصَل له بعد أَنْ كان في مجلسِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يزداد إيمانُه بالذِّكْر وشدَّةِ التفكُّر والاعتبار والمراقَبةِ والإقبال على الآخرة، فإذا خَرَج اشتغل بالأزواج والأولاد ومَعاشِ الدنيا؛ الأمرُ الذي أشعره بضعفٍ في إيمانه إذا ما قُوبِلَ بما كان عليه في مجلس الذِّكْر؛ فخاف أَنْ يكون ذلك نفاقًا، فأعلمه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه ليس بنفاقٍ؛ إذ ليس في مقدوره الدوامُ على درجةٍ واحدةٍ مِنَ الإيمان لكونه مُتفاوِتَ الدرجات؛ فساعةً يزيد إيمانُه إذا حَصَلَتْ أسبابُ الزيادة، وساعةً يضعف إذا حَصَلَتْ أسبابُ النقص.
ـ يُتْبَع ـ
الجزائر في: ١٥ المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٣ جانفي ٢٠٠٨م
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 4838 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)