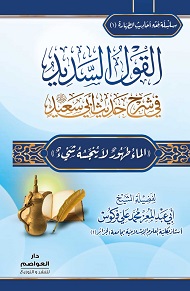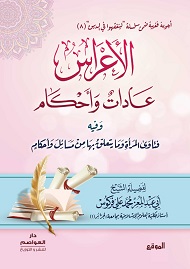العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف الثاني عشر: بيـانُ معنى الإيمـان (٦)»
التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: مَنْ عُدِمَ مِنْ إِيمَانِهِ اليَقِينُ خَرَجَ مِنْ دَائِرَةِ المُؤْمِنِينَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الكَافِرِينَ، وَلَوْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَعَمِلَ أَعْمَالَ المُؤْمِنِينَ(١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾(٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾(٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾(٤).
(١) اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، واستقرارُ العلم فيه بحيث لا يتطرَّق إليه شكٌّ ولا احتمالٌ، وسببه شيئان: أحدهما: قوَّة الأدلَّة وكثرتها، والآخر: نورٌ مِن الله يضعه في قلب من يشاء، [انظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٢٩)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (٣٢١)]، فاليقين من زيادة الإيمان، وينتظم بأمرين: علم القلب، وعمل القلب، قال ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٣٣٧): «فإنَّ اليقين يراد به العلم المستقرُّ في القلب، ويراد به العمل بهذا العلم، فلا يُطلق الموقِن إلاَّ على من استقرَّ في قلبه العلم والعمل»، وقال ابن القيم -رحمه الله- في «الفوائد» (٢٥٦): «واليقين استقرار الإيمان في القلب علمًا أو عملاً»، وقال -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (٢/ ٦٣): «اليقين روح الأعمال وعمودها وذروة سنامها»، وقال في موضعٍ آخر من «مدارج السالكين» (٢/ ٣٩٧): «اليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقةٌ صدِّيقيةٌ، وهو قطب الشأن الذي عليه مدارُه… ومتى وصل اليقينُ إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقًا، وانتفى عنه كلُّ ريبٍ وشكٍّ وسخطٍ وهمٍّ وغمٍّ فامتلأ محبَّةً لله، وخوفًا منه، ورضًى به، وشكرًا له، وتوكُّلاً عليه، وإنابةً إليه».
ويوجَد ترابطٌ بين اليقين والإحسان، فمنتهى اليقين وغايتُه هو الإحسان، غير أنَّ الإحسان في عمل الجوارح واليقينَ في عمل القلب، قال ابن القيِّم -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (٢/ ٣٩٩) -عند تعرُّضه لتعريفات اليقين- بأنه: «ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبتُه إليه كنسبة المرئيِّ إلى العين فلا يبقى معه شكٌّ ولا ريبٌ أصلاً، وهذا نهاية الإيمان، وهو مقام الإحسان».
كما يوجَد ترابطٌ بين اليقين والعلم، إذ العلم أوَّلُ اليقين وغايتُه الإحسان -كما تقدَّم-.
هذا، وليس مقصود المصنِّف -رحمه الله- التعرُّضَ إلى اليقين من حيث منزلتُه وأنواعه ودرجاته، وإنما مراده أن يبيِّن اليقينَ الذي يُعَدُّ شرطًا في الإيمان ولا نجاةَ في الآخرة إلاَّ به، فهو اليقين الذي يقابله الشكُّ وينافيه، فالشكُّ نقيض اليقين، بحيث يتردَّد الشاكُّ بين وجود الشيء وعدمه، سواءٌ استوى الاحتمالان أو ترجَّح أحدهما، فالصدق والكذب سواءٌ، كمن لا يجزم بصدق الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا بعدم وقوعه، أو شكَّ في شيءٍ من القرآن أو في حكمٍ من أحكام الله أو خبرٍ من أخباره، أو شكَّ في كفر الكافر ونحو ذلك، فاليقين المنافي للشكِّ شرطٌ مِن شروط «لا إله إلاَّ الله»، ومَن شكَّ في الله أو في رسوله أو ما جاء به عن الله فهو كافرٌ لا شهادة له ولا إيمان إجماعًا، قال القاضي عياضٌ في [«الشفا» (٢/ ١١٠١)، «النسيم الرياض» للخفاجي (٤/ ٥٥٤)]: «اعلم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو المصحف أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما، أو جحده أو حرفًا منه أو آيةً، أو كذَّب به أو بشيءٍ منه، أو كذَّب بشيءٍ ممَّا صُرِّح به فيه مِن حكمٍ أو خبرٍ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علمٍ بذلك، أو شكَّ في شيءٍ من ذلك؛ فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماعٍ»، وقال -رحمه الله- في موضعٍ آخر (٢/ ١٠٦٩): «وكذلك من أضاف إلى نبيِّنا الكذبَ فيما بلَّغه وأخبر به، أو شكَّ في صدقه، أو سبَّه… فهو كافرٌ بإجماعٍ».
قلت: وإنما كفرُ الشكِّ إذا بقي شكُّه مستمرًّا مع إعراضه عن الأدلَّة الموجِبة للعلم، وامتناعِه عن النظر فيما يزيل شكَّه، قال ابن القيِّم في «مدارج السالكين» (١/ ٣٣٨): «أمَّا كفر الشكِّ: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذِّبه، بل يشكُّ في أمره، وهذا لا يستمرُّ شكُّه إلاَّ إذا ألزم نفسَه الإعراضَ عن النظر في آيات صدق الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم جملةً، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، أمَّا مع الْتفاته إليها ونظرِه فيها، فإنه لا يبقى معه شكٌّ».
فكفرُ الشكِّ يشبه كُفْرَ الإعراض مع وجود فرقٍ دقيقٍ بينهما، فكفرُ الإعراض هو: أن يُعْرِض بسمعه وقلبه عمَّا جاء الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يصدِّقه ولا يكذِّبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتَّةَ مع ترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبَه، فهو الكفر البسيط المتعلِّق بعمل القلب، وليس من اللازم أن يكون صاحبُه جاهلاً، بخلاف كفر الشكِّ فهو: الذي لا يجزم صاحبُه بصدق الرسول ولا يكذِّبه، بل يشكُّ في أمره، فكفرُه يتعلَّق بقول القلب، وهو التصديق الجازم بكلِّ ما أخبر به النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ويقع كفرُ الشكِّ بسبب اختلال شرط العلم، قال ابن تيمية في [«مجموع الفتاوى» (٢/ ٧٩)]: «وليس كلُّ كافرٍ مكذِّبًا، بل قد يكون مرتابًا، إن كان ناظرًا فيه أو معرضًا عنه بعد أن لم يكن ناظرًا فيه».
وحقيقٌ بالتنبيه أنه يوجَد فرقٌ -أيضًا- بين الريب والشكِّ، وبين الشكِّ والوسوسة.
أمَّا الريب فهو أعمُّ من الشكِّ؛ لأنَّ الريب على نوعين: نوعٌ يكون شكًّا بسبب الإخلال بشرط العلم، ونوعٌ يكون اضطرابًا في طمأنينة القلب وعمله، وبهذا الاعتبار فالشكُّ أخصُّ من الريب، ووصفُ اليقين إنما يُنعت به المتَّصف بالاطمئنان على عمومه سواءٌ من جهة علم القلب الذي هو أصل قول القلب، أو مِن جهة عمل القلب الذي هو أصل عمل الجوارح، قال ابن تيمية -رحمه الله- في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٨١)]: «والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب، بخلاف الشكِّ، فإنه لا يكون إلاَّ في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلاَّ من اطمأنَّ قلبُه علمًا وعملاً».
أمَّا الوسوسة فهي: الإلقاء الخفيُّ الذي يهجم على القلب ولا اختيارَ للعبد فيه، فإن كان ما أُلقي في النفس ممَّا تشهد له النصوص الشرعية من أنه مِن شرع الله وتقواه فذلك إلهامٌ محمودٌ، وإن دلاَّ على أنه فسقٌ وفجورٌ وعصيانٌ فتلك وسوسةٌ مذمومةٌ، سواءٌ كان مِن الشيطان بهمسه بإغوائه في القلب أو مِن النفس الأمَّارة بالسوء والفحشاء. قال ابن تيمية -رحمه الله- في [«مجموع الفتاوى» (١٧/ ٥٢٩)]: «فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنَّة، فإنْ كان ممَّا أُلقي في النفس ممَّا دلَّ الكتاب والسنَّة على أنه مِن تقوى الله فهو مِن الإلهام المحمود، وإن كان ممَّا دلَّ على أنه فجورٌ فهو من الوسواس المذموم، وهذا الفرق مطَّردٌ لا ينتقض».
والعبد إن كَرِه الوسوسةَ الإغوائية المذمومة ودَفَعها ونفاها كانت كراهتُه مِن صريح الإيمان، قال ابن تيمية -رحمه الله- في [«مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٨٢)]: «والمؤمن مبتلًى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدرُه، كما قالت الصحابة: «يا رسول الله، إنَّ أحدنا ليجد في نفسه ما لَأَنْ يخرَّ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه مِن أن يتكلَّم به»، فقال: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ»، وفي روايةٍ: «ما يتعاظم أن يتكلَّم به» قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الوَسْوَسَةِ» أي: حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعِه عن القلب، وهو مِن صريح الإيمان كالمجاهد الذي جاء العدوُّ فدَافَعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد».
أمَّا الشاكُّ في صدق الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وممَّا جاء به فهو تاركٌ للإيمان الذي لا نجاة له إلاَّ به فافترقا.
(٢) جزءٌ من الآية ١٣٦ من سورة النساء.
(٣) الآية ١٥٠، ١٥١ من سورة النساء.
(٤) الآية ١ من سورة المنافقون.
وقد استدلَّ المصنِّف -رحمه الله- بهذه الآيات القرآنية التي لا يظهر فيها كفرُ الشكِّ بجلاءٍ ووضوحٍ، ولأهل العلم أدلَّةٌ شرعيةٌ أخرى استدلُّوا بها على أن يكون ناطقُ الشهادتين مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة، فإنَّ الإيمان الجازم لا يغني فيه إلاَّ علمُ اليقين لا علمُ الظنِّ، فمنها قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، قال الحكميُّ في «معارج القبول» (٥/ ٤١٩) في دلالة الآية: «فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونَهم لم يرتابوا، أي: لم يشكوا، فأمَّا المرتاب فهو من المنافقين -والعياذ بالله- الذي قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [التوبة: ٤٥]، ومنها: قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ» [أخرجه مسلم في «الإيمان» (١/ ٢٢٤) باب الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد دخل الجنَّةَ قطعًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، وفي روايةٍ: «لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ» [أخرجه مسلم في «الإيمان» (١/ ٢٢٦) باب الدليل على مَن مات على التوحيد دخل الجنَّةَ قطعًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].
ومنها: قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأبي هريرة رضي الله عنه في حديثٍ طويلٍ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَهُ مِنْ وَرَاءِ الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ» [أخرجه مسلم في «الإيمان» (١/ ٢٣٩) باب الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد دخل الجنَّة قطعًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].
وهذه الأحاديث إنما هي فيمن قال بالشهادتين ومات عليها، غيرَ أنها مشروطةٌ بمن أتى بهما مستيقنًا بها قلبُه غيرَ شاكٍّ فيها، كما جاءت في أحاديثَ أخرى مقيَّدةً بمن قالها خالصًا من قلبه وبصدقٍ ويقينٍ دخل الجنَّةَ ولم يُحْجَبْ عنها، ولا يخفى أنَّ الشرط إذا انتفى ينتفي معه المشروطُ لأنه يَلْزَم مِن عدمه العدمُ.
... يتبع ...
الجزائر في:١٥ ربيع الأول ١٤٢٩ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٣ مارس ٢٠٠٨م
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 4954 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)