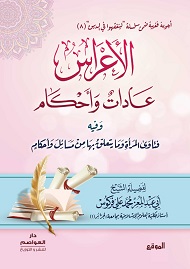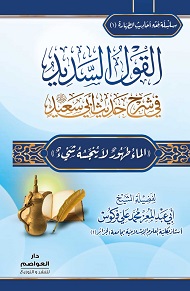العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف السابع والعشرون: عقيدة الإثبات والتَّنـزِيه (٩)»
[فَصْلٌ](١)
وَنُثْبِتُ الاِسْتِوَاءَ(٢) وَالنُّزُولَ(٣) وَنَحْوَهُمَا(٤)، وَنُؤْمِنُ بِحَقِيقَتِهِمَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفٍ(٥)، وَبِأَنَّ ظَاهِرَهَا المُتَعَارَفَ -فِي حَقِّنَا- غَيْرُ مُرَادٍ.
(١) يجدر التنبيه إلى أنَّ الأستاذ محمَّد الصالح رمضان أفصح عن تصرُّفه في نصِّ المصنِّف بتقديم هذه الفقرة إلى موضعٍ آخَرَ يراه أنسبَ بها حيث يقول: «ملحوظة: قوله: «ونُثبت الاستواء والنزول» إلى قوله «غير مرادٍ» كان في الأصل بعد صفة الكلام رقم: (٤٦)، ومن غير استشهادٍ عليه بالآيات والأحاديث، فرأيتُ إثباتَه هنا تحت هذا العنوان، ثمَّ تأتي بقيَّة الصفات كما رتَّبها الأستاذ الإمام واستدلَّ عليها بالآيات والأحاديث، وأرجو ألاَّ يكون هذا من التحكُّم وسوء التصرُّف» [تعليق محمَّد الصالح رمضان على «العقائد الإسلامية» (٧٣)].
أقول: والأَوْلى الاستبقاء على سياق المصنِّف -رحمه الله- والمحافظة على ترتيبه الأصلي دون المساس بنصِّ المصنِّف إلاَّ إشارةً مقترحةً على الهامش -أوَّلاً-، ولأنَّ طابع التأليف بينهما يستدعي هذا النسق من الترتيب بين الصفات الذاتية المتعقَّبة بالصفات الفعلية -ثانيًا-، فضلاً عن كون سياق المصنِّف يكشف مخالفتَه لأصول البدعة الأشعرية، حيث إنهم لا يُثبتون من الصفات الخبرية إلاَّ الصفات السبع المشهورة التي هي صفات المعاني، وهي: السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام [النفسي الذي تقدَّم بيانه سابقًا]، وينفون قيامَ الأفعال الاختيارية بالله تعالى كالاستواء والنزول والمحبَّة والرضا والفرح ونحوها.
(٢) استواء الله تعالى على عرشه صفةٌ فعليةٌ خبريةٌ متعلِّقةٌ بمشيئته وقدرته ثابتةٌ بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة ويدلُّ عليها قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وقوله تعالى في ستَّة مواضعَ أخرى من القرآن: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤، يونس: ٣، الرعد: ٢، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤]، وقد ثبت في السنَّة الصحيحة أحاديثُ كثيرةٌ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» [أخرجه البخاري في «التوحيد» (١٣/ ٤٠٤) باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، ومسلم في «التوبة» (١٧/ ٦٨) بابٌ في سعة رحمة الله تعالى].
وقد أجمع الصحابة وأئمَّة السلف على إثبات صفة الاستواء لله جلَّ وعلا، ونقل الصابوني -رحمه الله- هذا الاتِّفاقَ في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (١٥، ١٦) بقوله: «وعلماء الأمَّة وأعيان الأئمَّة من السلف -رحمهم الله- لم يختلفوا في أنَّ الله تعالى على عرشه، وعرشُه فوق سماواته، يُثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدِّقون الربَّ جلَّ جلاله في خبره، ويُطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويُمرُّونه على ظاهره، ويكِلُون عِلْمَه إلى الله»، كما ذكر الحافظ ابن حجرٍ -رحمه الله- الإجماعَ عند إيراده لأقوال أئمَّة السنَّة في إثبات صفة الاستواء، فقال في «فتح الباري» (١٣/ ٤٠٧-٤٠٨) في سياق التعقيب: «فكيف لا يوثق بما اتَّفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة».
هذا، والنصوص الشرعية السابقة تضمَّنت -أيضًا- إثبات صفة العلوِّ لله تعالى لمجيء الاستواء مقيَّدًا ﺑ«على» في النصِّ القرآني وهو يدلُّ على معنى العلوِّ والارتفاع والاعتدال والصعود والاستقرار، وهي المعاني التي أثبتها أهل السنَّة ولا يحتمل أيَّ معنًى آخرَ أصلاً إلاَّ عند إطلاقه أو تقييده بحرفٍ آخَرَ غيرِه، وقد بيَّن ابن القيِّم -رحمه الله- هذا الوجه في معرض الردِّ على منكري الاستواء وتأويلهم له بالاستيلاء من اثنين وأربعين وجهًا حيث يقول -رحمه الله-: «أحدها: أنَّ لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بِلُغَتهم وأنزل بها كلامَه نوعان: مطلقٌ ومقيَّدٌ، فالمطلق ما لم يُوصَلْ معناه بحرفٍ مثل قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ [القصص: ١٤] وهذا معناه: كَمُلَ وتمَّ، يقال: استوى النبات واستوى الطعام، وأمَّا المقيَّد فثلاثة أضرابٍ: أحدها: مقيَّدٌ ﺑ«إلى» كقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩، فُصِّلت: ١١]، واستوى فلانٌ إلى السطح وإلى الغرفة، وقد ذكر سبحانه هذا المعدَّى ﺑ«إلى» في موضعين من كتابه: في البقرة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩] والثاني في سورة السجدة (كذا في الأصل والصواب: فُصِّلت): ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصِّلت: ١١] وهذا بمعنى العلوِّ والارتفاع بإجماع السلف، ...
والثاني: مقيَّدٌ ﺑ«على» كقوله: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف: ١٣]، وقوله: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ [هود: ٤٤] وقوله: ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا أيضًا معناه العلوُّ والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.
الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدِّي الفعلَ إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبةَ بمعنى ساواها، وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى «استولى» ألبتَّة، ولا نقله أحدٌ من أئمَّة اللغة الذين يُعتمد قولهم، وإنما قاله متأخِّرو النحاة ممَّن سلك طريقَ المعتزلة والجهمية» [«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي (٢/ ٣٢٠)].
فمعتقد أهل السنَّة -إذًا- أنَّ الله جلَّ وعلا مستوٍ على عرشه بذاته حقيقةً فوق السماء السابعة استواءً يليق بجلاله، بائنٌ من خلقه ولا يعلوه خلقٌ من خلقه، فهُمْ يُثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تكييفٍ ولا تشبيهٍ ولا تعطيلٍ، وينكرون تأويلَ الصفات وإخراجَها عن ظاهرها إلى معانٍ لا تحتملها اللغة ولا يصيغها الشرعُ، وقد اشتهر عن الإمام مالكٍ -رحمه الله- قوله: «الاستواء معلومٌ، والكيف غير معقولٍ، والإيمان به واجبٌ، والسؤال عنه بدعةٌ»، وهذه المقالة المشهورة مع اختلافٍ يسيرٍ في بعض ألفاظها محفوظةٌ -أيضًا- عن غيره، وقد غدت قاعدةً عامَّةً وميزانًا محكمًا ينطبق على جميع نصوص الصفات. قال الذهبي -رحمه الله- في تعليقه على المقالة السابقة في «مختصر العلوِّ» (١٤١-١٤٢): «هذا ثابتٌ عن مالك، وتقدَّم نحوه عن ربيعة شيخ مالكٍ، وهو قول أهل السنَّة قاطبة "أنَّ كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأنَّ استواءه معلومٌ كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نتعمَّق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا إثباتًا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويلٌ لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولَما وَسِعهم إقرارُه وإمرارُه والسكوت عنه، ونعلم يقينًا مع ذلك أنَّ الله جلَّ جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا».
وقد استدلَّت الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة ومن متأخِّري الأشاعرة كالغزَّالي والرازي والآمدي على تفسير الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيتٍ مجهولٍ لم يَقُلْه شاعرٌ معروفٌ يصحُّ الاحتجاج بقوله، وهو:
قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ
قال ابن تيمية -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ١٤٦) في معرض الردِّ على هذا الاستدلال بقوله: «ولم يثبت نقلٌ صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌّ، وكان غير واحدٍ من أئمَّة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيتٌ مصنوعٌ لا يُعرف في اللغة، وقد عُلم أنه لو احتُجَّ بحديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لاحتاج إلى صحَّته، فكيف ببيتٍ من الشعر لا يُعرف إسناده وقد طعن فيه أئمَّة اللغة ..».
وقد ذكر ابن كثيرٍ -رحمه الله- في «البداية والنهاية» (٩/ ٧) أنَّ البيت للأخطل وقد كان نصرانيًّا، وقال في موضعٍ آخَرَ من المصدر نفسه (٩/ ٢٦٢): « وهذا البيت تستدلُّ به الجهمية على أنَّ الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكَلِم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجَّةٌ ولا دليلٌ على ذلك، ولا أراد الله عزَّ وجلَّ باستوائه على عرشه استيلاءَه عليه، تعالى الله عن قول الجهمية علوًّا كبيرًا.
فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيًا عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشرٍ على العراق، واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه، وعرشُ الربِّ لم يكن ممتنعًا عليه نَفَسًا واحدًا حتى يقالَ استولى عليه أو معنى الاستواءِ الاستيلاءُ، ولا تجد أضعف من حجج الجهمية، حتى أدَّاهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجَّةٌ».
وإلى جانب هؤلاء النفاة ظهرت المفوِّضة الذين يُثبتون الاستواءَ من جهة النصوص الشرعية والإيمان به كلفظٍ، مع التوقُّف في المعنى المراد، أي: تفويض العلم بمعناها اللغوي وكذا الكيف إلى الله عزَّ وجلَّ، وهو مذهب البيهقي وأحدُ قولَيِ الرازي، وقد زعم كثيرٌ من الأشاعرة أنَّ القول بالتفويض هو قول السلف [انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (١١٥)، «الأسماء والصفات» للبيهقي (٥١٧)، «تحفة المريد» للقاني (٩١)، «الإتقان» للسيوطي (٢/ ٦)]. ولا يخفى أنَّ نسبة هذا القول إلى السلف نسبةٌ باطلةٌ، إذ لم يَرِدْ عن أحدٍ من السلف أنه فوَّض معنى الاستواء، بل المنقول عن السلف تصريحُهم بالمعنى المراد بالاستواء، وهو العلوُّ والارتفاع على العرش، مع الإيمان بأنَّ الله مستوٍ على العرش حقيقةً، وهو معلومٌ عنهم بالاضطرار، وقد تعرَّض الإمام أحمد للنصوص التي نسمِّيها متشابهاتٍ بتفسير معانيها آيةً آيةً وحديثًا حديثًا وبيَّن فساد ما تأوَّلها عليه الزائغون، ولم يتوقَّف فيها هو والأئمَّة قبله ولم يقل أحمد إنَّ هذه الآياتِ والأحاديثَ لا يفهم معناها إلا الله، ولا قال له أحدٌ ذلك، ممَّا يدلُّ على أنَّ التوقُّف عن بيان معاني آيات الصفات، وصرْفَ الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهبًا لأهل السنَّة -وهو أعرف بمذهب السلف-، وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقةً، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرُها وتُمرُّ كما جاءت دالَّةً على المعاني لا تُحرَّف ولا يُلْحَد فيها» [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٧/ ٤١٤)].
وقد جاء كلام ابن القيِّم -رحمه الله- مقرِّرًا لاتِّفاق السلف على هذا المعنى بقوله: «تنازع الناس في كثيرٍ من الأحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضعٍ واحدٍ، بل اتَّفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدلُّ على أنها أعظم النوعين بيانًا وأنَّ العناية ببيانها أهمُّ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين، وإثباتها من لوازم التوحيد، فبيَّنها الله سبحانه وتعالى ورسولُه بيانًا شافيًا لا يقع فيه لَبْسٌ يوقع الراسخين في العلم. وآياتُ الأحكام لا يكاد يفهم معانِيَها إلاَّ الخاصَّة من الناس، وأمَّا آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاصُّ والعامُّ، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية» [«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي (١/ ١٥)].
وفي مقابل أقوال المعطِّلة ظهرت المشبِّهة من الروافض والكرَّامية وغيرهم الذين يُثبتون استواءَ الله وارتفاعَه فوق عرشه، لكنَّهم تعمَّقوا فيما يُمنع الخوض فيه من كيفية استوائه، فبعضهم قال: إنَّ الله مماسٌّ لعرشه لا يفضل منه شيءٌ ولا يفضل عن العرش شيءٌ منه، وقال بعضهم: إنه على بعض أجزاء العرش، وقال آخَرون: إنَّ العرش مكانٌ له وإنَّ العرش امتلأ به وغير ذلك من أقوالهم في كيفية استوائه [انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٤٤-١٤٧، ٢/ ٢٢)، «مقالات الإسلاميِّين» للأشعري (١/ ٢٨٤)، «الفَرْق بين الفِرَق» للبغدادي (٢١٥)].
وبطلان قول المشبِّهة ظاهرٌ، ومذهبهم إنما هو نتيجةٌ لازمةٌ لأقوالهم في صفات الله وكلامهم في ذاته، فإنهم يصفون الله تعالى بأنه جسمٌ ذو أبعاضٍ، له قدرٌ من الأقدار، وأنه سبعة أشبارٍ بشبر نفسه ونحو ذلك من الأباطيل، إذ ليس لهم دليلٌ شرعيٌّ يستندون إليه، بل هو قولٌ على الله بغير علمٍ، والمعلوم أنَّ كيفية الاستواء وغيرها من الصفات ممَّا استأثر الله بعلمه، والمخلوقُ يقطع الطمعَ عن إدراك حقيقة ذات الله سبحانه وصفاته لأنَّ الله حجب نفسه وصفاتِه عن خلقه، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
فمذهب السلف –إذًا- وسطٌ بين المعطِّلة والمشبِّهة يُثبتون ذاتَه وصفاتِه من غير تمثيلٍ ولا تكييفٍ ولا تعطيلٍ، أمَّا غيرهم من أهل الأهواء فإنَّ كلَّ واحدٍ من الفريقين يجمع بين التعطيل والتمثيل، ويوضِّح ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٥/ ٢٧) صورة ذلك بقوله: « وكلُّ واحدٍ من فريقَيِ «التعطيل» و«التمثيل»: فهو جامعٌ بين التعطيل والتمثيل: أمَّا المعطِّلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلاَّ ما هو اللائق بالمخلوق ثمَّ شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثَّلوا أوَّلاً وعطَّلوا آخِرًا، وهذا تشبيهٌ وتمثيلٌ منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيلٌ لِما يستحقُّه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش لَلَزِمَ إمَّا أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا، وكلُّ ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلاَّ ما يثبت لأيِّ جسمٍ كان على أيِّ جسمٍ كان، وهذا اللازم تابعٌ لهذا المفهوم. أمَّا استواءٌ يليق بجلال الله تعالى ويختصُّ به فلا يَلزمه شيءٌ من اللوازم الباطلة التي يجب نفيُها كما يَلْزَم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثِّل: إذا كان للعالَم صانعٌ فإمَّا أن يكون جوهرًا أو عرضًا. وكلاهما محالٌ؛ إذ لا يُعقل موجودٌ إلاَّ هذان. وقوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثلٌ لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا يُعلم الاستواء إلاَّ هكذا، فإنَّ كليهما مثَّل وكليهما عطَّل حقيقةَ ما وصف الله به نفْسَه، وامتاز الأوَّل بتعطيل كلِّ اسمٍ للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواءٍ هو من خصائص المخلوقين.
والقول الفاصل: هو ما عليه الأمَّة الوسط؛ من أنَّ الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختصُّ به فكما أنه موصوفٌ بأنه بكلِّ شيءٍ عليمٍ وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنه سميعٌ بصيرٌ ونحو ذلك. ولا يجوز أن يُثْبَت للعلم والقدرة خصائصُ الأعراض التي لِعِلْمِ المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يُثْبَت لفوقيته خصائصُ فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمُها.»
(٣) نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا صفةٌ فعليةٌُ خبريةٌ متعلِّقةٌ بمشيئة الله وقدرته ثابتةٌ لله تعالى بالأحاديث الصحيحة التي بلغت حدَّ التواتر، وأشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» [أخرجه البخاري في «التهجُّد» (٣/ ٢٩) باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (١/ ٥٢١) باب: ٢٤. الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، وأخرجه غيرهما. قال ابن عبد البرِّ في «التمهيد» (٧/ ١٢٨): «وهو حديثٌ منقولٌ من طرقٍ متواترةٍ ووجوهٍ كثيرةٍ من أخبار العدول عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم»].
واتَّفق السلف على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى حقيقةً كما يليق بجلاله، والإيمانِ بها وإجرائها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، قال ابن عبد الهادي -رحمه الله- في «الصارم المنكي» (١٩١): «واعلم أنَّ السلف الصالح ومن سلك سبيلَهم من الخلف متَّفقون على إثبات نزول الربِّ تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا»، وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «حديث النزول» (٥): «واتَّفق سلف الأمَّة وأئمَّتها وأهل العلم بالسنَّة والحديث على تصديق ذلك وتلقِّيه بالقبول»، كما نقل ابن تيمية -رحمه الله- كلامَ أبي عمرٍو الطلمنكي -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٥/ ٥٧٧) أنه قال: «وأجمعوا -يعني: أهلَ السنَّة والجماعة- على أنَّ الله ينزل كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء لا يحدُّون في ذلك شيئًا».
وأهل السنَّة والجماعة وسطٌ بين من يفسِّر نزولَه بنزول أمره ورحمته وهُمُ المعطلة وبين من يمثِّل نزوله بنزول المخلوقين وهُمُ المشبِّهة، فإنَّ أهل السنَّة يُثبتون نزول الله تعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا نزولاً حقيقيًّا ويُمرُّون الأخبار الثابتة كما جاءت على ظاهرها من غير تشبيهٍ له بنزول المخلوقين ولا تمثيلٍ ولا تكييفٍ ولا تعطيلٍ، وإنما يُثبتون ما أثبته النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وينتهون فيه إليه، ويكِلُون علمه إلى الله تعالى، ذلك لأنَّ الله تعالى ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما لا تُعلم كيفية ذاته فلا تُعلم كيفية صفاته، إذ العلم بكيفية الصفة يتبع العلمَ بكيفية الموصوف. قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله- في «التمهيد» (٧/ ١٥٣): «وقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» عندهم مثل قول الله عزَّ وجلَّ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ ومثل قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ كلُّهم يقول: ينزل ويتجلَّى ويجيء بلا كيفٍ، لا يقولون كيف يجيء؟ وكيف يتجلَّى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين تجلَّى؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه ليس كشيءٍ من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له، وفي قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبل ذلك متجلِّيًا للجبل، وفي ذلك ما يفسِّر معنى حديث التنزيل». وقال الذهبي -رحمه الله- في «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٣٧٦): «هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحَّت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرَّضوا لها بردٍّ ولا تأويلٍ، بل أنكروا على من تأوَّلها مع إصفاقهم على أنها لا تُشبه نعوتَ المخلوقين، وأنَّ الله ليس كمثله شيءٌ، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإنَّ في ذلك محاولةً للردِّ على الله ورسوله، أو حَوْمًا على التكييف أو التعطيل».
وقد تعرَّض ابن تيمية -رحمه الله- لهذه المسألة في كتابه «شرح حديث النزول» مبيِّنًا فيه مذهب السلف وأئمَّة السنَّة، فأقام الحجج والأدلَّة، وفنَّد شبهات المعطِّلة والمؤوِّلة والمشبِّهة ونقضها من أساسها نقضًا علميًّا محكمًا.
هذا، وإن كان أهل السنَّة لم يُحفظ عنهم نزاعٌ في تقرير هذا المذهب في الصفات مع اتِّفاقهم على صفة النزول إلاَّ أنهم يختلفون في مسألة خلوِّ العرش منه حالَ نزوله، وما عليه جمهور أهل السنَّة أنَّ الله ينزل ولا يخلو منه العرش، وبه قال الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وحمَّاد بن زيد وغيرهم [انظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية (١٤٩)]. وهذه المسألة مرتبطةٌ بأنواع الفعل الاختياري كالنزول والمجيء والإتيان والذهاب والهبوط: هل هي بحركةٍ وانتقالٍ أم لا؟
قال ابن تيمية -رحمه الله- في «شرح حديث النزول» (٥٨) و«مجموع الفتاوى» (٥/ ٤٠٢): «واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنَّة والحديث: في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك. هل يقال: إنه بحركةٍ وانتقالٍ؟ أم يقال: بغير حركةٍ وانتقالٍ؟ أم يُمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوالٍ ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب «اختلاف الروايتين والوجهين». فالأوَّل قول أبي عبد الله بن حامدٍ وغيره. والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. والثالث: قول أبي عبد الله بن بطَّة وغيره».
قلت: والذي يتوافق مع أصول أهل السنَّة وقواعدهم هو إثبات ما أثبته الكتاب والسنَّة مع التقيُّد بألفاظ الشارع ونصوصه، وعدم التعرُّض بنفيٍ ولا إثباتٍ لِما لم يَرِدْ فيهما، فالإمساك عن الأمرين هو أحقُّ بالصواب والاتِّباع كما أفصح عن ذلك ابن القيِّم -رحمه الله- بقوله: «وأمَّا الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرَّك وينتقل، ولا ننفي ذلك عنه، فهُمْ أسعد بالصواب والاتِّباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النصُّ، وسكتوا عمَّا سكت عنه، وتظهر صحَّة هذه الطريقة ظهورًا تامًّا فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النصُّ عنها مجملةً محتمِلةً لمعنيين: صحيحٍ وفاسدٍ، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيِّز والجهة والأعراض والحوادث والعلَّة والتغيُّر والتركيب، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حقٌّ وباطلٌ، فهذه لا تُقبل مطلقًا ولا تُرَدُّ مطلقًا، فإنَّ الله سبحانه لم يُثبت لنفسه هذه المسمَّيات ولم يَنْفِها عنه، فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأ ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ، فإنَّ معانِيَها منقسمةٌ إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له، فإنَّ الانتقال يراد به انتقالُ الجسم والعَرَض من مكانٍ هو محتاجٌ إليه إلى مكانٍ آخَرَ يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباتُه للربِّ تعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتُها لله تعالى، ويراد بالحركة والانتقال حركةُ الفاعل من كونه غيرَ فاعلٍ إلى كونه فاعلاً، وانتقاله -أيضًا- من كونه غيرَ فاعلٍ إلى كونه فاعلاً. فهذا المعنى حقٌّ في نفسه لا يُعقل كونُ الفاعل فاعلاً إلاَّ به، فنفيُه عن الفاعل نفيٌ لحقيقة الفعل وتعطيلٌ له، وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعمُّ من ذلك، وهو فعلٌ يقوم بذات الفاعل يتعلَّق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاعَ الفعل بنفسه فيه، وقد دلَّ القرآن والسنَّة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يومَ القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظُلَلٍ من الغمام والملائكةُ، وينزل كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا، وينزل عشيَّةَ عرفةَ، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنَّة، وهذه أفعالٌ يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيُها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصَّة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصَّة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجُزْ نفيُه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجُزْ إثباتُه له، وحركة الحيِّ من لوازم ذاته، ولا فرْقَ بين الحيِّ والميِّت إلا بالحركة والشعور، فكلُّ حيٍّ متحرِّكٌ بالإرادة وله شعورٌ، فنفيُ الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفيَ الحياة» [«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي (٢/ ٤٠٤-٤٠٥)].
(٤) وقول المصنِّف -رحمه الله-: «ونحوهما» أي: من أنواع الفعل اللازم القائم به كالمجيء والإتيان، والهبوط والدنو، والتدلِّي والقرب والتقرُّب، والغضب والرضى والفرح، وأنواع الفعل المتعدِّي كالخلق والرزق، والإماتة والإحياء، والقبض والبسط، ونحو ذلك من صفات الله الفعلية الاختيارية الثابتة بالنصوص الشرعية، فالواجب الإيمان بحقيقتها على ما يليق به سبحانه مع القطع بأنَّ الله ليس كمثله شيءٌ في جميع ما يصف به نفْسَه أو ما يصفه به رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
(٥) وقول المصنِّف -رحمه الله- «بلا كيفٍ» تقرير لمنهج السلف في إثبات صفة الاستواء والنزول ونحوهما من الصفات الفعلية الاختيارية لفظًا ومعنًى، واعتقادهم بأنَّ الله مستوٍ على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا كلَّ ليلةٍ استواءً أو نزولاً يليق بجلاله سبحانه، إلاَّ أنهم يكِلُون علْمَ كيفية ذلك الاستواء والنزول إلى الله تعالى الذي استأثر بعلمه، قال ابن القيِّم -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (٣/ ٣٥٩): «إنَّ العقل قد يئس من تعرُّف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف بلا كيفٍ أي: بلا كيفٍ يعقله البشر، فإنَّ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيَّته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك، كما أنَّا نعرف معانيَ ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخِر، ولا نعرف حقيقة كيفيَّته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزُنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم».
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 7426 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)