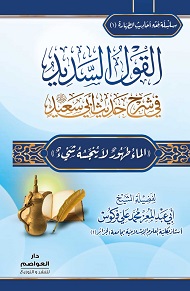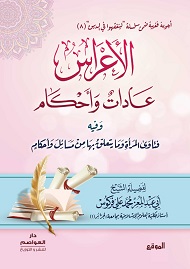من أسرار فاتحة الكتاب (١)
﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧].
وأمَّا المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالِّين فلوجوهٍ:
أحدها: أنهم متقدِّمون عليهم بالزمان.
الثاني: أنهم كانوا هم الذين يَلُون النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانَه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائيةً عنه، ولهذا تجد خطابَ اليهود والكلام معهم في القرآن الكريم أكثر من خطاب النصارى كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السور.
الثالث: أنَّ اليهود أغلظ كفرًا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخصَّ بهم واللعنة والعقوبة، فإنَّ كفرهم عن عنادٍ وبغيٍ كما تقدَّم، فالتحذير من سبيلهم والبعدُ منها أحقُّ وأهمُّ بالتقديم، وليس عقوبة مَن جَهِل كعقوبة مَن عَلِم.
الرابع: ـ وهو أحسنها ـ أنه تقدَّم ذكرُ المنعَم عليهم، والغضبُ ضدُّ الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء ومقابله، فذكرُ المغضوب عليهم مع المنعَم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالِّين، فقولك: الناس منعَمٌ عليه ومغضوبٌ عليه، فكن من المنعَم عليهم أحسن من قولك: منعمٌ عليه وضالٌّ.
وأمَّا المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالِّين باسم الفاعل فجوابهما ظاهرٌ، فإنَّ أهل الغضب من غَضِب الله عليهم وأصابهم غضبه فهُمْ مغضوبٌ عليهم، وأمَّا أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلُّوا وآثروا الضلالَ واكتسبوه، ولهذا استحقُّوا العقوبةَ عليه، ولا يليق أن يقال: «ولا المضَلِّين» مبنيًّا للمفعول لِمَا في رائحته من إقامة عُذرهم وأنهم لم يكتسبوا الضلالَ من أنفُسهم بل فُعل فيهم، ولا حجَّةَ في هذا للقدرية، فإنَّا نقول: إنهم هم الذين ضلُّوا وإن كان الله أضلَّهم، بل فيه ردٌّ على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلًا إلَّا على جهة المجاز لا الحقيقة، فتضمَّنتِ الآية الردَّ عليهم، كما تضمَّن قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الردَّ على القدرية، ففي الآية إبطالُ قول الطائفتين والشهادةُ لأهل الحقِّ أنهم هم المصيبون وهم المثبتون للقدر توحيدًا وخلقًا، والقدرةِ لإضافة أفعال العباد إليهم عملًا وكسبًا وهو متعلَّق الأمر والعمل، كما أنَّ الأول متعلَّق الخلق والقدرة، فاقتضت الآية إثباتَ الشرع والقدر والمعاد والنبوَّة، فإنَّ النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه، فالمنعَم عليهم رسلُه وأتباعُهم ليس إلَّا، وهُدى أتباعِهم إنما يكون على أيديهم، فاقتضى إثباتَ النبوَّة بأقرب طريقٍ وأبينِها وأدلِّها على عموم الحاجة وشدَّة الضرورة إليها، وأنه لا سبيلَ للعبد أن يكون من المنعَم عليهم إلَّا بهداية الله له، ولا تُنال هذه الهداية إلَّا على أيدي الرسل، وأنَّ هذه الهداية لها ثمرةٌ وهي النعمة التامَّة المطلقة في دار النعيم، ولخلافها ثمرةٌ وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي، فتأمَّلْ كيف اشتملتْ هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهمِّ مَطَالِبِ الدين وأجلِّها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو أعلم.
[«بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٢/ ٣٣)]
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 5178 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)