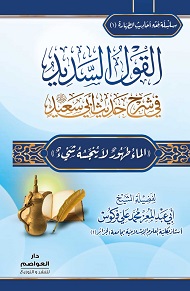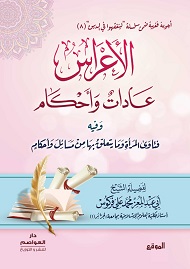فصل: الشبهة الثامنة
تفنيد دعوى «تنزيه ابنِ عربيٍّ الصوفيِّ مِنْ وحدة الوجود
واتِّهام السلفية بها»
قال شمس الدين بوروبي ـ هداه الله ـ: «السلفية يتَّهمون الصوفية وابنَ عربيٍّ بأنهم يعتقدون وحدةَ الوجود، ولكنَّهم في عقائدهم اعتقدوا أنَّ الله يحلُّ في السماء. الله عند السلفية موجودٌ في السماء، والسماءُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقه؛ فكيف يحلُّ الخالقُ في المخلوق، مَنِ الذي يعتقد ـ إذًا ـ وحدةَ الوجود؟ مَنِ الذي يعتقد أنَّ الله يحول في خَلْقه؟ الذي يعتقد أنَّ الله في السماء أم الذي ينزِّه الله عن المكان ويقول: ما كان لخالقِ المكان أَنْ يحدَّه مكانٌ»... ثمَّ برَّأ ابنَ عربيٍّ مِنْ وحدة الوجود بأبياتٍ قالها في ديوانه:
«الاتِّحَادُ مُحَالٌ لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا جَهُولٌ بِهِ عَنْ عَقْلِهِ شَرَدَا
وَعَنْ حَقِيقَتِهِ وَعَنْ شَرِيعَتِهِ فَاعْبُدْ إِلَهَكَ لَا تُشْرِكْ بِهِ أَحَدَا
الرجل يقول هذا بينما العقائد السلفية تعلِّم الناسَ أنَّ الله موجودٌ في السماء كوجود النجوم.. والقمر..» اﻫ.
الجواب:
ادَّعى المحاضر ـ جهلاً أو عنادًا ـ تبرئةَ المتصوِّفة مِنْ عقيدة وحدة الوجود الكفرية، وزاد الدعوى باطلًا حين ألصقها بالسلفية ـ زورًا وبهتانًا ـ ونَسَب إليهم فهمًا سقيمًا مِنْ إثبات صفة العلوِّ لله تعالى، ويمكن تناوُلُ الجواب عن الشبهة وبيانُ تهافُتِها مِنْ جهاتٍ:
الجهة الأولى: إثبات نسبة وحدة الوجود للصوفية.
عقيدة وحدة الوجود يُعنى بها في المعتقَدِ الصوفيِّ أنه لا وجودَ في الوجود إلَّا الله فليس غيره في الكون، وما هذه المظاهر في هذا الكونِ المُشاهَدِ إلَّا مَظاهِرُ لحقيقةٍ واحدةٍ هي الحقيقةُ الإلهية، أي: أَنْ يكون المخلوقُ مخلوقًا وخالقًا في آنٍ واحدٍ فلا انفصالَ بينهما، وأمَّا أنَّ غُلاةَ المتصوِّفة المتأثِّرين بالفكر اليونانيِّ والهندوسيِّ القديم يعتقدون هذه العقيدةَ فيدلُّ على ذلك جملةٌ مستفيضةٌ مِنْ نصوصٍ مبثوثةٍ بكُتُبِ أعلامهم كابن عربيٍّ وابن سبعين، والتلمسانيِّ وعبد الكريم الجيلي، وعبد الغني النابلسي، منها: قولُ ابنِ عربي: «فإنَّ الإله المُطْلَقَ لا يَسَعُه شيءٌ لأنه عينُ الأشياء وعينُ نفسه، والشيءُ لا يقال فيه: يَسَعُ نَفْسَه ولا يَسَعُها؛ فافهم»(١) أي: أنَّ الله تعالى هو عين الأشياء الموجودة في الكون، وكُلُّ ما في الكون مَظاهِرُ لله تعالى؛ فيُطْلَقُ عليه الله، وهذه ـ بعينها ـ عقيدةُ القول بوحدة الوجود، ومنها كلامٌ له يُنْكِرُ فيه موقفَ هارون عليه السلام ويصحِّح فيه موقفَ السامريِّ زاعمًا أنَّ موسى عليه السلام أيَّد السامريَّ في دعوته إلى عبادةِ غيرِ الله تعالى فقال: «وكان موسى عليه السلام أَعْلَمَ بالأمر مِنْ هارون؛ لأنه عَلِمَ ما عَبَده أصحابُ العجل، لعِلْمه بأنَّ الله قد قضى ألَّا نعبد إلَّا إيَّاه، وما حَكَم اللهُ بشيء إلَّا وَقَع، فكان عتبُ موسى أخاه هارون؛ لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتِّساعه؛ فإنَّ العارف مَنْ يرى الحقَّ في كُلِّ شيءٍ، بل يراه عينَ كُلِّ شيءٍ»(٢)، وله في «فصوص الحِكَم» طامَّاتٌ لا يَسَعُ المجالُ لذِكْرِها.
وقال ابنُ الفارض زاعمًا أنَّ الذات الإلهية هتكت عنه الحُجُب، فرأى حقيقةَ الله متعيِّنةً بذاتها في كُلِّ مظاهر الوجود:
جَلَتْ فِي تَجَلِّيهَا الوُجُودَ لِنَاظِرِي فَفِي كُلِّ مَرْئِيٍّ أَرَاهَا بِرُؤْيَةِ
فَفِي الصَّحْوِ بَعْدَ المَحْوِ لَمْ أَكُ غَيْرَهَا وَذَاتِي بِذَاتِي إِذْ تَحَلَّتْ تَجَلَّتِ
ويدَّعي أنَّ جميع الوجود يعبد بعضُه بعضًا فيقول:
وَكُلُّ الجِهَاتِ السِّتِّ نَحْوِي تَوَجَّهَتْ بِمَا تَمَّ مِنْ نُسْكٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةِ
لَهَا صَلَوَاتِي فِي المَقَامِ أُقِيمُهَا وَأَشْهَدُ فِيهَا أَنَّهَا لِيَ صَلَّتِ
كِلَانَا مُصَلِّ وَاحِدٌ سَاجِدٌ إِلَى حَقِيقَتِهِ بِالجَمْعِ فِي كُلِّ سَجْدَةِ
وَمَا كَانَ لِي صَلَّى سِوَايَ وَلَمْ تَكُنْ صَلَاتِي لِغَيْرِي فِي أَدَا كُلِّ سَجْدَةِ(٣).
هذا، وحريٌّ بالتنبيه أنَّ القول بوحدة الوجود يترتَّب عليه آثارٌ غايةٌ في الفساد ترجع على التوحيد بالهدم وعلى الدِّين بالإبطال، فينجرُّ على القول بوحدة الوجود ـ من جهةٍ ـ تجويزُ عبادةِ كُلِّ شيءٍ موجودٍ في هذا الكون؛ لأنه ـ انطلاقًا مِنْ عقيدتهم الباطلة ـ أنَّ كُلَّ ما في الكون يُعتبَرُ مجالِيَ ومَظاهِرَ لله تعالى، وأنَّ حَصْرَ العبادة في الله تعالى ـ عندهم ـ نقصٌ في التوحيد، وكمالُ التوحيد إنما يكون بعبادةِ كُلِّ شيءٍ ـ تعالى الله عمَّا يقولون عُلُوًّا كبيرًا ـ وقد تقدَّم أنَّ ابنَ عربيٍّ اعتبر موقفَ السامريِّ في صناعته العجلَ لأجلِ أَنْ يعبده بنو إسرائيلَ صحيحًا، وموقفَ هارون عليه السلام النبيِّ المُرْسَلِ مِنْ عند الله خطأً.
كما يترتَّب على القول بوحدة الوجود ـ مِنْ جهةٍ ثانية ـ أنَّ كُلَّ الذين يعبدون غيرَ الله تعالى مِنْ عَبَدةِ الأوثان والأصنام والحيوان وغيرِها مؤمنون حقًّا، وذلك انطلاقًا مِنْ معتقَدِهم الفاسد؛ لأنَّ كُلَّ ما في الكون يُعَدُّ مَظْهَرًا لله، وكُلُّ ما فيه جزءٌ مِنَ الألوهية؛ فإنَّ عبادة أيِّ شيءٍ ممَّا يُوجَدُ في هذا الكونِ فهو عبادةٌ لله تعالى، بمعنى: أنه ينتفي الشركُ والمشركون، ولا وجودَ إلَّا للتوحيد والموحِّدين.
وبناءً على أصلهم في القول بوحدة الوجود فإنه يترتَّب عليه ـ أيضًا مِنْ جهةٍ ثالثةٍ ـ القولُ بوحدة الأديان، سواءٌ كانوا مِنْ أهل الكتاب أو مِنْ غيرهم مِنْ مجوسٍ وبوذيةٍ وغيرهم؛ فهُمْ جميعًا بناءً على هذه العقيدة الإلحادية في أنَّ الله هو عينُ خَلْقه، وما الأشياءُ الموجودةُ في هذا الكون إلَّا مَظْهَرٌ مِنْ مظاهر الله تعالى، فالأديان جميعًا حقٌّ لا باطلَ فيها، وهي متساويةٌ في عبادة الله تعالى؛ فهذه العقيدةُ الإلحادية ساوَتْ بين التوحيد والشرك، والإيمانِ والكفر، وأنَّ الإسلام الذي هو دِينُ الهدى والقدسية هو ـ عندهم ـ عينُ الأديان الباطلة التي تدعو إلى الكفر والضلال والباطل.
تلك هي الآثارُ الفاسدة المترتِّبة على عقيدة وحدة الوجود الإلحادية ومضاعفاتها الخطيرة على الدِّين والمجتمع الإسلاميِّ، وقد بيَّن العلماءُ بطلانَ هذا المعتقَدِ حقَّ البيان، ووقفوا ضِدَّه بكُلِّ حزمٍ وعزمٍ، وألَّفوا في الردِّ عليه كُتُبًا ومؤلَّفاتٍ سيقَتْ فيها الأدلَّةُ القاطعة والبراهين الواضحة، ووصفوا معتنقيها ممَّنْ يعتقد بهذه العقيدةِ الإلحادية بأنهم ليسوا مِنَ الإسلام في شيءٍ، بل الإسلام بريءٌ منهم كُلَّ البراءة. قال ابنُ حجر ـ رحمه الله ـ: «وقد كنتُ سألتُ شيخَنا الإمام سراج الدِّين البلقينيَّ عن ابنِ عربيٍ فبادَرَ الجوابَ بأنه كافرٌ، فسألتُه عن ابنِ الفارض فقال: لا أحبُّ أَنْ أتكلَّم فيه، قلت: فما الفرق بينهما والموضعُ واحدٌ، وأنشدتُه مِنَ التائية، فقطع عليَّ بعد إنشاد عِدَّةِ أبياتٍ بقوله: هذا كفرٌ هذا كفرٌ»(٤).
الجهة الثانية: في بيان الفرق بين وحدة الوجود والاتِّحاد.
ساق المُحاضِرُ ـ عامَله اللهُ بعدله ـ أبياتًا تُنْسَبُ لابن عربيٍّ الصوفيِّ حَسِبها ـ لفرطِ جهلِه ـ تبرِّئه مِنْ عقيدة «وحدة الوجود»، فأظهرَ بذلك مدَى فَقرِه في العلم الشرعيِّ وجرأته على محاربة الحقِّ بالتمويهات، حيث خَلَط بين مصطلحَيِ «الاتِّحاد» و«وحدة الوجود»، وبنى على هذا الخلطِ إفكًا، فاستدل بنفي نسبة القول بالاتحاد لابن عربي على نفي عقيدة «وحدة الوجود» عنه، وكُلُّ مَنْ له معرفةٌ بمصطلحات القوم وعباراتهم يعلم علمًا لا مِرْيةَ فيه أنَّ ابنَ عربيٍّ في أبياته التي صدَّرها بقوله: «الاتِّحاد مُحالٌ لا يقول به *** إلاَّ جهولٌ به عن عقله شردَا» إنما نفى الاتِّحاد وهو ـ أي: عقيدة الاتِّحاد المنفيَّةُ عنده ـ: «تصيير الذاتين واحدةً، ولا يكون إلاَّ في العدد مِنَ الاثنين فصاعدًا»(٥)، والمنسوبُ إليه صراحةً هو «وحدة الوجود» التي يسمِّيها ـ زورًا ـ توحيدًا: وهي الزعم بأنَّ الله والوجود شيءٌ واحدٌ غير منقسمٍ، وأنَّ وجود هذا العالَمِ هو عينُ وجود الله، فليس عندهم ربٌّ وعبدٌ، ولا مالكٌ ومملوكٌ، ولا عابدٌ ولا معبودٌ؛ فابنُ عربيٍّ ومَنِ اتَّبعه ينفون لفظَ الاتِّحاد لأنه يعني أنَّ التعدُّدية هي الأصلُ في الوجود، وهم يقولون: إنَّ الوجود عينُ الله، وهذا الذي أنكره المحاضر ـ جهلاً أو مكابرةً ـ أفصح عنه ابنُ عربيٍّ قائلاً: «فإنَّ العارف مَنْ يَرى الحقَّ في كُلِّ شيءٍ، بل يراه كُلَّ شيءٍ»(٦)، والشرك الذي نفاه ابن عربي في قوله: «فَاعْبُدْ إِلَهَكَ لا تُشْرِكْ بِهِ أَحَدَا» ليس هو حقيقة الشرك الذي نهى الله عنه، وإنما يعني به خصوصًا: إثبات وجودين اتحدَ أحدُهما بالآخر، وهذا عنده باطل من جهة أنَّ كلَّ الوجود ـ عنده ـ واحدٌ ربًّا ومربوبًا، خالقًا ومخلوقًا، لا مِنْ جهة كون حقيقة الشرك جعل الند مع الله تعالى المنهي عنه بمثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢﴾ [البقرة] وهو شامل لعقيدة «الاتحاد» و«وحدة الوجود».
وفي معرض بيان حقيقةِ مذهب أهل وحدة الوجود، وسببِ تسميتهم اتِّحاديةً يقول ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «حقيقة قول هؤلاء: أنَّ وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودُها غيرَه، ولا شيءَ سواهُ ألبتَّةَ؛ ولهذا مَنْ سمَّاهم حلوليةً أو قال: «هم قائلون بالحلول» رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأنَّ مَنْ قال: إنَّ الله يحلُّ في المخلوقات فقَدْ قال بأنَّ المحلَّ غير الحالِّ، وهذا تثنيةٌ ـ عندهم ـ وإثباتٌ لوجودين: أحَدُهما: وجود الحقِّ الحالِّ. والثاني: وجود المخلوق المحلِّ، وهم لا يُقِرُّون بإثبات وجودين ألبتَّةَ... وأمَّا وجهُ تسميتهم اتِّحاديةً، ففيه طريقان: أحَدُهما: لا يرضَوْنه؛ لأنَّ الاتِّحاد على وزن الاقتران، والاقترانُ يقتضي شيئين، اتَّحد أحَدُهما بالآخَرِ، وهم لا يُقِرُّون بوجودين أبدًا، والطريق الثاني: صحَّة ذلك، بناءً على أنَّ الكثرة صارَتْ وحدةً»(٧).
وتسميته «وحدة الوجود» توحيدًا هو عينُ الباطل، فبَين التوحيد الذي بَعَث اللهُ به رُسُلَه وأنبياءَه، وأنزله في كُتُبه، والكفرِ الذي يسمِّيه أهلُ الباطل توحيدًا كما بين السماء والأرض، وكيف يكون القائل بأنَّ الوجود واحدٌ، ليس عنده وجودان: قديمٌ وحادثٌ، وخالقٌ ومخلوق موحِّدًا؟ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ مبيِّنًا مسلكَ أهل البِدَع في تمسُّكهم بالمتشابه مِنَ الكلام الذي له وجهان: «يخدعون به جُهَّالَ الناس كما يُنفِّقُ أهل الزَّغَلِ النقدَ المغشوش الذي له وجهان يخدعون به مَنْ لم يعرفه مِنَ الناس؛ فلا إله إلَّا الله! كم قد ضلَّ بذلك طوائفُ مِنْ بني آدَمَ لا يحصيهم إلَّا اللهُ! واعتبِرْ ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنَّة وهو التوحيد الذي حقيقتُه إثباتُ صفاتِ الكمال لله وتنزيهُه عن أضدادها وعبادتُه وَحْدَه لا شريكَ له؛ فاصطلح أهل الباطل على وضعِه للتعطيل المحض، ثمَّ دعَوُا الناسَ إلى التوحيد فخدعوا به مَنْ لم يعرف معناه في اصطلاحهم وظنَّ أنَّ ذلك التوحيدَ هو الذي دعَتْ إليه الرُّسُلُ، والتوحيد اسمٌ لستَّةِ مَعانٍ: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتِّحادية، فهذه الأربعة أنواع مِنَ التوحيد جاءَتِ الرُّسُلُ بإبطالها، ودلَّ على بطلانها العقلُ والنقلُ» إلى أَنْ قال: «التوحيد الرابع: توحيد القائلين بوحدة الوجود وأنَّ الوجود عندهم واحدٌ، ليس عندهم وجودان: قديمٌ وحادثٌ، وخالقٌ ومخلوقٌ، وواجبٌ وممكنٌ، بل الوجود عندهم واحدٌ بالعين، والذي يقال له: الخلق المشبه هو الحقُّ المنزَّه، والكُلُّ مِنْ عينٍ واحدةٍ، بل هو العين الواحدة. فهذه الأنواع الأربعة سمَّاها أهل الباطل: توحيدًا، فاعتصموا بالاسم مِنْ إنكار المسلمين عليهم وقالوا: نحن الموحِّدون، ودعَوُا الناسَ إلى الباطل باسم التوحيد فجعلوه جُنَّةً وترسًا ووقايةً، وسمَّوُا التوحيدَ الذي بَعَث اللهُ به رُسُلَه وأنبياءه: تركيبًا وتجسيمًا وتشبيهًا، وجعلوا هذه الألقابَ له سهامًا وسلاحًا يقاتلون بها أهلَه؛ فتترَّسوا بما عند أهل الحقِّ مِنَ الأسماء الصحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سمَّوْا بها ما بعث اللهُ به رسوله»(٨).
الجهة الثالثة: إثبات العلوِّ لله تعالى.
لا زالَتِ الأمَّةُ منذ الرعيل الأوَّل مُطْبِقةً على أنَّ الله سبحانه على عرشه مستوٍ، وأوَّلُ مَنْ عُرِف عنه في هذه الأمَّةِ إنكارُ أَنْ يكون الله فوق سماواته على عرشه هو «جهم بنُ صفوان» وقبله «الجعد بنُ درهم»، ولكنَّ الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقرَّرها وعنه أُخِذَتْ. وشبهتهم: فهمٌ سقيمٌ لظواهر الآيات، والأدلَّةُ على بطلان قول الجهمية متضافرةٌ؛ فكتاب الله مِنْ أوَّله إلى آخِرِه، وسنَّةُ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وعامَّةُ كلام الصحابة والتابعين وسائرِ الأئمَّةِ مملوءٌ بما هو نصٌّ أو ظاهرٌ في أنَّ الله سبحانه وتعالى فوق كُلِّ شيءٍ بدلالاتٍ متنوِّعةٍ منها: التصريح بأنه سبحانه في السماء بذاته(٩) كقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ١٧﴾ [المُلْك]. وفي الصحيحين مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: «بَعَث عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى النبيِّ بذهيبة في أديمٍ مقروضٍ لم تحصل مِنْ ترابها». قال: «فقسمها بين أربعةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاثَةَ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ»، قال رجلٌ مِنْ أصحابه: «كنَّا نحن أحقَّ بهذا مِنْ هؤلاء»، قال: فبَلَغ ذلك النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً»(١٠)، وعن عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»(١١)، وصحَّ عن أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه في موت النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قولُه: «وَمَنْ كَانَ يَعبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، حَيٌّ لَا يَمُوتُ»(١٢)، وبنو آدم كُلُّهم مفطورون على الإقرار بعلوِّ الله الذاتي فعن زَيد بنِ أسلمَ، قال: مرَّ ابنُ عُمر رضي الله عنهما برَاعي غنَمٍ فقال: «يا راعِي الغنَمِ هل مِنْ جَزْرَةٍ؟» قالَ الرَّاعِي: «ليسَ هَاهنَا ربُّها»(١٣)، فقال ابنُ عُمرَ: «تَقولُ: أكلَهَا الذِّئبُ»، فرفعَ الرَّاعِي رَأسهُ إلى السَّماءِ، ثُمَّ قال: «فأيْنَ اللهُ؟» فَاشْتَرَى ابنُ عُمرَ الرَّاعِيَ واشْترى الغنَمَ، فأعْتقهُ وأعْطاهُ الغنَمَ(١٤).
الجهة الرابعة: في بيان المراد بكون الله في السماء:
قد افترى المحاضر فريةً عظيمةً حين نَسَب إلى المُثْبِتين للعلوِّ أنهم يحصرون ربَّهم في جرم السماء، وإنما أُتِيَ مِنْ قِبَلِ قلَّةِ معرفته بلغة العرب التي نزل بها كتابُ ربِّ العالمين؛ فإنَّ قوله تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ إذا أُجْرِيَتْ «في» على أصلها ـ وهو الظرفية ـ فتفسَّرُ السماءُ بمعنى العلوِّ المطلق، قَالَ الزَّجَّاجُ: «السَّمَاءُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ يُقَالُ لِكُلِّ مَا ارتَفع وعَلا: قَدْ سَما يَسْمُو»(١٥). وإِنْ أُرِيدَ بالسماء المخلوقة فتُحْمَل «في» بمعنى «على»، ويكون المعنى: «مَنْ على السماء»، لا بمعنَى أنَّ السَّماء تحويه وتحيط به ـ كما ادَّعى المحاضرُ افتراءً ـ فالله ـ سبحانه ـ لا يحيط به أيُّ شيءٍ. وعلى هذا التفسيرِ نصوصُ علماء أهل السنَّة والجماعة، قال ابنُ عبد البرِّ المالكي ـ رحمه الله ـ: «وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ﴾ فَمَعْنَاهُ: مَنْ عَلَى السَّمَاءِ، يَعْنِي: عَلَى الْعَرْشِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بِمَعْنَى عَلَى، أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ﴾ [التوبة: ٢] أي: على الأرض، وكذلك قوله: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ﴾ [طه: ٧١] وَهَذَا كُلُّهُ يُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: ٤] وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِمَّا تَلَوْنَا مِنَ الْآيَاتِ فِي هَذَا الباب»(١٦).
وقال أَبو بَكرٍ مُحمَّدُ بنُ مَوهَبٍ المالكيُّ شارح «رِسالةِ ابنِ أَبي زَيدٍ» ـ رحمة الله عليهمَا ـ: «وَقَدْ تَأْتِي (فِي) فِي لُغَةِ العَربِ بمعنى فوقَ؛ وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [المُلْك: ١٥] يريد: فوقها وعليها، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ﴾ [طه: ٧١] يريد: عليها، وقال تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ﴾ [المُلْك: ١٦] الآيات، قال أهلُ التَّأويلِ العالِمُون بلُغةِ العربِ: يريدُ: فوْقهَا، وهُو قوْلُ مالِكٍ مِمَّا فهم عن جماعةٍ ممَّن أدركَ مِنَ التَّابعينَ ممَّا فهموهُ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم ممَّا فهمُوهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ اللهَ في السَّماء بمَعنَى: فوقهَا وعليْهَا»(١٧).
وقد ناقش شيخ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ شبهةَ مَنْ يقول بأنَّ السَّماء تحويه، وبيَّن زيفَها، فقال: «من توهَّم أنَّ كون الله في السَّماء بمعنى أنَّ السَّماء تحيط به وتحويه فهو كاذبٌ ـ إِنْ نَقَله عن غيره ـ ضالٌّ ـ إِنِ اعتقده في ربِّه ـ وما سمعنا أحَدًا يفهم هذا مِنَ اللّفظ، ولا رأينا أحدًا نقله عن واحدٍ، ولو سُئِل سائرُ المسلمين: هل يفهمون مِنْ قول الله ورسوله: «إنَّ الله في السَّماء»: أنَّ السَّماء تحويه؟ لَبادَرَ كُلُّ أحَدٍ منهم إلى أَنْ يقول: هذا شيءٌ لعلَّه لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمرُ هكذا، فمِنَ التكلُّف أَنْ يُجْعَل ظاهرُ اللفظ شيئًا محالًا لا يفهمه النَّاسُ منه، ثمَّ يريد أَنْ يتأوَّله، بل عند النَّاس «أن الله في السَّماء»، و«هو على العرش» واحدٌ؛ إذ السَّماء إنّما يراد به العلوُّ، فالمعنى: أنَّ الله تعالى في العلوِّ، لا في السفل، وقد علم المسلمون أنَّ كرسيَّه ـ سبحانه وتعالى ـ وَسِع السمواتِ والأرض، وأنَّ الكرسيَّ في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضِ فَلَاةٍ، وأنَّ العرش خَلْقٌ مِنْ مخلوقات الله لا نسبةَ له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يُتوهَّمُ بعد هذا أنَّ خَلْقًا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ وَلَتَعۡلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابٗا وَأَبۡقَىٰ ٧١﴾ [طه]، وقال: ﴿فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [آل عمران: ١٣٧؛ النحل: ٣٦] بمعنى «على»، ونحو ذلك، وهو كلامٌ عربيٌّ حقيقةً لا مجازًا، وهذا يعلمه مَنْ عَرَف حقائقَ معاني الحروف، وأنها متواطئةٌ في الغالب لا مشتركةٌ»(١٨).
وقال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «التصريح بأنه سبحانه في السماء، وهذا عند أهل السنَّة على أحَدِ وجهين: إمَّا أَنْ تكون «في» بمعنى «على»، وإمَّا أَنْ يراد بالسماء العلوُّ، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز حملُ النصِّ على غيره»(١٩).
وقد تمسَّك أهلُ السنَّة بنصوص الكتاب والسنَّة في إثبات العلوِّ لله تعالى، ويَلْزَمُ المحاضرَ ـ هداه الله ـ أَنْ يَستصحِبَ اتِّهامَه للسلفيِّين فيُنْزِله على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنه بلَّغ أمَّتَه الكفرَ في الأحاديث التي سَلَف بعضُها، ويَلْزَمه أَنْ يحكم على السلف ومنهم الصحابة بما اتَّهم به أتباعَهم، وأنهم أقرُّوا الكفرَ ولم يُنْكِروه، هذا مِنْ جهةٍ، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الذين ينفون عُلُوَّ اللهِ على خَلْقه هم الذين يحصرون ربَّهم ويحدُّونه في مخلوقاته حين يدَّعون أنه في كُلِّ مكانٍ، وهي مَزاعِمُ الجهميةِ وامتداد أباطيلهم لأهل الصوفية الفلسفية مِنَ القائلين بوحدة الوجود والاتِّحادية والحلولية.
وختامًا لهذه الشبهة فإنه يجدر التنبيهُ إلى وقوع المحاضر في التناقض، وبيانُه: أنَّ إنكاره أَنْ يكون الله في السماء ـ وهي عقيدة الجهمية ـ ينقض قولَه السالفَ ممَّا زعَمه مِنْ تأويلِ نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بنزول أمره ناسبًا ذلك ـ تدليسًا ـ إلى الإمام مالكٍ ـ رحمه الله ـ فيقال: إذا كنتَ لا تؤمن بأنَّ الله في العلوِّ فكيف تزعم أنَّ الأمر ينزل؟ فإنَّ النزول لا يكون في اللغة إلاَّ مِنْ علوٍّ(٢٠).
وهكذا حالُ كُلِّ مَنْ لم يرضَ بالسلف اعتقادًا ومنهجًا واتَّخذ الأهواءَ وبِدَعَ الكلام له سبيلاً، يضرب بعضُ كلامِه بعضًا، وينقض آخرُه أوَّلَه، لا يستقيم لهم منهجٌ ولا يطَّرِدُ لهم أصلٌ ولا تنضبط بهم قاعدةٌ.
والعلم عند الله تعالى، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
(١) «فصوص الحِكَم» لابن عربي (١/ ١٧٥).
(٢) المصدر السابق (١/ ١٩٢).
(٣) انظر: «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل (٢٥).
(٤) «لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣١٨).
(٥) «التعريفات» للجرجاني (٨).
(٦) «فصوص الحِكَم» لابن عربي (١/ ١٤١).
(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢/ ١٤٠ ـ ١٤١).
(٨) «الصواعق المرسلة» لابن القيِّم (٣/ ٩٣٢).
(٩) قال ابن القيِّم ~: «إنَّ الجهمية لمَّا قالوا: إنَّ الاستواء مجازٌ، صرَّح أهل السنَّة بأنه مستوٍ بذاته على عرشه، وأكثرُ مَنْ صرَّح بذلك أئمَّةُ المالكية» [«مختصر الصواعق المرسلة» للبعلي (٣٥٧)].
(١٠) أخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).
(١١) أخرجه أبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني (٩٢٥)، والجزرة: شاةٌ تصلح للذبح.
(١٢) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٢٠١).
(١٣) أي: مالكها.
(١٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٠٥٤). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٤٧٠).
(١٥) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١٤/ ٣٩٨).
(١٦) «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٧/ ١٣١).
(١٧) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيِّم (٢/ ١٨٨).
(١٨) «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٠٦).
(١٩) «إعلام الموقِّعين» (٢/ ٢١٥).
(٢٠) انظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية (٣٥)، و«الصفات الإلهية» لمحمَّد أمان الجامي (٣١٣).
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 1757 مرة
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)