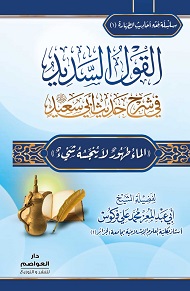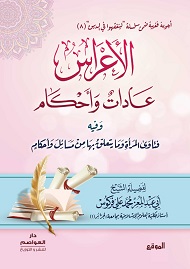تنبيهٌ أوَّل(١)
مَا ذُكِرَ مِنَ القَوَاعِدِ يُطَبَّقُ عَلَى خُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَبْقَى مِنَ السُّنَّةِ فِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرُهُ.
قواعدُ في أفعاله صلَّى الله عليه وسلَّم
كُلُّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ فِي العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ فَهُوَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِلْأُمَّةِ(٢)، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ(٣)(٤).
وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الوُجُوبِ وَالاِسْتِحْبَابِ، وَيَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِالدَّلِيلِ(٥).
وَكُلُّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرْجَحُ مِمَّا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا(٦).
وَكُلُّ مَا تَرَكَهُ مِنْ صُوَرِ(٧) العِبَادَاتِ(٨) فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ(٩).
وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ لِلْخِلْقَةِ(١٠) البَشَرِيَّةِ(١١) فَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَحَلًّا لِلتَّأَسِّي، وَلَكِنَّ هَيْئَتَهُ الَّتِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهَا هِيَ أَفْضَلُ هَيْئَةٍ، وَهِيَ مَحَلُّ الأُسْوَةِ(١٢).
قواعدُ في تقريره صلَّى الله عليه وسلَّم(١٣)
كُلُّ مَا قِيلَ(١٤) أَوْ فُعِلَ(١٥) بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بَلَغَهُ وَأَقَرَّهُ فَهُوَ حَقٌّ عَلَى(١٦) مَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ(١٧).
وَكُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ فِي زَمَانِهِ وَكَانَ مُشْتَهِرًا شُهْرَةً(١٨) يَبْعُدُ أَنْ تَخْفَى عَلَيْهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ(١٩).
تنبيهٌ ثانٍ
تَخْتَصُّ السُّنَّةُ عَنِ الكِتَابِ بِقَوَاعِدَ تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نَاحِيَةِ ثُبُوتِهَا(٢٠)؛ لِأَنَّهَا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ لَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ(٢١)، بِخِلَافِ القُرْآنِ فَكُلُّهُ مُتَوَاتِرٌ(٢٢).
فَكُلُّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ(٢٣) أَوْ حَسَنٍ(٢٤) فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلاِسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الأَحْكَامِ(٢٥).
وَكُلُّ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ(٢٦)(٢٧).
وَكُلُّ مَا ثَبَتَ طَلَبُ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ بِدَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مَا جَاءَ لِلتَّرْغِيبِ فِيهِ أَوْ لِلتَّرْهِيبِ مِنْهُ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ(٢٨).
(١) «أوَّل» ساقطٌ مِنْ: «أ».
(٢) فأفعالُه صلَّى الله عليه وسلَّم التي يُقْصَدُ بها التعبُّدُ والقُرْبةُ فإنَّا مُتعبَّدون فيها بالتأسِّي به صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لإجماعِ الصحابة رضي الله عنهم على الرجوع إلى أفعاله والتأسِّي به، ولقوله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وهذه الآيةُ أصلٌ عظيمٌ في التأسِّي بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد جعَلَتِ الآيةُ التأسِّيَ به مِنْ لوازمِ رجاءِ الله واليومِ الآخِرِ، ولقوله تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ٣١]، والآيةُ صرَّحَتْ أنَّ مِنْ لوازمِ مَحبَّةِ الله تعالى الواجبةِ: مُتابَعةَ رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم. ومِنْ ذلك: قولُه تعالى: ﴿فََٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الأعراف]؛ فجَعَلَ الله عزَّ وجلَّ الهدايةَ في اتِّباعه.
هذا، وحقيقٌ بالتنبيه: أنَّ التأسِّيَ يَلْزَمُه المُتابَعةُ في صورةِ العمل والمُتابَعةُ في القصد؛ لأنَّ المُرادَ بالتأسِّي هو الاقتداءُ به ومُتابَعتُه في فِعْلِه على الوجه الذي فَعَلَ: فإِنْ قَصَدَ به العبادةَ أو قَصَدَ تخصيصَ مكانٍ أو زمانٍ بالعبادة؛ شُرِع لنا أَنْ نفعله على وجهِ العبادة والتخصيص: كالطواف بالكعبة، واسْتِلام الحَجَرِ، والصلاةِ خَلْفَ المَقام. أمَّا إذا لم يقصده صلَّى الله عليه وسلَّم بالعبادة: كنزوله بمكانٍ يُصلِّي فيه اتِّفاقًا لا قصدًا فلا يكون تخصيصُ ذلك المكانِ بالصلاة تأسِّيًا؛ لعدَمِ تقصُّدِه بالعبادة ابتداءً، وإنما وقَعَتْ بحكمِ الاتِّفاق.
(٣) «ب»: «على الخصوصية».
(٤) أي: أنَّ كُلَّ فعلٍ تشريعيٍّ فَعَلَهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فالأصلُ فيه عدَمُ خصوصيَّته به؛ ذلك لأنَّ المعلوم ـ استقراءً ـ مِنَ القرآن أنَّ الله يُخاطِبُ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بخطابٍ خاصٍّ والمقصودُ منه العمومُ في الحكم، نحو قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [الطلاق: ١]، وبيَّن فيه عمومَ المُكلَّفين، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٢﴾ [الأحزاب: ١ ـ ٢]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ﴾ إلى أَنْ قال: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التحريم: ١ ـ ٢]، وقال: ﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ﴾ ثمَّ قال: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ﴾ [الروم: ٣٠ ـ ٣١]، وما وَرَدَ بعد الخطابِ الخاصِّ مِنَ التعميم في الآيات يُسْتَدَلُّ به على شموله لأُمَّتِه، إلَّا إذا دلَّ الدليلُ على الاختصاص به، فإنه لا يُعَدُّ ـ حالتئذٍ ـ تشريعًا لغيره ويَحْرُم فيه التأسِّي به: كالزيادة في النكاح على أربعِ نسوةٍ، وزواجِه بدونِ مهرٍ، ودخولِه مكَّةَ بغيرِ إحرامٍ، واختصاصِه بوجوبِ الضُّحى والوترِ والتهجُّد بالليل، وإباحةِ الوِصال له والصفيِّ مِنَ الغنيمة، وغيرِ ذلك مِنْ خصائصه.
(٥) في هذه المسألةِ تفصيلٌ يظهر وجهُه كالتالي: إِنْ كان فِعْلُه صلَّى الله عليه وسلَّم لبيانِ مُجْمَلٍ أو لتقييدِ مُطلَقٍ؛ فإنَّ هذا النصَّ التشريعيَّ يأخذ حُكْمَ النصِّ المبيَّن؛ فإِنْ كان المبيَّنُ واجبًا فهو واجبٌ، وإِنْ كان مندوبًا فهو مندوبٌ؛ فحكمُ فِعْلِه تابعٌ لِما بَيَّنه؛ ذلك لأنَّ البيان لا يتعدَّى رتبةَ المبيَّن؛ فهو كالتفسير ينطبق مع المفسَّر.
فإِنْ لم يكن بيانًا لمُجْمَلٍ أو تقييدًا لمُطْلَقٍ: فإمَّا أَنْ يُعْلَمَ فِعْلُه بدليلٍ يُرجِّحُ الوجوبَ أو الندبَ وإمَّا أَنْ لا يُعْلَمَ: فإِنْ عُلِمَ فإنه يُحْمَلُ على ما يُرجِّحُه الدليلُ، وإِنْ لم يُعْلَمْ فِعْلُه بدليلٍ فإنَّ ما عليه أهلُ التحقيق أنه: إِنْ قَصَدَ بذلك قُرْبةً فهو مندوبٌ؛ لأنَّ قَصْدَ ظهورِ القُرْبةِ فيه يُوضِّحُ رجحانَ فِعْلِه على تَرْكِه، والزيادةُ مُنْتَفِيَةٌ بالأصل، وذلك هو معنى الندب، فإِنْ لم يظهر منه قَصْدُ القُرْبَةِ ففعلُه صلَّى الله عليه وسلَّم محمولٌ على الإباحة؛ لأنَّ صدوره منه دليلٌ على الإذن فيه، والزيادةُ على ذلك مُنْتَفِيَةٌ بالأصل، وذلك معنى الإباحة، [انظر: «المفتاح» للتلمساني (٦٢٤ ـ ٦٢٥)].
(٦) ما واظَبَ على فِعْلِه صلَّى الله عليه وسلَّم يُسَمَّى بالسنَّة المؤكَّدةِ أو سنَّةِ الهدى، أمَّا ما فَعَلَهُ أحيانًا فيُطْلَقُ عليه بالسنَّة المُسْتَحَبَّةِ أو النافلة؛ والذي واظَبَ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم إمَّا أَنْ يكون غيرَ مُعارِضٍ للفعل الثابتِ عنه مرَّةً أو نحوَها أو مُعارِضًا: ففي حالةِ عدَمِ التعارض فتظهر رجحانيةُ فِعْلِه المُواظَبِ عليه مِنْ بابِ إرادةِ إدامةِ فِعْلِه؛ ذلك لأنَّ الفعل لا عمومَ له، ولا يدلُّ على دوام الحكم إِنْ فَعَلَه مرَّةً أو مَرَّاتٍ، وتحصلُ معرفةُ إدامته في المُسْتَقْبَلِ بمُواظَبَتِه على الفعل أو تأكيدِه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لذلك كانَتِ السنَّةُ المؤكَّدةُ أقوى مِنَ السنَّة المُسْتَحَبَّة.
أمَّا في حالةِ التعارض الحاصل بين الفعلين؛ فإنَّ أَقْرَبَ الأقوالِ إلى الحقِّ أنه إِنْ لم تَقَعِ الأفعالُ بياناتٍ للأقوال فلا يحصل التعارُضُ؛ لانعدامِ الصِّيَغِ والألفاظ التي يمكن النظرُ فيها والحكمُ عليها، وقد تَتعارَضُ في الصورةِ إِنْ وَقَعَتِ الأفعالُ بياناتٍ للأقوال، ولكنَّ الحقيقة أنَّ التعارض حاصلٌ بين المبيَّناتِ مِنَ الأقوال، لا بين بياناتها مِنَ الأفعال.
(٧) «ب»: «ممَّا يُحْسَبُ مِنَ العبادات».
(٨) تَرْكُه صلَّى الله عليه وسلَّم لفعلِ عبادةٍ مِنَ العبادات: إمَّا أَنْ يَرِدَ عن طريقِ تصريحِ الصحابيِّ بالترك، كقوله: «صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» [أخرجه أبو داود (٤/ ٥) رقم: (١١٤٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وأصلُه في الصحيحين]، أو عن طريقِ عدَمِ نَقْلِ فِعْلِه مع تَوافُرِ الهِمَمِ والدواعي على نَقْلِه: كتركِ التلفُّظ بالنيَّة عند الصلاة، فإنَّ فِعْلَه يُعَدُّ حُجَّةً ويجب التأسِّي به في الترك؛ لأنَّ «الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ».
(٩) ما قرَّرَهُ المُصنِّفُ ـ مِنْ أنَّ كُلَّ ما تَرَكَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صُوَرِ العبادات فليس بقُرْبةٍ ـ يحتاج إلى التفصيل التالي: ما تَرَكه صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صُوَرِ العبادات: إمَّا أَنْ يكون لعدَمِ وجودِ المقتضي له أو مع وجودِه: فإِنْ وُجِدَ المقتضي لِفِعْلِه وتَرَكَه: فإمَّا أَنْ يكون تَرَكَه بسببِ قيامِ مانعٍ أو لا؟ وعليه، فالذي يتركه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ العبادات مع وجود المقتضي لِفِعْلِه لكِنْ حالَ دون فِعْلِه قيامُ مانعٍ، فهذا التركُ لا يُتقرَّبُ به؛ لأنه عملٌ بغيرِ مقتضَى سنَّته، أمَّا إذا زالَ المانعُ فيصحُّ فِعْلُ ما تَرَكَه لكونه سنَّةً يَصِحُّ التأسِّي به فيه: كتَرْكِه صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فيما بعدُ ـ قيامَ رمضان جماعةً بسببِ خشيتِه أَنْ يُكْتَبَ على أمَّتِه، فبعد زوالِ المانعِ بموته صلَّى الله عليه وسلَّم أَصْبَحَ فِعْلُ ما تَرَكَه مشروعًا مُوافِقًا لسُنَّته؛ لذلك فَعَله عمر بنُ الخطَّاب رضي الله عنه، حيث جَمَعَ الناسَ على إمامٍ واحدٍ في صلاة التراويح.
أمَّا الذي يترك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِعْلَه لعدَمِ وجودِ المقتضي له فتركُه لا يُعَدُّ سنَّةً: فإِنْ وُجِدَ المقتضي له كان فِعْلُه مشروعًا لكونه عملًا بمقتضى سنَّتِه: كقتالِ مانِعِي الزكاة؛ فلم يكن مُقْتَضيهِ موجودًا في زمَنِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وقام مُقْتضيهِ في خلافةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ فكان قتالُه لهم مشروعًا غيرَ مُخالِفٍ لسُنَّته.
أمَّا ما تَرَكه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صُوَرِ العبادات مع وجود المقتضي لِفِعْلِها وانتفاءِ الموانع؛ فحالتئذٍ يكون تركُه سنَّةً: مثل تَرْكِه صلَّى الله عليه وسلَّم الأذانَ لصلاة العيدين.
وبهذا التفصيلِ يظهر أنَّ ما قرَّرَهُ المُصنِّفُ مِنْ أنَّ: «ما تَرَكه صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ صُوَرِ العبادات فليس بقُرْبةٍ» ليس على إطلاقه، بل يُشْرَعُ التأسِّي به في الترك في حالةِ وجود المقتضي وانتفاءِ المانع، أمَّا عند انتفاءِ المقتضي أو وجودِ المانع ففِعْلُه أَنْسَبُ لسُنَّتِه، فإِنْ كان مقصودُ المُصنِّفِ هو التقرُّبَ بفعلٍ تَرَكه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ أمور العبادات مع وجود المقتضي له وانتفاءِ الموانع فكلامُه صحيحٌ، بل هو معصيةٌ وبدعةٌ؛ لِما فيه مِنِ اتِّهامِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخيانةِ الرسالة كما قال الإمامُ مالكٌ، ولا شكَّ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد امتثل لأمرِ ربِّه بالقيام بواجب التبليغ في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾ [المائدة: ٦٧]، فقام به حقَّ القيام، وأَتَمَّهُ أَتَمَّ البيانِ، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ» [أخرجه ابنُ ماجه (١/ ٤) رقم: (٥) مِنْ حديثِ أبي الدرداء رضي الله عنه]، وقد شَهِدَتْ له أُمَّتُه على ذلك في خُطْبَتِه يومَ حَجَّةِ الوداع؛ فأَتَمَّ اللهُ هذا الدِّين وأَكْمَلَهُ فلا ينقصه أبدًا، ورَضِيَه فلا يسخطه أبدًا، قال تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]؛ فكمالُ هذا الدِّين وتمامُه قاضٍ بالاستغناء التامِّ عن زيادات المُبْتَدِعين واستدراكات المُسْتَدْرِكين.
(١٠) «أ»: «للخلق».
(١١) أي: الأفعال الصادرة عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية مِمَّا فَطَرَ اللهُ عليها البشرَ، وتشتركُ فيها نفوسُ الخَلْق، ولا يملك الإنسانُ فيه حُرِّيَّةَ التصرُّف: كالقيام والقعود والنوم وحركةِ اليد أثناءَ المشي وهواجسِ النفسِ ونحوِها، ويُطْلَقُ عليها الأفعالُ الجِبِلِّيَّة.
(١٢) الأفعال الجِبِلِّيةُ أو الخَلْقية التي لم يُقْصَدْ بها التشريعُ أو القُرْبةُ لا يكون النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أسوةً فيها، ولا يُتَّبَعُ في شيءٍ منها، وهي معدودةٌ مِنَ القسم المُباح، غيرَ أنه لو تُؤُسِّيَ به فيها لَأُثيبَ عليها، وإِنْ تَرَكها لا رغبةً عنها ولا استكبارًا فلا بأسَ بذلك، فإِنْ قامَ الدليلُ على أنَّ المقصود مِنْ فِعْلِه الاقتداءُ كان تشريعًا بذلك الدليلِ وليس بمُجرَّدِ صدورِه منه: كالأكل باليد اليمنى أو مِمَّا يلي الآكِلَ مِنْ حديثِ عمر بنِ أبي سَلَمَة رضي الله عنهما [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ (٩/ ٥٢١) رقم: (٥٣٧٦)، ومسلمٌ (١٣/ ١٩٢) رقم: (٢٠٢٢)].
أمَّا ما كان صادرًا بمقتضى الخبرةِ البشرية المُسْتفادَةِ مِنَ التجارب الخاصَّة في الحياة: كالزراعة والتجارة ووَصْفِ الدواء؛ فلا تُعَدُّ تشريعًا ولا حُجَّةً، ويدلُّ عليه ما أخرجه مسلمٌ (١٥/ ١١٧) رقم: (٢٣٦٣) مِنْ حديثِ أنسٍ وعائشةَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ»، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟»، قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، والشِّيصُ كما بيَّنَهُ النوويُّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح مسلم» (١٥/ ١١٨)]: «وهو البُسْرُ الرديءُ الذي إذا يَبِسَ صارَ حشفًا، وقيل: أردأُ البُسْر، وقِيلَ: تمرٌ رديءٌ، وهو مُتقارِبٌ».
(١٣) إقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم أو تقريرُه حُجَّةٌ، وهو قسمٌ مِنْ أقسام السُّنَّة، ويدلُّ سكوتُه على جوازِ الفعل أو القول، وهو مذهبُ جمهورِ العلماء؛ إذ لا يُقِرُّ على خطإٍ ولا معصيةٍ، ولا يجوز في حَقِّه تأخيرُ البيانِ عن وقت الحاجة؛ ذلك لأنَّ إقراره على الفعل إِنْ تَضَمَّنَ معصيةً فمعصيةٌ؛ فالعاصمُ له مِنْ فِعْلِ المعصيةِ عاصمٌ له مِنَ الإقرار عليها، ولقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ﴾ [المائدة: ٦٧]؛ إذ وجوبُ إنكارِ المُنْكَرِ لا يَسْقُطُ عنه بالخوف على نَفْسِه، وقد كان الصحابةُ يحتجُّون بتقريره على الجوازِ مِنْ غيرِ نكيرٍ؛ فكان إجماعًا منهم على حُجِّيَّتِه.
(١٤) الإقرار على الأقوال يمكن أَنْ يُفَصَّلَ على الوجه التالي وهو أنَّ الأقوال:
ـ إمَّا أَنْ تتعلَّق بأمور الدِّين: فإقرارُه يدلُّ على صِحَّتِها، كاعترافِ مَاعِزٍ بالزِّنَا أمامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثًا، فقال له أبو بكرٍ: «إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ ـ أي: رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ»، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدلَّ على إصابته في الحكم، وكقول العَجْلانيِّ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، اللَّهُمَّ احْكُمْ»، قَالَ ـ أي: ابْنُ مَسْعُودٍ ـ: «فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ» [أخرجه أحمد ـ واللفظ له ـ (١/ ٤٢١) رقم: (٤٠٠١) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وأخرجه ـ بنحوه ـ البخاريُّ (٥٢٥٩)، ومسلمٌ (١٠/ ١٢٧) رقم: (١٤٩٢)، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما]؛ فسَكَتَ عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فدلَّ على صحَّةِ كلامِه وإصابتِه للحقِّ.
ـ وإمَّا أَنْ يكون إقرارُه على أقوالٍ مُتعلِّقةٍ بالدنيا والأمورِ المُغيَّبة: فإقرارُه لا يدلُّ على ثبوت المدلول وصِدْقِ خبرِه، مثل طعنِ المُنافِقين في نَسَبِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما بسببِ التَّخالُفِ بينه وبين أبيه في اللون؛ فسكوتُه لا يدلُّ على صدقِ الخبر، ويدلُّ عليه أنَّ القائفَ لَمَّا رأى أقدامَ زيدٍ وأسامةَ وقد غطَّيَا رؤوسَهما، قال: «إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ رضي الله عنها [أخرجه البخاريُّ (٧/ ٨٧) رقم: (٣٧٣١)، ومسلمٌ (١٠/ ٤٠) رقم: (١٤٥٩)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها]. وهذا الحديث يُسْتَدَلُّ به مِنْ إقراره صلَّى الله عليه وسلَّم على أنَّ القِيافةَ طريقٌ مِنْ طُرُقِ ثُبوتِ النسب، وبه قال الجمهور.
(١٥) الإقرار على الفعل إِنْ لم يكن قُرْبةً فإنه يدلُّ على نفيِ الحرج: كإقراره صلَّى الله عليه وسلَّم على أَكْلِ الضَّبِّ والجراد مع أنه لم يأكل منهما، وإلَّا فيدلُّ إقرارُه على صِحَّته: كصلاة ركعتين بعد الصبح كما في حديثِ قيس بنِ عمروٍ ـ ويقال: ابنُ قَهْدٍ ـ وسكوتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنه، [#تقدَّم تخريجه]. وإقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم على التركِ كإقراره على الفعل.
(١٦) «أ»: «فهو على».
(١٧) مِنْ شروط الإقرار الذي هو حُجَّةٌ:
أوَّلًا: أَنْ يَعْلَمَ بوقوعه سواءٌ بحضرته صلَّى الله عليه وسلَّم أو في زَمَنِه، ويكونَ قادرًا على الإنكار.
ثانيًا: أَنْ لا يكون قد بيَّن حُكْمَه بيانًا يُسْقِطُ عنه وجوبَ الإنكار.
ثالثًا: أَنْ لا يكون المسكوتُ عنه صادرًا مِنْ كافرٍ فلا عبرةَ فيه؛ لِما عُلِمَ بالضرورة مِنْ إنكارِه صلَّى الله عليه وسلَّم لِما يفعله الكُفَّار.
(١٨) ومثالُه الفعليُّ ما ثَبَتَ في قصَّةِ مُعاذٍ رضي الله عنه مِنْ أنه كان يُصلِّي العشاءَ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ ينصرفُ إلى قومه فيُصلِّي بهم؛ فاسْتُدِلَّ به على جوازِ اقتداءِ المُفْتَرِض بالمُتَنَفِّل؛ استدلالًا بما وَقَعَ في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم وكان مشهورًا؛ إذ غالبُ الظنِّ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يعلم الأئمَّةَ الذين يُصَلُّون في قبائل المدينة، لا سيَّما أنه قد ثَبَتَ في الصحيحين شكوى الأعرابيِّ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ إطالةِ مُعاذٍ رضي الله عنه في صلاته؛ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِمُعاذٍ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟» [أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٠) رقم: (٧٠٥)، ومسلمٌ (٤/ ١٨١) رقم: (٤٦٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما].
وأمَّا مثالُه القوليُّ: فهو قولُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رضي الله عنهم، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ» [أخرجه ابنُ أبي عاصمٍ في «السنَّة» (٥٥٣). وصحَّحه الألبانيُّ في «ظلال الجنَّة» (٥٥٣)].
(١٩) إِنْ قَصَدَ المُصنِّفُ بمثليَّةِ هذا القسمِ لِما كان بحضرته صلَّى الله عليه وسلَّم أنه مِثْلُه مِنْ حيث جوازُ الفعلِ وصحَّتُه فصحيحٌ، وإلَّا فليس هو مِثْلَه في القوَّة والحُجِّية؛ لاحتمالِ ألَّا يكون قد بَلَغه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا.
ومفهومُ كلامِ المُصنِّفِ أنَّ ما وَقَعَ في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم وكان خفيًّا، أي: لم ينتشرِ انتشارًا بحيث يبعد أَنْ يعلمه؛ فحكمُه أنَّ هذا ليس بحُجَّةٍ، بخلافِ ما وَقَعَ بحضرته أو في زمانه وكان مشهورًا، ويُمثِّلون لهذه الصورةِ بقولِ بعضِ الصحابة رضي الله عنهم: «كُنَّا نُكْسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَغْتَسِلُ» [أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٥/ ٣٥)، والهيثميُّ في «كشف الأستار عن زوائد البزَّار» (١/ ١٦٤)، مِنْ حديثِ عُبَيْدِ الله بنِ رِفاعة عن أبيه. والحديث في سنده محمَّدُ بنُ إسحاق صاحبُ المغازي: مشهورٌ بالتدليس عن الضُّعَفاء والمجهولين. انظر: «تعريف أهل التقديس» لابن حجر (١٣٢)، و«التبيين لأسماء المدلِّسين» للعجمي (٤٧)]؛ فهذا يظهر فيه قويًّا احتمالُ عدَمِ عِلْمِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ولهذا لم يكن حُجَّةً بخلافِ ما تقدَّم.
(٢٠) وهذه الناحيةُ هي السندُ والمتنُ الذي هو موضوعُ «علم الحديث درايةً»، ويُطْلَقُ عليه ـ أيضًا ـ اسْمُ: «مصطلح الحديث» و«أصول الحديث»، وهي أسماءٌ لمسمًّى واحدٍ، وهو: «مجموعةٌ مِنَ القواعد والمسائل التي يُعْرَفُ بها حالُ الراوي والمرويِّ مِنْ حيث القَبولُ والردُّ»؛ فالسندُ مِنْ جهةِ أحوال أفراده، واتِّصالِه وانقطاعِه وعُلُوِّه ونزولِه ونحوِ ذلك، والمتنُ مِنْ جهةِ صحَّته وضَعْفِه، وما يُلْحَقُ بذلك.
أمَّا «علمُ الحديث روايةً» فيقوم على نَقْلِ ما أُضِيفَ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ خَلْقية أو خُلُقيةٍ نقلًا دقيقًا مُحرَّرًا، فهذا موضوعُه، وهو لا يَسْتَغْنِي عن «علم الحديثِ درايةً» حتَّى يمكن معرفةُ المقبول مِنَ المردود. وقد اهتمَّ عُلَماءُ الحديثِ بهذا العلم وأَوْلَوْهُ رعايةً تامَّةً ودِقَّةً مُتَناهِيةً؛ حرصًا على حفظِ السنَّةِ على أَحْسَنِ وجهٍ بأَسْلَمِ قواعدِ التثبُّت العلميِّ.
(٢١) والسنَّةُ مِنْ حيث السندُ ليسَتْ على درجةٍ واحدةٍ؛ فهي تنقسم مِنْ هذه الحيثية إلى:
مُتواتِرٍ: وهو: «ما رواهُ جَمعٌ تُحيلُ العادةُ تواطُؤَهم على الكذب عن مِثْلِهم، مِنْ أوَّلِ السند إلى مُنْتَهاهُ، على أَنْ لا يَخْتَلَّ هذا الجمعُ في أيِّ طبقةٍ مِنْ طبقات السند».
وإلى آحادٍ: وهو ما عَدَا المُتواتِرَ، ويَشْمَلُ كُلَّ خبرٍ لم تتوفَّرْ فيه شروطُ المُتواتِر.
ويُضيفُ الأحنافُ قسمًا ثالثًا بينهما وهو: «المشهورُ»، والصحيحُ أنه يدخل ضِمْنَ الآحاد؛ إذ لا يُفيدُ إلَّا الظنَّ، والعُلَماءُ ـ أيضًا ـ يختلفون في المستفيض ومرتبتِه، والظاهرُ منها أنَّ المستفيض والمشهورَ بمعنًى واحدٍ ولا يخرجان عن الآحاد.
(٢٢) المُتواتِرُ مِنَ السنَّة ـ باعتبارِ المتن ـ قسمان:
مُتواتِرٌ لفظيٌّ: وهو: «ما اتَّفق فيه الرُّواةُ على اللفظ والمعنى»؛ فهو كتواتر القرآن، ومنه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [متواتر: انظر: «صحيح الجامع الصغير» للألباني (٢/ ١١١١) رقم: (٦٥١٩)].
ومتواترٌ معنويٌّ: وهو: «ما اتَّفق نَقَلَتُه على مَعْناهُ مِنْ غيرِ مُطابَقةٍ في لفظِه»، كأحاديثِ الشفاعةِ والرؤيةِ والميزانِ والحوضِ والصراطِ، وأحاديثِ نَبْعِ الماءِ مِنْ بينِ أصابِعِه صلَّى الله عليه وسلَّم.
والخبرُ المُتواتِرُ مُفيدٌ للعلم اليقينيِّ؛ لأنَّ حصولَ العلمِ به أمرٌ يُضْطَرُّ إليه الإنسانُ، وهو أمرٌ مُتَّفَقٌ عليه بين العُقَلاء.
واللافت للنظر: أنَّ أهل الحديثِ لم يُفصِّلوا القولَ في المُتواتِرِ وشروطِه، وإنما هو صنيعُ أهل الأصول؛ لأنَّ المُتواتِرَ ليس مِنْ مَباحِثِ علمِ الإسناد؛ لذلك يجب العملُ به مِنْ غيرِ بحثٍ عن رجالِه، وإنما وَقَعَ التفصيلُ في مَباحِثِه وشروطِه مِنْ قِبَلِ أهل الأصول.
(٢٣) انتقل المُصنِّفُ إلى أقسام الحديث مِنْ حيث القَبولُ والردُّ؛ فبَدَأَ بالحديث الصحيح وهو على قسمين: صحيحٍ لذاته، وصحيحٍ لغيره.
فالصحيح لذاته هو: «المُسْنَدُ الذي اتَّصل سندُه بنَقْلِ العدل الضابط ضبطًا تامًّا عن مِثْلِه مِنْ أوَّلِه إلى مُنْتهاهُ مِنْ غيرِ شذوذٍ ولا عِلَّةٍ»، وهو مُشْتَمِلٌ على أعلى صفاتِ القَبول كما يظهر مِنْ تعريفه.
أمَّا الصحيح لغيره فهو: الحديث الذي لم تتوفَّر فيه أعلى صفاتِ القَبول، كأَنْ يكون راويهِ: العدلَ غيرَ التامِّ الضبط، وهو الحَسَنُ لذاته إذا عُضِّدَ بطريقٍ آخَرَ مِثْلِه؛ فيصيرُ صحيحًا لغيره.
(٢٤) الحديث الحَسَنُ وهو ـ أيضًا ـ على نوعين: حَسَنٌ لذاته، وهو: «ما اتَّصل سندُه بنقلِ العدل الذي خَفَّ ضبطُه عن مِثْلِه مِنْ أوَّلِه إلى مُنْتهاهُ مِنْ غيرِ شذوذٍ ولا عِلَّةٍ»، وسُمِّي بذلك لأنَّ حُسْنَه ناشئٌ عن توفُّرِ شروطٍ خاصَّةٍ فيه لا يَتَّجِهُ لشيءٍ خارجٍ عنه.
أمَّا الحَسَنُ لغيره فهو: الضعيفُ في الأصل، وإنما طَرَأَ عليه الحُسْنُ بالعاضد الذي لولاه لَاستمرَّتْ صفةُ الضعفِ فيه.
(٢٥) وحكمُ الحديثِ المقبولِ ـ سواءٌ كان صحيحًا لذاته أو لغيره، أو حَسَنًا لذاته أو لغيره ـ أنه حُجَّةٌ في جميعِ الأحكام وسائرِ المسائل، سواءٌ وافَقَ القياسَ أو خالَفَهُ، أو عَمَّتْ به البلوى أو لم تَعُمَّ، وسواءٌ فيما يسقط بالشُّبْهة أو ما لا يسقط بها، أو فيما زادَ على القرآنِ أو كان مُوافِقًا ومُؤكِّدًا له أو مُبَيِّنًا؛ فعند أهلِ السنَّة: وجوبُ العملِ به ما لم يَرِدْ دليلٌ صحيحٌ ناسخٌ له أو راجحٌ عليه عند تَعذُّرِ الجمعِ حالَ التعارض الظاهريِّ.
هذا، وحَرِيٌّ بالتنبيه أنَّ المُصنِّفَ ذَكَرَ صلاحِيَةَ الاستدلالِ به في الأحكام دون التعرُّض إلى العقائد، والصحيحُ أنَّ خبر الواحدِ حُجَّةٌ في الأحكام والعقائد مِنْ غيرِ تفريقٍ بينهما، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه عند السلف، والتفريقُ بينهما أمرٌ حادثٌ مُبْتَدَعٌ في دينِ الله، كما نصَّ على ذلك ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في [«الصواعق المُرْسَلة» ـ باختصار الموصلي ـ (٥٠٣)]؛ إذ إِنَّ هذا الفرقَ لم يكن معروفًا عند أحَدٍ مِنَ الصحابة والتابعين، ولا عند تابِعِيهم ولا عند الأئمَّة الأعلام، وإنما عُرِفَ عن رؤوسِ أهلِ البِدَعِ ومَنْ تَبِعَهم، [انظر الفتوى رقم: (٩٤٣) الموسومة ﺑ: «في حجِّية خبر الواحد في الأحكام والعقائد»].
(٢٦) قوله: «لذلك» فاسْمُ الإشارةِ يعود إلى الاحتجاج به في الأحكام وكذلك في العقائد.
(٢٧) الحديث الضعيفُ هو: «كُلُّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفاتُ القَبول»، أو: «لَم يجمع شروطَ الحديثِ الصحيح أو الحَسَن».
فإذا ما فَقَدَ شَرْطَ الاتِّصالِ نَتَجَ عنه: المُعلَّقُ والمُنْقَطِعُ والمُعْضَلُ والمُرْسَلُ والمدلَّس.
وإذا فَقَدَ شَرْطَ العدالةِ تَرتَّبَ عليه: الموضوعُ والمتروكُ والمُنْكَرُ والمطروحُ والمضعَّفُ والمجهولُ وغيرُها.
وإذا فَقَدَ شَرْطَ الضبطِ نَتَجَ عنه: المُدْرَجُ والمقلوبُ والمُضْطَرِبُ والمُصحَّف والمُحرَّف.
وإذا فَقَدَ شَرْطَ عدَمِ الشذوذ: ظَهَرَ الحديثُ الشاذُّ.
ويظهر الحديثُ المعلَّلُ بفقدان الحديثِ لشرطِ عدَمِ العِلَّة.
(٢٨) والمُصنِّفُ يذهب إلى جوازِ الأخذ بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفي فضائلِ الأعمال والمَواعِظِ ونحوِ ذلك دون الأحكام إذا كان ضَعْفُه غيرَ شديدٍ؛ ليَخْرُجَ منه ما انفرد به الكذَّابون والمتَّهَمون بالكذب ومَنْ فَحُشَ غَلَطُه، وقد نَقَل العلائيُّ ـ رحمه الله ـ الاتِّفاقَ على هذا الشرط، ويُضيفُ أصحابُ هذا المذهبِ شرطين آخَرَين، وهُما:
ـ أَنْ يندرج الحديثُ تحت أصلٍ معمولٍ به، ولعلَّ هذا الشرطَ هو مُرادُ المُصنِّفِ مِنْ قوله: «بدليلٍ مُعْتَبَرٍ».
ـ وأَنْ لا يعتقد عند العملِ به ثبوتَه؛ لئلَّا يَنْسِبَ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ما لم يَقُلْه، بل يعتقد الاحتياطَ، [انظر: «تدريب الراوي» (١٩٦)].
ويُقابِلُ هذا الرأيَ المُفصِّلَ مذهبان: أحَدُهما يمنع العملَ به مُطلقًا، والآخَرُ يُجيزُه مطلقًا، ولعلَّ أَسْلَمَ المَذاهبِ الرأيُ الذي يمنع مطلقًا، وهو مذهبُ البخاريِّ ومسلمٍ وابنِ حزمٍ وغيرِهم؛ لِما يُوجَدُ في الترغيب والترهيب مِنَ الروايات الصحيحة الثابتة التي تُغْنِينا عن الأخذِ والعمل بالأحاديث الضعيفة في هذا المجال.
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 1026 مرة
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)