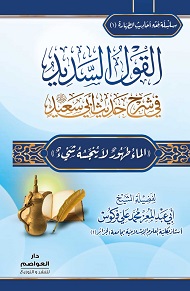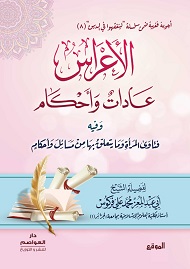- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٢٦٣
الصنف: فتاوى منهجية
تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى:
«الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»
السؤال:
شيخَنا ـ سلَّمك الله ـ نَعلم أنَّ الفتوى رقم: (١٢٦٠) الموسومة ﺑ: «في حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر» قد أخذَتْ منكم وقتًا كثيرًا بسببِ تَهاطُلِ إشكالاتِ المُريدين للصواب، وتصلُّبِ المُعانِدين وتعسُّفِ المتحاملين؛ ونَستسمِحُكم في أَنْ نقتطع جزءًا مِنْ وقتكم الثمين لِتُنوِّروا فهومَنا فيما يتعلَّق بما يُروِّجُ له بعضُهم مِنْ أنَّ كُلَّ الأدلَّة التي أُورِدَتْ في الفتوى عليها إيراداتٌ، وليس فيها دلالةٌ صحيحةٌ على جواز الإنكار علانِيَةً؛ وبعضُ أصحابِ هذه الإيراداتِ مِنَ المُغرِضين ـ علاوةً على كونهم يُخطِّئونكم في هذه المسألةِ ـ فهُم ينسبون إليكم الشذوذَ والانحرافَ المنهجيَّ في الدَّعوة إلى الله، وتفصيلُ اعتراضاتهم على النحو الآتي:
ـ غايةُ ما في أدلَّةِ الفتوى أنها اجتهاداتٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم، واجتهادُ بعضِهم لا يكون حجَّةً على غيرِهم رضي الله عنهم.
ـ وعُبادةُ بنُ الصامتِ لم يتعرَّضْ لمعاويةَ رضي الله عنهما بالذِّكر، وإنما أَنكرَ المعاملةَ الربَوِيَّةَ وأَرشدَ إلى السُّنَّةِ النبويَّة، وهذا جارٍ على ما قرَّره علماءُ السُّنَّةِ مِنْ أنَّ المُنكَر يُنكَرُ دون التعرُّض للحاكم وفاعلِ المُنكَر بالتصريح.
ـ وحديثُ معاويةَ رضي الله عنه الآخَرُ ـ وهو أقوى الأدلَّة ـ: «سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ القِرَدَةُ»(١)، غايةُ ما فيه: أنَّ معاوية رضي الله عنه قَبِل إنكارَ الرَّجل الذي أَنكرَ عليه، وهو مِنَ الصحابة يَعترِيهِ الخطأُ فيما اجتهد فيه كما يعتري سائرَ البشرِ غيرِ المعصومين، فلا يُتعامَلُ مع أقواله كما يُتعامَلُ مع النصوص النبويَّة، ولا يصحُّ أَنْ يُؤسَّس لقاعدةٍ جديدةٍ مَفادُها: أنَّ هذه سُنَّةٌ إقراريَّةٌ مِنْ معاويةَ رضي الله عنه.
ـ ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ معاويةَ رضي الله عنه هو الذي أراد أَنْ يَستخرِجَ مِنْ رعيَّتِه مَنْ يردُّه إلى صوابه، فتَنازَل عن حقِّه في أَنْ يُنصَح سِرًّا، ولم يفعله معاويةُ ليُستدَلَّ به على النصح جهرًا، وإنما فَعَله امتحانًا.
ـ كما أنَّ رأي معاوية ـ مِنْ جهةٍ ثالثةٍ ـ مُقابَلٌ برأيِ أسامةَ رضي الله عنهما، فعن أبي وائلٍ قال: قِيلَ لأسامةَ: «لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ»، قال: «إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ، إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»(٢).
وأمَلُنا مِنْ شيخِنا ـ حفظه الله ـ أَنْ يجيب عن هذه الإيراداتِ بما تقتضيهِ القواعدُ العلميَّةُ على ما أَلِفْناه منكم، ونطلب منكم بإلحاحٍ ـ إذا كان وقتُكم يُسعِفكم ـ ذِكرَ الآثارِ الدالَّةِ على الإنكار العلنيِّ على وُلَاةِ الأمر في غَيْبَتِهم، إذ ثَمَّةَ مَنْ يزعم أنَّ جميعَ ما وَرَد عن السلف في الإنكار إنما كان في حضرة وُلَاة الأمر.
سائلين اللهَ أَنْ يُسدِّد خُطَاكم، وأَنْ يبارك في وقتكم، وأَنْ يُعلِيَ شأنَكم في الدنيا والآخرة، ويُجزِلَ لكم الأجرَ والثواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما تَقرَّر في الفتوى المُشارِ إليها والردِّ على إشكالِ المُعترِض في مسألةِ جواز الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر الذي خالف الشريعةَ عَلَنًا بالضوابط الشرعيَّة المُبيَّنةِ في أصل الفتوى هو ما أَدِينُ اللهَ به وأَعتقِدُه راجحًا وأَلتزِمُ بحُكمه عند الاقتضاء، مع مراعاة المصلحة في بيانِ المُنكَر والحكمةِ في تقديم النصيحة لأُولِي الأمر، وتركِ الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ ـ على حدٍّ سواءٍ ـ عند وجود المانع وهو غلبةُ الظنِّ بحدوث مفسدةٍ أو ترتُّبِ شرٍّ.
هذا، والمعلومُ مِنْ مسائل الدِّين والشريعة: أنَّ النصوص الشرعيَّة العامَّةَ أو المُطلَقةَ لا يُقضَى بتخصيصها ولا يُحكَم بتقييدها إلَّا عند ورودِ الدليل الخاصِّ المُخرِج لبعضِ الأفراد مِنَ العامِّ أو دليل التقييد المُنافي لصفة الإطلاق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء].
وعليه، فصُوَرُ أدلَّةِ عمومات الكتاب والسُّنَّةِ كثيرةٌ في بيان الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَر، فهو واجبٌ كِفائيٌّ على الأمَّة جميعًا، سواءٌ كان حاكمًا ـ رئيسًا أو مَلِكًا أو سلطانًا أو أميرًا أو وزيرًا أو واليًا أو قائدًا أو قاضيًا أو عونًا حكوميًّا رفيعًا ونحوَ ذلك ـ أو كان محكومًا، وذلك يَشْمَل جميعَ شرائحِ المُجتمَع وطبقاته، هذا مِنْ ناحيةٍ، كما يَشْمَل ـ مِنْ ناحيةٍ أخرى ـ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ أوَّلًا ـ المتمثِّلَ في المُشافَهةِ السِّرِّيَّة والمكالمةِ عبر وسائل الاتِّصال أو بالمراسلة السِّرِّيَّة، لأنَّ «الكِتَابَ كَالخِطَابِ»، ويَشْمَل الإنكارَ العلنيَّ ـ ثانيًا ـ الذي يكون في حضورِه مُشافَهةً بوجوده، أو في غَيْبَتِه، سواءٌ كان إنكارُ المُنكَر في غَيْبَتِه بالتصريح أو التعريض(٣) أو التلميح(٤) بحسَبِ مقتضَيَاتِ الإنكار وإمكانياته؛ فهو واجبٌ على الأمَّة وحقٌّ لها، فكما يجب على الحُكَّام والأُمَراء والوُلَاة والقُضَاة أَنْ يأمروا بالمعروف ويَنْهَوْا عن المُنكَر مُطلَقًا، فكذلك على الأمَّة أَنْ تأمر وتنهى حُكَّامَها وأُمَراءَها مُطلَقا قيامًا بالواجب في إزالة المُنكَر وأداءً للحقِّ ومنعًا لتفويته بحسَبِ القدرة، ودون أَنْ تأخذهم في أمرِ الله هَوَادةٌ أو يخافوا لومةَ لائمٍ، ومِن غير إحداثِ مُنكَرٍ أكبرَ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(٥)، وهذا المعنى مِنَ الإنكار يدخل في عموم باب النصيحة التي هي حقيقةُ الدِّين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٦)؛ والنصحُ لأئمَّةِ المسلمين فإنه ـ فضلًا عن طاعتهم في المعروف، وتذكيرِهم بالمسؤوليَّة المُلقاة على عاتِقِهم، وصيانةِ الألسنَةِ عن ذمِّهم وتجريحِهم وغيرِها ـ فإنَّهم يشتركون مع النصح لعامَّةِ المسلمين في التآمُرِ بينهم بالمعروف والتناهي عن المُنكَرِ كما قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة]، وقال تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران ١١٠]؛ ولا يخفى أنَّ هذه الآياتِ والأحاديثَ في وجوب الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَرِ لم تُفرِّق بين الحاكم بمُختلِفِ طبقاتِ الأعيان الحاكمة ممَّنْ يَنوبُ مَنابَه، والمحكومِ على مُختلِفِ طبقات المُجتمَع وشرائحِه، ولا بين الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ؛ وإذا وَرَد الاستثناءُ في الإنكار العلنيِّ بعلَّةِ الخوف مِنْ ترتُّبِ مفسدةٍ أو مَهْلكةٍ فيجبُ تركُه في تلك الحالِ عملًا بالأصل الفقهيِّ: «يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ وَأَيْسَرُ المَفْسَدَتَيْنِ تَفَادِيًا لِأَشَدِّهِمَا»، مع بقاء الأصل دون حكمه، ويزول حكمُ المنع مِنَ الإنكار العلنيِّ بزوال عِلَّتِه التي هي خارجةٌ عن أصل النَّصِّ المُطلقِ ولا يُقيَّد بها إلَّا في حالِ وجودِ العلَّةِ، إذ الحكمُ يدور مع عِلَّته وجودًا وعدَمًا، وهذا الضابطُ مِنْ دفعِ المفسدة تَقدَّم ذِكرُه في الفتوى، لكِنْ لا يعني ذلك أنه يجب نفيُ جملةِ الإنكار العلنيِّ إذا تَوفَّر سببُه ولم يمكن تغييرُ المُنكَرِ إلَّا بالعلن وتَحقَّق شرطُه وانتفَتْ موانِعُه؛ لأنَّ نفيَ أصلِ الإنكار في عمومه الذي تشهد له نصوصُ الشرع ـ على ما تقدَّم ذِكرُه أعلاه ـ هو ـ في حدِّ ذاته ـ نفيٌ للشرع اللازمِ العملُ به وتعظيمُه؛ ويشهَدُ لهذا الآثارُ السلفيَّةُ الموقوفةُ المتقدِّمة في الفتوى، وفي الرَّدِّ على إشكال المُعترِض، ومنها ـ أيضًا ـ إنكارُ كعب بنِ عُجرةَ رضي الله عنه علنًا على عبد الرحمن بنِ أمِّ الحَكَم، حين «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١]»»(٧)؛ قال النووي ـ رحمه الله ـ: «هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المنكر، والإنكارَ على ولاة الأمور إذا خالفوا السنَّة»(٨)؛ ومِثلُه عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ(٩).
وبالمقابل فإنَّ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ أيضًا ـ إذا كان يُحدِثُ إنكارُه مفسدةً ويترتَّب عليه شرٌّ، فإنَّ حُكْمَه: منعُ الإنكارِ السِّرِّيِّ وسقوطُ وجوبِه في هذه الحال مع بقاء الإنكار القلبيِّ لأنه لا يسقط بحالٍ، لكِنْ يزول حكمُ المنع بزوال عِلَّته وهي خشية المفسدة، أي: ليس معنَى ذلك سوى سقوطِ وجوب الإنكار السِّرِّي مع بقاء أصله، ومتى زالت علَّةُ المفسدة عاد حكمُه في وجوب الإنكار السِّرِّيِّ إذا تحقَّقَتْ شروطُه وانتفَتْ موانعُه، فهو كمُقابِله لا يجوز نفيُه مُطلَقًا لنفسِ العلَّة المذكورة آنفًا، وإلَّا كان نفيًا لشطرِ النصِّ، وردُّ النصوصِ جريمةٌ وصنيعُ أهل الأهواء؛ لأنَّ المعلوم أنَّ الشيء يُعطَى حُكمَ نظيره، ويُنفَى عنه حكمُ مُخالِفه، فهو مِنْ قبيل الجمع بين المتماثلات لا التفريقِ بينها. وما ذُكِر مِنَ المعارضة ـ في هذا الباب ـ فغيرُ صحيحةٍ؛ لأنها تُؤدِّي إلى ترك العمل بالنَّصِّ عند انتفاءِ عِلَّةِ التَّرْك مع عدمِ اطِّرادها، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ يخالف المنقولَ ومُقتضَيَاتِ المعقول، إذ المعارضةُ الصحيحة هي التي يمكن طَرْدُها، وليس أمرُ المُعترِضين كذلك، ولهذا لمَّا قال سعيد بنُ جُبَيْرٍ لابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ؟» قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا»، وفي روايةٍ أنَّه قال رجلٌ لابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟»، قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الإِمَامَ...»(١٠)، فهو رضي الله عنه لم يَنْفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد الجوازَ بالأمن مِنَ القتل والتهلكة وبعدم التَّأنيب والفتنة، ومثيلُه رأيُ أسامة رضي الله عنه كما سيأتي، وهذا الضابط وغيرُه قد بيَّنتُه سابقًا لمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ.
فالحاصل ـ إذن ـ أنَّ عموم النصوص الشرعيَّة النَّاهية عن المُنكَر تدلُّ على مُطلَق الإنكار سرِّيًّا كان أو علنيًّا لا على الإنكار المُطلَق؛ لورود الضَّوابطِ المُقيِّدةِ له والمُستخلَصةِ مِنَ القواعدِ الشَّرعيةِ العامَّةِ والمُستوحاةِ مِنَ المَقاصدِ والحِكَمِ المَرعيَّة ذاتِ أبعادِ النَّظرةِ المَآليَّةِ، وهي تدلُّ ـ بمُجمَلها ـ على مشروعيَّةِ الإنكار السرِّيِّ والعلنيِّ بجميع وجوههما إذا توفَّر شرطُهما وانتفى مانعُهما سواءٌ بالمشافهة السرِّيَّة أو الوسائل السرِّيَّة الأخرى أو كانت علنيَّةً بالمشافهة بحضرَتِه أو بالتصريح أو التعريض أو التلميح في غَيْبته على ما تقدَّم ذِكرُه.
فإذا تقرَّر هذا الحكمُ فلا إشكالَ ألبتَّةَ في:
· قصَّةِ عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه في إنكاره للمعاملة الربويَّة التي أَمَر بها معاويةُ رضي الله عنه، وغاب عنه حُكمُها، فأَرشدَ عبادةُ رضي الله عنه فيها إلى السُّنَّة النبويَّة، والقول بأنَّ عبادة رضي الله عنه أَنكرَ المُنكَرَ فيها دون التعرُّض للحاكمِ أو فاعلِ المُنكَرِ بالذِّكرِ والتَّصريحِ غيرُ مُتَّجِهٍ، فإنه ـ وإِنْ سلَّمْنا جدلًا ـ أنه لم يصرِّح باسْمِ معاوية رضي الله عنه إلَّا أنه لمَّح به وعرَّض بذِكر الوصف، والتَّعريضُ والتَّلميحُ يدخلان في باب الإنكار العلنيِّ ـ كما تقدَّم ـ ولم يَكن بحضرتِه بل في غَيْبَته، وقد فَهِم الناسُ أنَّ المُرادَ به حكمُ المعاملةِ المأمورِ بها مِنْ قِبَلِ معاوية رضي الله عنه، فرَدَّ الناسُ ما أخَذُوا، ولذلك عرَّض معاويةُ بحديثه لمَّا بَلَغه مشكِّكًا فيه، بناءً على أنه لم يسمعه مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع أنه صَحِبه وكان كاتبًا له، ثمَّ أعاد عُبادةُ رضي الله عنه القصَّةَ وذَكَره تصريحًا، ثمَّ قال: «لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ـ أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ ـ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ»(١١)؛ وقد كان عُبادةُ رضي الله عنه في هذه القصَّةِ مُطبِّقًا لمقتضى المبايعةِ في حديثِهِ الآخَرِ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»(١٢)؛ فصَدَع رضي الله عنه بالحقِّ بيانًا للحكم الشرعيِّ دون هَوَادةٍ، وأَنكرَ المُنكَرَ بحسَبِ قُدرتِه حيث لا يؤدِّي إنكارُه إلى مُنكَرٍ أكبرَ، مِنْ غيرِ أَنْ يُنازِعَ الأمرَ أهلَه أو ينزع يدًا ممَّا يَلزَمُه فيه طاعتُه، علمًا أنَّه ثبَتَ مثلُ هذا عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه تصريحًا لا تعريضًا، فعن موسى بنِ أنسٍ قال: «خطَبَ الحجَّاج بنُ يوسفَ النَّاسَ فقال: «اغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، فاغسِلوا ظاهِرَهما وباطِنَهما وعراقيبَهما، فإنَّ ذلك أَقرَبُ إلى جَنَّتكم»، فقال أنسٌ: «صدَقَ اللهُ، وكذَبَ الحجَّاج؛ ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلِكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦]»»، قال: «قرَأَها جرًّا»(١٣).
· أمَّا ما أَوردَه بعضُهم على حديثِ معاوية رضي الله عنه الآخَرِ ـ وهو التَّقاحُمُ في النَّار ـ بقوله: «ولا يصحُّ أَنْ يُؤسَّس لقاعدةٍ جديدةٍ، مَفادُها: أنَّ هذه سُنَّةٌ إقراريَّةٌ مِنْ معاوية رضي الله عنه» فجوابُه:
ـ أنَّ حديث معاوية رضي الله عنه ليس موقوفًا عليه، وإنما هو مرفوعٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو حجَّةٌ، ولعلَّ المُعترِضَ توهَّم في ذلك الوقفَ فبنى عليه كلامَه.
ـ أنَّ هذه حَيْدةٌ، لأنَّ الحجَّةَ ما نَقَله الراوي، وغايةُ ما في الأمر أنَّ الراويَ ـ وهو معاوية ـ فسَّره بفعله، ولا يخفى أنَّ الحيدة عن الجواب هروبٌ عن الإلزام وضربٌ مِنَ الانقطاعِ يُنافي قواعدَ المناظرة.
ـ والقول بأنَّه اجتهادُ صحابيٍّ في فهمِ النصِّ يخالفه غيرُه مِنَ الصحابة فغيرُ سليمٍ ـ أيضًا ـ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في عموم وجوب الإنكار سواءٌ كان سرِّيًّا أو علنيًّا، وإنَّما اختلفوا في سقوط واجبِه حالَ حدوثِ علَّة المفسدة على ما ذَكَره ابنُ القيِّم ـ كما سيأتي ـ ولأنَّ معاويةَ هو راوي الحديثِ وأعلمُ بمُلابَساته، ولهذا وردت القاعدةُ الترجيحيَّة: «الرَّاوِي أَعْلَمُ بِمَا رَوَى».
· ومِنْ أغربِ ما سمعتُ مِنِ اعتراضٍ: أنَّ معاوية رضي الله عنه إنما أراد أَنْ يَستخرِجَ مِنْ رعيَّتِه مَنْ يردُّه إلى صوابه، فتَنازَل عن حقِّه في أَنْ يُنصَح سِرًّا، وكأنَّ إنكار المُنكَر حقٌّ لمعاوية رضي الله عنه يتصرَّف فيه كما شاء تصرُّف المشرِّع، وهذا ـ عندي ـ يُعَدُّ مِنَ التَّلاعب بمضمون النَّصِّ الشَّرعيِّ وإرادةِ إخضاعِه للهوى، وعدمِ الاكتراث بمواقف الصحابة رضي الله عنهم الأخرى التي كان فيها إنكارٌ على الوُلَاة مِنْ غيرِ سبقِ إذنٍ منهم بذلك، وقد تقدَّم بعضُها.
ولو سُلِّم ـ جدلًا ـ مِثلُ هذا الاعتراضِ مع ما يجب فيه مِنْ تنزيه الصحابة رضي الله عنهم مِنَ التصرُّف في الأحكام الشرعيَّة، فلم يكن ذلك القصدُ مِنْ معاوية معلومًا للمُنكِر عليه مقولتَه أوَّلًا، ولم يكن معروفًا للحضور الذين شهدوا الواقعةَ ثمَّ انصرفوا بعدها ثانيًا، ثمَّ كيف يدفع معاويةُ رضي الله عنه الرَّجلَ إلى ارتكابِ ما هو باطلٌ في نظر المُعترِض ولم يُرشِدْه ـ لا هو ولا غيرَه ـ إلى الحقِّ المُبين بدعوى الامتحان؟ ﻓ «تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، ومَنْ بعد معاوية ليسوا في مِثلِ حِلمه، وهل معنَى ذلك أنَّ صاحبَ هذا الاعتراضِ يشهد على معاويةَ رضي الله عنه تقريرَه بفعلِه القاعدةَ المِكيافيليَّة: «الغاية تبرِّر الوسيلةَ»؟! فإذا كان اللازمُ باطلًا فالملزومُ مِثلُه، والحقيقةُ أنَّ هذا المُعترِضَ ليس مِنْ هذا النصِّ في العِير ولا في النفير.
علمًا أنَّ اجتهاداتِ الصحابة ـ في هذه المسألة ـ لم تأتِ مُتضارِبةً بل جاءت مُتوافِقةً في جواز الإنكار العلنيِّ، وقد يُسقِط بعضُهم واجبَ الإنكار العلنيِّ حكمًا لا أصلًا خشيةَ التهلكة أو القتلِ أو التأنيبِ أو الفتنة ـ لا لمجرَّدِ هيبة الناس دون خوف الأذى منهم ـ كما سَبَق ذِكرُه عن سعيد بنِ جُبَيْرٍ أو مع الرَّجل الذي سأل ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ونظيرُه قولُ أسامة رضي الله عنه: «إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ، إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ»، فهو رضي الله عنه لم يَنفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، ولكِنْ خَشِيَ فَتْحَ بابِ التهلكة، والحقيقة أنَّ ظاهِرَ قولِ أسامةَ رضي الله عنه ليس فيه أنَّه نفى عن نفسِه مُكالَمَتَه أمامَ الناس، بل نفى حَصْرَ مُكالَمِته في كونها أمامَ الناسِ، فكأنه يقول: هل تظنُّون أنِّي لا أُكلِّمه إلَّا وأنتم تسمعون أو إذا كان ذلك بمَسمعِكم ـ كما في بعض الروايات: بسمعِكم ـ(١٤) أو بمرأًى منكم أو إذا أَخبرتُكم أنِّي كلَّمْتُه، إنِّي لَأكلِّمه ـ علاوةً على ذلك ـ فيما بيني وبينه، وهذا كما أنه أقرَبُ إلى الاستصلاح وأدرأُ للفتنة فهو أبعدُ عن الرِّياء في الحال التي كان فيها عثمانُ رضي الله عنه؛ يشهد لهذا لفظُ مسلمٍ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قِيلَ لَهُ: «أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟» فَقَالَ: «أَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟! أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟! فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»»(١٥).
فالحاصل: أنَّ مِنَ الحكمة في الإسرار بالإنكار أو النصيحة في الجملة: أنه أبعدُ عن الرِّياء وأقرَبُ إلى التجرُّد ـ كما نلحظه مِنْ أثرِ أسامةَ ـ وهو أجدرُ باستصلاحِ القلوبِ وأدعى إلى القبول. وعليه، فَلَمْ يبقَ للمعترِضِ ـ والحالُ هذه ـ أدنى مسكةٍ بهذه الشبهةِ يتشبَّث بها، ومع ذلك فإِنْ حمَلْناه على المعنى الأوَّل فهو يدخل ـ بلا شكٍّ ـ فيما تقدَّم مِنَ الضوابط الشرعيَّة، فلا تعارُضَ ـ حالتَئذٍ ـ فيما تقرَّر ذِكرُه، وفي هذا السياقِ وضَّح ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ صحَّةَ هذا المعنى بقوله: «ما قالَهُ عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: «بايَعْنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أَنْ نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ»(١٦)؛ ونحن نشهدُ بالله أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ، وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَنْ تَأمَّلَهُ مِنْ هديهِم وسيرتِهم، فقَدْ أَنكرَ أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأَنكرَ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو أميرٌ، وأَنكرَ ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأَنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِنْ إنكارِهم على الأمراءِ والوُلَاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ: لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَنْ بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أَنْ يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»(١٧).
هذا، وقد سَبَق وأَنْ ذكرتُ الآثارَ الدالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حضرَتِه وغَيْبَتِه وفنَّدْتُ شُبُهاتِ المُعترِضين، وقد ساق ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ جملةً منها، وفضلًا عن ذلك يمكن إضافةُ بعض آثار السلف الدالَّةِ على الإنكار العلنيِّ في غَيْبتهم أو دون اطِّلاعِهم ردًّا على مَنْ يَقْصُرها على كونها بحضرتهم وهي:
أوَّلًا: إنكارُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ على معاوية رضي الله عنهما:
عن عياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ ـ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(١٨).
ثانيًا: إنكار ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم:
عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ»(١٩)؛ ولم يُنكِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنِ عمر إنكارَه على خالدٍ ولا حتَّى صفةِ إنكاره بالعلن؛ وكانت مبادرةُ ابنِ عمر إلى ذلك درءًا لمفسدةِ قتلِ مَنْ لا يستحقُّ القتلَ.
ثالثًا: إنكار ابنِ مسعود على عثمان رضي الله عنهما:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ»(٢٠)؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»(٢١).
رابعًا: إنكار عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما:
عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه الترفُّهَ بتركِ أحَدِ السفرين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ»(٢٢).
خامسًا: إنكار ابنِ عبَّاسٍ على عليٍّ رضي الله عنهم:
عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: «صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ»»(٢٣).
سادسًا: إنكار الحسن البصريِّ على أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه وفعلِ الحجَّاج:
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا»(٢٤)؛ يعني: أنَّ مصلحة التحديث بحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُعارَضةٌ بمفسدةِ مسارعةِ الحجَّاج إلى القتل للخوارج وغيرِهم متذرِّعًا بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المُحارِبين؛ فإنكارُه على أنسٍ تحديثَ الحجَّاج بهذا يتضمَّن ـ لزومًا وبالأَوْلى ـ إنكارَ أفعالِ الحجَّاج وهو أميرُ العراق.
سابعًا: إنكار عائشة على مروان في حضوره، وإنكار أخيها عبدِ الرحمن على معاوية في غَيْبته:
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي»(٢٥)، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ»، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «كَذَبَ ـ وَاللَّهِ ـ مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ؛ فَمَرْوَانُ قَصَصٌ [أو فَضَضٌ(٢٦)] مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٢٧). وغيرها مِن الآثار الدالَّة على الإنكار العلنيِّ في غيبة وليِّ الأمر ودون اطِّلاعٍ منه.
هذا، وأمَّا الرمي بالخطإ العشوائيّ العاري عن الدليل، أو المبنيُّ على الشُّبهات أو على ضعف الأدلَّة أو على التعصُّب والهوى والتقليد، فإنَّه ـ مع ما فيه مِنَ المغالطةِ والانتقاصِ ـ فهو مجازفةٌ بالحقِّ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيحِ، بل هو مِنَ التَّجنِّي والظُّلمِ والجهر بالسُّوء الذي لا يحبُّه اللهُ لِمَا فيه مِنْ معنى السَّبِّ والشَّتم والثَّلب الذي يَقدِرُ عليه كُلُّ واحدٍ.
والمعلومُ أنَّ الخطأ قد يقع مِنَ الناظر المؤهَّل ومِنَ المجتهد الفقيه حالَ الاستدلال بالدليل نتيجةَ قُصورِ فهمِه، والقصورُ: إمَّا أَنْ يكون في معرفة النقل وفي معرفةِ طُرُقه، أو في تمييز الصحيح مِنَ السقيم، فهذا الجانب الحديثيُّ موكولٌ إلى أهله مِنْ ذوي الاختصاص بفنون الرواية ومعرفةِ الرجال، ولا ننقل منه إلَّا المقبولَ في الاستدلال ـ ولله الحمدُ والمِنَّة ـ.
وإمَّا أَنْ يكون القصور في معرفةِ دلالةِ الأدلَّةِ وتحقُّقِ معانيها، فإنَّ المشاركة الاجتهاديَّة فيها لم تخرج عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وتقريراتِ علماء السُّنَّة العاملين الذين أثبتوا ـ في الجملة ـ الإنكارَ العلنيَّ بضوابطه مثل الشيخ عبد العزيز بنِ بازٍ(٢٨) والشيخ الألبانيِّ(٢٩) والشيخ ابنِ عثيمين(٣٠) والشيخ مُقبِل بنِ هادي الوادعيِّ(٣١) والشيخ عبد الله بن قعود(٣٢) رحمهم الله وغيرهم كثير، فإذا نُسِب الخطأُ والشذوذُ إلى هذه الفتوى فإنما يُنسَب إلى هؤلاء المنقولِ عنهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم والعلماءِ الأثبات مِنْ بابٍ أَوْلى.
ومع ذلك لا أدَّعي العصمةَ في فتاوايَ وكتاباتي، ولا آمَنُ مِنَ الزلل في مناقشتي للمسائل والإشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجةً لقصورِ فهمٍ أو اجتهادٍ خاطئٍ، أو عدمِ استقصاءٍ في البحث أو غلطٍ في التصوُّر ونحوِ ذلك، ويبقى رجائي في الله أَنْ يجنِّبَني العثارَ ويُلهِمني الرَّشَدَ، وأَنْ يغفر لي ويعفوَ عنِّي، ويجعلَني ممَّنْ يستمعون القولَ فيتَّبِعون أحسنَه؛ إنه سبحانه جوادٌ كريمٌ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ وبالإجابة جديرٌ.
وأمَّا إِنْ كان المقصودُ مِنْ وراءِ التخطئة والرميِ بالشذوذ والانحراف المنهجيِّ الطعنَ في أهل السُّنَّةِ والتهوينَ مِنْ قدرِهم والغضَّ مِنْ مَقامِهم والوقيعةَ في أعراضهم لتنفير الناس عنهم فهذا سبيلُ أهلِ البِدَع والأهواء في زرع الفتنة ونشرِ الخبث والضرر، وإماتةِ الحقِّ والسُّنَّةِ وإضعافِ الدعوة إلى الله وتضييقِ سَبيلِها، فهؤلاء نَكِلُ أَمْرَهم إلى الله، واللهُ بصيرٌ بالعباد.
وأقول في ـ هذا المَقام ـ ما قاله ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وأنا في سَعَةِ صدرٍ لمَنْ يخالفني، فإنه ـ وإِنْ تعدَّى حدود الله فيَّ بتكفيرٍ أو تفسيقٍ أو افتراءٍ أو عصبيَّةٍ جاهليَّةٍ ـ فأنا لا أتعدَّى حدودَ الله فيه، بل أَضبِطُ ما أقوله وأفعله، وأَزِنُه بميزان العدل، وأَجعلُه مُؤتَمًّا بالكتاب الذي أَنزلَه اللهُ وجَعَله هُدًى للناس حاكمًا فيما اختلفوا فيه؛ قال الله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] الْآيَةَ، وقال تعالى: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [الحديد: ٢٥]، وذلك أنك ما جَزَيْتَ مَنْ عصى اللهَ فيك بمِثلِ أَنْ تُطيعَ اللهَ فيه»(٣٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(١) الحديث صَحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٤/ ٣٩٨)، وحسين أسد مُحقِّق «مسند أبي يعلى» (١٣/ ٣٧٣).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «بدء الخَلْق» بابُ صفة النار وأنَّها مخلوقة (٣٢٦٧)، ومسلمٌ في «الزهد والرقائق» (٢٩٨٩).
(٣) التَّعريضُ في الكلام هو ما يَفهمُ به السَّامعُ مرادَ المتكلِّم مِنْ غيرِ تصريحٍ، ويدلُّ على المعنى مِنْ جهة التَّلويحِ والإشارةِ. [انظر: «التعريفات» للجرجاني (٦٢)، «الكُلِّيَّات» لأبي البقاء (٧٦٣)].
(٤) التلميح: هو أَنْ يشار في فحوى الكلام إلى قصَّةٍ أو شعرٍ مِنْ غيرِ أَنْ تُذكَر صريحًا. [انظر: «التعريفات» للجرجاني (٦٦)، «الكُلِّيَّات» لأبي البقاء (٣٠١ ـ ٣٠٢)].
(٥) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» بابُ بيانِ كون النهي عن المُنْكَرِ مِنَ الإيمان (٤٩)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.
(٦) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» بابُ بيانِ أنَّ الدِّين النصيحةُ (٥٥)، مِنْ حديثِ تميم بنِ أوسٍ الداريِّ رضي الله عنه.
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١] (٨٦٤).
(٨) «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١٥٢).
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٧٤).
(١٠) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٣٧٣٠٧)، والبيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٧١٨٥، ٧١٨٦)، وابنُ عبدِ البَرِّ في «التمهيد» (٢٣/ ٢٨٢)، وابنُ المُقرِئ في «مُعجَمه» (١٢٣٠)، عن سعيد بنِ جُبَيرٍ.
(١١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» باب الصرف وبيعِ الذهب بالوَرِق نقدًا (١٥٨٧).
(١٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» باب: كيف يبايع الإمامُ الناسَ؟ (٧١٩٩)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٧٠٩).
(١٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٣٣٩)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثيرٍ في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٢) طبعة دار طيبة للنشر.
(١٤) انظر: «شرح مسلم» للسيوطي (٦/ ٢٩٥).
(١٧) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١١٠).
(١٨) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين مِنَ التمر والشعير (٩٨٥).
(١٩) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ بعثِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة (٤٣٣٩)، وفي «الأحكام» (٧١٨٩) باب: إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ أو خلاف أهلِ العلم فهو رَدٌّ.
(٢٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» باب الصلاة بمِنًى (١٠٨٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» بابُ قصرِ الصلاة بمِنًى (٦٩٥).
(٢١) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٤، ٦/ ٣٨٨).
(٢٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ، وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» باب جواز التمتُّع (١٢٢٣).
(٢٣) أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» باب: لا يعذَّب بعذاب الله (٣٠١٧)، واللفظُ للترمذيِّ في «الحدود» بابُ ما جاء في المرتدِّ (١٤٥٨).
(٢٤) أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» (٥٦٨٥) باب الدواء بألبان الإبل.
(٢٥) أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٧﴾ [الأحقاف]، (٤٨٢٧).
(٢٦) فَضَضٌ: أي: قطعةٌ وطائفةٌ منها، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٤)].
(٢٧) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٨٣)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرِجاه»؛ وقال الذهبيُّ في «التلخيص»: «فيه انقطاعٌ»؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٧٢٢) عند الحديث رقم: (٣٢٤٠).
(٢٨) سُئِل ـ رحمه الله ـ: ما ضابط الإنكار مِنْ حيث الإسرارُ والجهرُ به، وإذا لم يُجْدِ الإسرارُ فهل يُجهَر بالإنكار؟ وهل هنالك فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجِّه قصَّةَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ مع الخليفة [كذا والصواب: الأمير؛ فإنَّ المقصودَ هو مروانُ وكان يومَئذٍ أميرَ المدينة لا خليفةً] في تقديم الخُطبة على الصلاة، وقصَّةَ سلمان مع عمر في قصَّةِ القميص، وغيرَها مِنَ الوقائع؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ: «الأصل أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النجاح، فقَدْ ينجح في مسألةٍ مع أميرٍ ولا ينجح مع الأمير الثاني، فالمسلم الناصح يتحرَّى الأمورَ التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهرُه بالنصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصلاة، فهذا لا بأسَ لأنه يفوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويخشى أنه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ، فإذا كان في مكانٍ أو في بلدٍ مع أيِّ شخصٍ، ويظهر له ويرتاح إلى أنَّ الأصلحَ مُباشَرةُ الإنكار باللسان والجهر معه فلْيَفعل ذلك ويتحرَّى الأصلحَ؛ لأنَّ الناس يختلفون في هذه المسائل: فإذا رأى المصلحةَ ألَّا يجهر، وأَنْ يتَّصِل به كتابةً أو مشافهةً فَعَل ذلك؛ لأنَّ هذه الأمورَ تختلف بحسَبِ أحوال الناس؛ وكذلك الشخص المُعين يحرص على السَّتر مهما أَمكنَ، ويزوره، أو يكاتبه، وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنه إذا جَهَر قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنه ينفع فيه هذا الشيء فيفعل الأصلحَ، فالناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حرمةٌ إذا جَهَر به بين الناس، فليس لمجاهر الفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ» [دروس للشيخ عبد العزيز بن باز (٩/ ١٧)].
(٢٩) قال ـ رحمه الله ـ: «فإذا الحاكم خالف الشريعةَ علنًا فالإنكار عليه علنًا لا مخالفةَ للشرع في ذلك، لأنَّ هؤلاء الذين يسمعون الإنكارَ [يعني: المنكر] مِنَ الحاكم ـ وإنكاره مُنكَرٌ ـ يدخل في قلوبهم فيما إذا لم يُنكَرِ المُنكَر مِنَ العالم على ذلك الحاكم؛ فهذا وجهُ حديثِ أبي سعيدٍ، لكنَّ هذا لا يناقض القاعدةَ التي جاء ذِكرُها في الرسالة» [مِنْ درسٍ صوتيٍّ منشور على الشبكة العنكبوتيَّة].
(٣٠) قال ـ رحمه الله ـ: «كذلك ـ أيضًا ـ في مسألةِ مناصحة الوُلَاة: مِنَ الناس مَنْ يريد أَنْ يأخذ بجانبٍ مِنَ النصوص وهو إعلانُ النكير على وُلَاة الأمور مهما تَمخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَنْ نناصح ولاةَ الأمور سِرًّا كما جاء في النصِّ الذي ذَكَره السائل، ونحن نقول: النصوص لا يكذِّب بعضُها بعضًا، ولا يصادم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا متى؟ عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشرُّ ولا يحلُّ به الخير». [«لقاء الباب المفتوح» (٦٢/ ١٠)].
(٣١) قال ـ رحمه الله ـ: «مسألة الخروج عليهم: فما داموا مسلمين لا يُخرَج عليهم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ وأمَّا الانكار عليهم فلا بأسَ بذلك، مع إعلام المسلمين أنك لستَ داعِيَ ثورةٍ، ولا داعِيَ انقلاباتٍ، ولكِنْ تدعو إلى تغيير هذا المُنكَر» [من شريط: «أسئلة بني قيس بحاشد»].
(٣٢) قال ـ رحمه الله ـ: «فأنا أرى إن كان هذا الأمرُ الذي سيُنصح به أمرًا ظاهرًا ومعلَنًا وواضحًا، فالمُنكرُ المُعلنُ الواضحُ الظَّاهرُ أرى أنَّه لا حرج في أن يناصَح الحاكم من مواجهةٍ أو مِن عمودِ صحيفةٍ أو مِن مِنبرٍ أو بأيِّ أسلوبٍ من الأساليب، إذا كان المنكر واضحًا وواقعًا في الناس وعلنيًّا، فالقاعدة السَّليمةُ أنَّ ما يُنكَرُ إذا كان علنًا عُولج ونُصِح به علنًا» [«شريط وصايا للدعاة: الجزء الثاني» للشيخ عبد الله بن حسن القعود].
(٣٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٢٤٦).
- قرئت 263633 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)