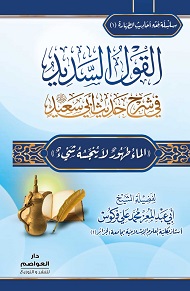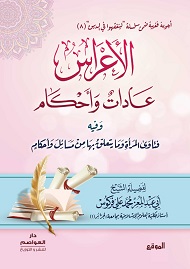العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
«التصفيف الرابع والثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (٥)»
الثَّالِثُ وَالخَمْسُونَ: العَبْدُ لاَ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ
وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَى فِي رُبُوبِيَّتِهِ: اعْتِقَادُ أَنَّ العَبْدَ لاَ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ، فَهُوَ كَمَا لَمْ(١) يَخْلُقْ ذَاتَهُ وَلَمْ يَخْلُقْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُقْ أَفْعَالَهُ، فَهُوَ كُلُّهُ مَخْلُوقٌ للهِ: ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ(٢)، غَيْرَ أَنَّ(٣) لَهُ مُبَاشَرَةً لِأَفْعَالِهِ بِاخْتِيَارِهِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ أَعْمَالاً وَكَانَ مَسْؤُولاً عَنْهَا وَمُجَازًى عَلَيْهَا، وَتِلْكَ المُبَاشَرَةُ هِيَ كَسْبُهُ وَاكْتِسَابُهُ(٤).
فَيُسَمَّى العَبْدُ عَامِلاً وَكَاسِبًا وَمُكْتَسِبًا(٥)، وَلاَ يُسَمَّى خَالِقًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ﴾(٦)، ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾(٧)، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾(٨).
(١) وفي نسخة محمَّد صالح رمضان [م. ر]: «ما لم»، وهو تصحيفٌ.
(٢) أفعال العباد قسمان:
- أفعالٌ اضطراريةٌ لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة له مِن نفسه على التحكُّم فيها مثل: نبضات القلب والعروق وحركات المرتعش ونحو ذلك، فهذا القسم من الأفعال لم تختلف فيه المذاهب العقدية في أنه مخلوقٌ لله قولاً واحدًا، ذلك لأنَّ الحركاتِ الاضطراريةَ ليست فعلاً مختارًا للعبد وإنما هي صفةٌ له، فالفاعل هو مَن حصل منه الحدث وقام به، فمن ارتعشت يدُه أو اخترمه الموتُ أو وقع عليه المرضُ فإنَّ الحدث في هذه الصور ليس مِن فعل العبد باختياره ولا هو مَن قام به، وإنما هو وصفٌ قام بالعبد، ولهذا لا يتعلَّق التكليف بالأفعال الاضطرارية، ولا يترتَّب عليها أصلاً ثوابٌ ولا عقابٌ.
- أفعالٌ اختياريةٌ تحصل بإرادة المكلَّف واختياره، له سلطةٌ وقدرةٌ على التحكُّم فيها، سواءٌ كانت من أعمال البرِّ والطاعة أو من المعاصي بمختلف أنواعها.
فالأفعال الاختيارية هي التي يتعلَّق بها التكليفُ والثواب والعقاب.
وأهل المذاهب العقدية اختلفوا في هذا القسم الأخير مِن جهةِ: خلق الأفعال الاختيارية للعبد، ومِن جهةِ: أثر قدرة المكلَّف في الفعل على أربعة أقوالٍ.
والمصنِّف -رحمه الله- -من جهةِ: خلق الأفعال الاختيارية للعبد- يقرِّر مذهبَ أهل السنَّة والجماعة، وهو أنَّ مِن مقتضى توحيد الله في ربوبيته والإيمان بالقدر: اعتقادَ أنَّ أفعال العباد كلَّها: حركاتِهم وأصواتَهم وكتاباتِهم واكتسابَهم، سواءٌ كانت خيرًا أو شرًّا، طاعةً أو معصيةً، ليست مخلوقةً للعبد، وإنما هي مخلوقةٌ لله تعالى ومقدَّرةٌ على العباد ومقضيَّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم، أي: كتبها الله عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم [انظر: «شرح السنَّة» للبغوي (١/ ١٤٢)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٦٣، ١١٧)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٣)، «الحجَّة في بيان المحجَّة» للأصفهاني (١/ ٤٥٧، ٢/ ٤٤٣)] لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافَّات: ٩٥-٩٦]، فإنَّ «ما» موصولةٌ، أي: والله خلقكم وخلق آلهتَكم التي عملتموها بأيديكم، فأخبر أنه خلق معمولَهم، وقد حلَّه عملُهم وصنعُهم، فالآية تدلُّ على أنَّ المنحوت مخلوقٌ لله تعالى، وما صار منحوتًا إلاَّ بفعلهم، فيكون ما هو مِن آثار فعلهم مخلوقًا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له، بل الخشب أو الحجر لا غير، وهي موادُّ غير معمولةٍ لهم، وإنما يصير معمولاً بعد عملهم [انظر: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ٢٠٦)، «شرح الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٦)].
والأدلَّة كثيرةٌ ومتضافرةٌ من الكتاب والسنَّة على أنَّ الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد، ولا يخرج شيءٌ عن عموم الخلق، قال البيهقيُّ -رحمه الله- في [«الاعتقاد» (٧٣)] مفصحًا عن مذهب السلف أهلِ السنَّة والجماعة: «قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [غافر: ٦٢]، فدخل فيه الأعيانُ والأفعال مِن الخير والشرِّ، وقال: ﴿أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، فنفى أن يكون خالقٌ غيره، ونفى أن يكون شيءٌ سواه غيرَ مخلوقٍ، فلو كانت الأفعال غيرَ مخلوقةٍ لكان الله سبحانه خالقَ بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الآية. ومعلومٌ أنَّ الأفعال أكثرُ من الأعيان، فلو كان الله خالقَ الأعيان والناسُ خالقي الأفعال لكان خلقُ الناس أكثرَ مِن خلقه ولكانوا أتمَّ قوَّةً منه وأَوْلى بصفة المدح من ربِّهم سبحانه، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافَّات: ٩٦]، فأخبر أنَّ أعمالهم مخلوقةٌ لله عزَّ وجلَّ» [انظر: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ٣٣٣)].
ومن السنَّة: حديثُ حذيفة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «إِنَّ اللهَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ»، وفي بعض الروايات: «إِنَّ اللهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ» قال البخاري: وتلا بعضُهم عند ذلك: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافَّات: ٩٦] فأخبر أنَّ الصناعاتِ وأهلَها مخلوقةٌ [أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣١)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص٧٥)، وابن أبي عاصم في «السنَّة» (ص١٥٨)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٣٧) و«ظلال الجنَّة» (٣٥٧)].
والحديث دلَّ أنَّ الله خالقٌ للصناعة وأهلها، ويؤيِّده قولُ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ فَخَلَقَ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، وَخَلَقَ أَهْلَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ» [أخرجه الدارمي في «الردِّ على الجهمية» (١٤٤)، والفريابي في «القدر» (٦٥)، والآجرِّي في «الشريعة» (٢/ ٨٣٩)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٤/ ٧٣٠)].
وفيما قرَّره أهل السنَّة والجماعة ردٌّ صريحٌ على معتقد القدرية والمعتزلة الذين يذهبون إلى القول بأنَّ العبد هو الخالق لفعله، الموجِد له بمشيئته الكاملة وقدرته التامَّة، وأنَّ مشيئته وقدرته مستقلَّةٌ عن إرادة الله وقدرتِه غيرُ تابعةٍ لهما، بمعنى أنَّ العباد خالقون لأفعالهم وأنها ليست مخلوقةً لله ولم يقدِّرها عليهم، بل هم مُحْدِثون لها [انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبَّار (٨/ ٣)، «مقالات الإسلاميِّين» للأشعري (١/ ٢٧٣)، «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ١٩٨)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٣)].
ولا يخفى ضلال القدرية والمعتزلة بمقالاتهم هذه، وذلك بجعل الأفعال مِن إنتاج العبد وإرادته المطلقة على وجه الإيجاد والاختراع لها بقدرته التامَّة، فإنه يَلزم مِن قولهم أنَّ الله عاجزٌ لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد إذ لا تدخل أفعالُه تحت قدرته، وأنه سبحانه يشاركه غيرُه في الإيجاد والخلق، ولهذا كان «القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ» كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [أخرجه أبو داود في «السنَّة» (٥/ ٦٦) بابٌ في القدر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٤٦٩١) وفي «ظلال الجنَّة» (٣٢٨، ٣٢٩)].
بل هم «أردأ من المجوس، من حيث إنَّ المجوس أثبتوا خالقَيْن، وهم أثبتوا خالقِين» [«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٣)]، ومِن أقوى شُبَههم على أنَّ العبد خالقٌ لفعل نفسه ومُوجِدٌ له قولُه تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، حيث إنَّ الله أثبت تعدُّد الخالقين وهو سبحانه أحسنُهم، فدلَّ ذلك على أنَّ العبد مُوجِدٌ لفعله مخترعٌ له بقدرته وإرداته.
ولا شكَّ أن هذه الشبهة متهافتةٌ لأنَّ معنى الآية: أحسن المصوِّرين المقدِّرين، إذ الخلق يُطلق على معنيين: الأوَّل: الإيجاد والإبداع، وقد يُطلق ويراد به التقدير وهو المعنى الثاني المراد بالآية بدليل قوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢]، أي: الله خالق كلِّ شيءٍ مخلوقٍ، فدخلت أفعال العباد في عموم «كلِّ» [«شرح الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٦)].
وممَّا يؤكِّد ذلك مِن كلام العرب ما ذكره الأزهريُّ -رحمه الله- في [«تهذيب اللغة» (٧/ ١٦)] بقوله: «والخلق في كلام العرب: ابتداعُ الشيء على مثالٍ لم يُسبق إليه.
وقال أبو بكر بنُ الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: أحدهما: الإنشاء على مثالٍ أبدعه، والآخر: التقدير.
وقال في قول الله جلَّ وعزَّ: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، معناه: أحسن المقدِّرين، وكذلك قوله: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧] أي: تقدِّرون كذبًا.
قلت [أي الأزهري]: والعرب تقول: خلقتَ الأديمَ إذا قدَّرتَه وقِسْتَه لتقطعَ منه مزادةً أو قِربةً أو خفًّا.
وقال زهيرٌ:
«وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْــــضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْرِي»
يمدح رجلاً فيقول له: أنت إذا قدَّرتَ أمرًا قطعتَه وأمضيتَه، وغيرك يقدِّر ما لا يقطعه، لأنه غير ماضي العزم، وأنت مضاءٌ على ما عزمتَ عليه»
وممَّا يدلُّ على فساد قول القدرية والمعتزلة وتناقُضِه إدخالُهم كلامَ الله الذي هو صفةٌ من صفاته في عموم قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢] فزعموا أنه مخلوقٌ، وأخرجوا مِن عموم الخلق ما هو جديرٌ أن يدخل فيه وهي أفعال العباد فزعموا أنها غير مخلوقةٍ.
هذا، وما تقتضيه النصوص الشرعية المخبرة عن ربوبية الله وقدرته وما يُمليه فرضُ الإيمان بالقدر: وجوبُ اعتقادِ أنَّ أفعال الخلق خيرَها وشرَّها مخلوقةٌ لله تعالى ومقدَّرةٌ على العباد، ومقضيَّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم، أمَّا كلام الله تعالى فهو صفةٌ من صفاته، وصفاتُ الله فرعٌ عن ذاته، فلا ينبغي أن يقال إنها مخلوقةٌ.
ومن الأدلَّة الأخرى على خلق أعمال العباد قولُه تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: ٨١]، قال ابن القيِّم -رحمه الله- في [«شفاء العليل» (١/ ٢٠٦)]: «فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل -وهي الدروع والثياب المصنوعة- ومادَّتها لا تسمَّى سرابيلَ إلاَّ بعد أن تحلَّها صنعةُ الآدميِّين وعملُهم، فإذا كانت مجعولةً لله فهي مخلوقةٌ له بجملتها: صورتُها ومادَّتها وهيئاتها، ونظير هذا قوله: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ [النحل: ٨٠]، فأخبر سبحانه أنَّ البيوت المصنوعة المستقرَّة والمتنقِّلة مجعولةٌ له، وهي إنما صارت بيوتًا بالصنعة الآدمية، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [يس: ٤١-٤٢]، فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق الفلك المصنوع للعباد».
(٣) وفي نسخة [م. ر]: «أنه».
(٤) والمصنِّف -رحمه الله- بعد تقريره لمذهب السلف مِن جهةِ خلق الله للأفعال الاختيارية للعبد يقرِّر مذهبَهم -أيضًا- من جهة أثر قدرة العبد في الفعل، وهو أنَّ العبد -مؤمنًا كان أو كافرًا، برًّا أو فاجرًا- غيرُ مسلوب الإرادة والمشيئة، بل هو فاعلٌ حقيقةً وأفعاله مخلوقةٌ لله، وله مباشَرةٌ لأفعاله بإرادته ومشيئته واختياره، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وأثبت الله تعالى العملَ والفعل للمكلَّف في آياتٍ عديدةٍ منها قولُه تعالى: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١].
وقد يضاف العمل إلى الإنسان الفرد المخاطَب إضافةَ ملكيةٍ كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقد يضاف العمل إلى الجماعة كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقوله تعالى: ﴿اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ [الشورى: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فدلَّت هذه الآيات على أنَّ العبد فاعلٌ على الحقيقة، وأنَّ له مشيئةً واختيارًا على فعله بعد مشيئة الله تعالى.
ويؤكِّد ذلك -أيضًا- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، فأضاف الله سبحانه عملَ الخير والشرِّ إلى العبد على الحقيقة، فدلَّ على أنه مِن كسبه وعمله الذي يجازى به، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فأثبت الله تعالى للعبد عملاً وكسبًا وهو مِن فعله حقيقةً، إذ الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفعٌ أو ضررٌ [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٥٠٢)].
وفيما قرَّره أهل السنَّة ردٌّ صريحٌ -أيضًا- على مقالة الجبرية والجهمية الذين سلبوا عن العبد الاختيارَ والقدرة على فعله وعمله، ونفَوْا عنه المشيئةَ والإرادة، وزعموا أنَّ العباد مجبورون على أفعالهم مقهورون على أعمالهم لا تأثير لهم في وجودها ألبتَّةَ، وسوَّوْا بين الحركات الاختيارية والاضطرارية، فهي حركاتٌ بمثابة حركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهبِّ الريح، وإنما تضاف الأفعال إلى العباد في معتقدهم مجازًا من باب إضافة الشيء إلى محلِّه دون ما يضاف إلى محصِّله، كما يقال: زالت الشمس، ودارت الرحى، وسال الوادي [انظر: «الفَرْق بين الفِرَق» للبغدادي (١٩٩)، «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ١٩٤)، «شرح الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٣)].
ولهم في ذلك شبهاتٌ ضعيفةٌ مِن أهمِّها: قولُه تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٤]، فالآيتان تدلاَّن عندهم أنه لا عمل للعبد ولا صنع، لأنَّ الله نفى القتلَ والرمي والزرع وأثبته لنفسه سبحانه، وإنما أضيفت هذه الأفعال إلى العبد مجازًا لا على وجه الحقيقة.
كما استدلُّوا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» قَالُوا: «وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ» [أخرجه البخاري في «الرقاق» (١١/ ٢٩٧) باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم في «صفة القيامة» باب لن يدخل أحدٌ الجنَّةَ بعمله بل برحمة الله تعالى (١٧/ ١٦٠)، وأحمد في «مسنده» (١٢/ ٤٤٩) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].
فدلَّ الحديث على أنَّ العبد مسلوب الفعل ولا عمل له ولا إرادة، لأنَّ الحديث أفصح عن أنَّ الجزاء غيرُ مرتَّبٍ على الأعمال.
وأجيب عن شبهة الجبرية والجهمية بأنها حجَّةٌ عليهم، ذلك لأنَّ الآية في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى﴾ نزلت في شأن رميه صلَّى الله عليه وسلَّم المشركين يوم بدرٍ من الحصباء، فما مِن المشركين أحدٌ إلاَّ أصاب عينيه ومنخريه وفمَه ترابٌ من تلك القبضة فولَّوْا مُدبرين [انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٩٥)]، والله تعالى أثبت لنبيِّه رميًا بقوله: ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾، ولا يخفى أنَّ تلك الرمية مِن البشر لا تبلغ هذا المبلغَ، فتبيَّن أنَّ المُثْبَت في الآية غير المنفيِّ، وذلك لأنَّ الرمي له ابتداءٌ وانتهاءٌ، فمبدأ الرمي كان من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو الحذف، وأمَّا انتهاؤه فكان مِن الله تعالى بالإيصال والإصابة، وكلٌّ منهما يسمَّى رميًا، فالذي أضافه الله إلى نبيِّه إنما هو رمي الحذف الذي هو مبدؤه، وإنما نفى عنه رميَ الإصابة والإيصال الذي هو نهايته، فكان المعنى إذن: «وما أصبتَ إذ حذفتَ ولكنَّ الله أوصل وأصاب» [انظر: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ٢١٧)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٥)].
هذا، وفي ردِّ قولهم قال ابن القيِّم -رحمه الله- في [«مدارج السالكين» (٣/ ٤٢٦)]: «فلو صحَّ ذلك لَوجب طردُه في جميع الأعمال، فيقال: ما صلَّيتَ إذ صليتَ، وما صُمْتَ إذ صُمْتَ، وما ضحَّيتَ إذ ضحَّيتَ، ولا فعلتَ كلَّ فعلٍ إذ فعلتَه، ولكنَّ الله فعل ذلك، فإن طردوا ذلك لَزِمَهم في جميع أفعال العباد -طاعتِهم ومعاصيهم- إذ لا فَرْقَ»، ويتابع ابن القيِّم -رحمه الله- بيانَ بطلان هذا القول وفسادِه بقوله: «ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٧] ثمَّ قال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] فأخبره: أنه وحده هو الذي تفرَّد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم، كما تفرَّد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك من رسوله ولكنَّ وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابًا ظاهرةً لدفع المشركين، وتولَّى دَفْعَهم وإهلاكهم بأسبابٍ باطنةٍ غيرِ الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافًا إليه وبه، وهو خير الناصرين».
وأمَّا قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٤]، فإنَّ المراد بالزرع هو الإنبات، أي: إخراج السنبل من الحبِّ، وهذا ليس للبشر قدرةٌ عليه ولا يتمُّ باختيارهم، وإنما مِن فعلهم شقُّ الأرض والبذر، فكان ذلك دليلاً على إضافة فعل الحرث إليهم حقيقةً دون الإنبات، قال القرطبيُّ في [«تفسيره» (١٧/ ٢١٧)]: «وأضاف الحرثَ إليهم والزرعَ إليه تعالى، لأنَّ الحرث فعلُهم ويجري على اختيارهم، والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختيارهم» [انظر أيضًا: «الاعتقاد» للبيهقي (٧٤)].
وأمَّا ترتُّب الجزاء على الأعمال ففيه -أيضًا- ضلَّت الجبرية والقدرية، ذلك لأنَّ الباء التي في الإثبات في قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧، الأحقاف: ١٤، الواقعة: ٢٤] هي باء السببية، أي: بسبب عملهم، والباء التي في النفي في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» فهي باء العوض، أي: نفي أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنَّة، وإنما هو برحمة الله وفضله، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسبَّبات، فرجع الكلُّ إلى محض فضل الله ورحمته، ويزيد ابن القيِّم -رحمه الله- المسألةَ إيضاحًا في بيان أنَّ الباء التي في النفي غيرُ الباء التي في الإثبات فيقول -رحمه الله- في [«مفتاح دار السعادة» (١/ ١٢٠)]: «الباء المقتضية للدخول غيرُ الباء التي نُفِي معها الدخولُ، فالمقتضية هي باء السببية الدالَّةُ على أنَّ الاعمال سببٌ للدخول مقتضيةٌ له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبَّباتها، والباء التي نُفِي بها الدخولُ هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا، فأخبر النبيُّ أنَّ دخول الجنَّة ليس في مقابلة عملِ أحدٍ وأنه لولا تغمُّد الله سبحانه لعبده برحمته لَما أدخله الجنَّةَ، فليس عمل العبد وإن تناهى موجِبًا بمجرَّده لدخول الجنَّة ولا عوضًا لها، فإنَّ أعماله -وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبُّه الله ويرضاه- فهي لا تقاوم نعمةَ الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعمالُه كلُّها في مقابلة اليسير مِن نِعَمِه وتبقى بقيَّة النعم مقتضيةً لشكرها، فلو عذَّبه في هذه الحالة لعذَّبه وهو غير ظالمٍ له، ولو رحمه لكانت رحمتُه خيرًا له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابتٍ وحذيفة وغيرهما مرفوعًا إلى النبيِّ أنه قال: «إِنَّ اللهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ» [أخرجه أبو داود في «السنَّة» (٥/ ٧٥) بابٌ في القدر، وابن ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٢٩) بابٌ في القدر، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١٤٧)] [انظر هذه المسألة في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٧٠)، «المحجَّة» لابن رجب (٢٦)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٩٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢٩٦)].
وفيه توجيهٌ آخر وهو: أنَّ دخول الجنَّة يكون بفضل الله ورحمته، غير أنَّ المنازل تُقْتَسم بحسب الأعمال، قال سفيان بن عيينة وغيره: «كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله، ودخولُ الجنَّة برحمته، واقتسامُ المنازل والدرجاتِ بالأعمال» [انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية (١/ ١٥١)، «حادي الأرواح» لابن القيِّم (٨٨)، «المحجَّة» لابن رجب (٢٧)].
فالحاصل أنَّ القدرية والجبرية على طرفي نقيضٍ، وكلاهما مصيبٌ فيما أثبته دون ما نفاه، قال ابن أبي العزِّ في [«شرح العقيدة الطحاوية» (٤٩٤)]: «فكلُّ دليلٍ صحيحٍ يقيمه الجبريُّ فإنما يدلُّ على أنَّ الله خالق كلِّ شيءٍ، وأنه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّ أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدلُّ على أنَّ العبد ليس بفاعلٍ في الحقيقة ولا مُريدٍ ولا مختارٍ، وأنَّ حركاتِه الاختياريةَ بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار، وكلُّ دليلٍ صحيحٍ يقيمه القدريُّ فإنما يدلُّ على أنَّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقةً، وأنه مريدٌ له مختارٌ له حقيقةً، وأنَّ إضافته ونسبته إليه إضافةُ حقٍّ، ولا يدلُّ على أنه غيرُ مقدورٍ لله تعالى، وأنه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته، فإذا ضممتَ ما مع كلِّ طائفةٍ منهما من الحقِّ إلى حقِّ الأخرى فإنما يدلُّ ذلك على ما دلَّ عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأنَّ العباد فاعلون لأفعالهم حقيقةً، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذمَّ» [انظر أيضًا: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ١٩٩)].
هذا، وقريبٌ من قول الجبرية قولُ الأشاعرة الذين يثبتون أنَّ أفعال العبد مخلوقةٌ لله تعالى، وهي مع كونها خَلْقَ اللهِ فهي من كسب العبد، غير أنَّ أفعال العبد واقعةٌ عندهم بقدرة الله وحدها، وللعبد قدرةٌ لا تأثير لها فيها، أي: أنَّ العبد كاسبٌ وليس بفاعلٍ حقيقةً، والفعل يوجد عند القدرة لا بها، وإنما فاعلُ فعلِ العبد هو الله تعالى، وعملُ العبد ليس فعلاً للعبد، بل هو كسبٌ له، وإنما هو مِن فعل الله فقط، والخالق قَرَن القدرةَ في المقدور بمجرَّد الاقتران العاديِّ لا لسببٍ ولا لحكمةٍ أصلاً.
والذي جرَّ الأشاعرة إلى تعطيل تأثير القدرة الحادثة في الفعل هو: اعتقادهم بأنَّ الأفعال ذواتٌ، ولا يقدر على الذوات إلاَّ الله، الأمر الذي دَفَعهم إلى عدم التفريق بين الخلق والفعل، ويقولون: إنَّ الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول، فنسبوا الخلقَ والفعل لله تعالى، لأنَّ الفعل عندهم هو المفعول، فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد، لئلاَّ يكون فعلٌ واحدٌ له فاعلان، لذلك لم ينسبوا للعبد إلا كسبًا لا يُعقل.
ولا يخفى أنَّ إثبات قدرةٍ لا أثر لها في الفعل فهو -في حقيقة الأمر- نفيٌ للقدرة أصلاً، فوجودها وعدمها سواءٌ، كما أنَّ المتقرِّر عند جماهير المسلمين أنَّ الأفعال صفاتٌ وأحوالٌ وليست ذواتٍ [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ١٢٨، ٤٦٧)، «إيثار الحقِّ على الخلق» لابن الوزير (٣١٧)].
وقد استنكر العلماء وكذا أعلام المذهب الأشعريِّ كالباقلاَّنيِّ والجوينيِّ وغيرهما الكسبَ الذي قال به الأشاعرة، وعدُّوه قولاً متناقضًا غيرَ مسلَّمٍ، إذ لا يُعقل فرقٌ بين الفعل الذي نَفَوْه والكسبِ الذي أثبتوه، وقولهم في الكسب -عند التحقيق- لا يخرج عن مقالة الجهمية والجبرية، لذلك قال ابن تيمية -رحمه الله- في [«النبوَّات» (١/ ٤٦١)] في مَعْرِض بيان الكسب عند الأشاعرة: «وهم لا يقولون به، بل قدرة العبد عندهم لا تتعلَّق إلاَّ بفعلٍ في محلِّها، مع أنها عند شيخهم غير مؤثِّرةٍ في المقدور، ولا يقول إنَّ العبد فاعلٌ في الحقيقة بل كاسبٌ، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقًا معقولاً، بل حقيقة قولهم قولُ جهمٍ: إنَّ العبد لا قدرة له ولا فِعْلَ ولا كَسْبَ، والله عندهم فاعلُ فعلِ العبد، وفعلُه هو نفس مفعوله؛ فصار الربُّ عندهم فاعلاً لكلِّ ما يُوجد من أفعال العباد، ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح، وأن يتَّصف بها على قولهم: إنه يُوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره».
وفي ردِّه -رحمه الله- على الأشاعرة الذين أثبتوا في المخلوقات والطبائع قوًى غيرَ مؤثِّرةٍ أضاف -رحمه الله- في [«مجموع الرسائل والمسائل» (٥/ ١٥٧)] قائلاً: «ومن قال: إنَّ قدرة العبد وغيرَها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقاتِ ليست أسبابًا، أو أنَّ وجودها كعدمها وليس هناك إلاَّ مجرَّد اقترانٍ عاديٍّ كاقتران الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه مِن الأسباب والحِكَم والعلل، ولم يجعل في العين قوَّةً تمتاز بها عن الخدِّ تُبصر بها، ولا في القلب قوَّةً يمتاز بها عن الرِّجل يعقل بها، ولا في النار قوَّةً تمتاز بها عن التراب تُحْرِق بها، وهؤلاء يُنكرون ما في الأجسام المطبوعة مِن الطبائع والغرائز، .. ثمَّ إنَّ هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز ورَوِي بالماء، بل يقول: شبعتُ عنده ورَوِيتُ عنده، فإنَّ الله يخلق الشِّبَعَ والرِّيَّ ونحو ذلك مِن الحوادث عند هذه المقترنات بها عادةً لا بها، وهذا خلاف الكتاب والسنَّة، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧] الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ١٦٤]».
هذا ويجدر التنبيه إلى ملاحظتين:
الأولى: لا يَلزم مِن وَصْفِ الله تعالى بالفعل ووَصْفِ المخلوق به -أيضًا- اشتراكُ الخالق والمخلوق في مسمَّى الفعل بأن يكون فعلُ الخالق كفعل المخلوق، بل فعلُ الله تعالى يخصُّه وفعلُ العبد يخصُّه، واتِّفاقهما في اسمٍ عامٍّ لا يقتضي تماثُلَهما في مسمَّى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره، وهذا يجري في مباحث الصفات التي وَصَف الله بها نَفْسَه ووصف بها خَلْقَه [انظر: «الرسالة التدمرية» لابن تيمية (٨ وما بعدها)].
الثانية: وجوب التفرقة بين فعل الله تعالى القائم بذاته كالرزق والإماتة والإحياء ونحو ذلك، وبين مفعولات الله تعالى التي هي أفعالٌ مخلوقةٌ لله تعالى منفصلةٌ عنه قائمةٌ بمحلِّها مباينةٌ له سبحانه كالأكل والشرب والطاعة والمعصية وغيرها، فإنَّ هذه الأفعال مخلوقةٌ ومقدَّرةٌ ومَقضيَّةٌ لله تعالى، ولا يَلْزَم من خلقه لها اتِّصافُه بها، وإنما يتَّصف بها من قامت به، ومن فعلها بقدرته واختياره وهو العبد.
ولذلك فرَّق جمهور أهل السنَّة المتَّبعون للسلف والأئمَّة بين الفعل والمفعول، ففعلُ العبد فعلٌ له على الحقيقة، ولكنَّه مخلوقٌ لله ومفعولٌ لله على الحقيقة، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، فأخبر الله تعالى أنه خالقُ العباد وأعمالِهم لا فاعلٌ لها، وإنما أضاف الفعلَ والعمل إلى العباد، ففعلُ العبد ليس هو نفسَ فعل الله لقيام الفرق بين الخلق والمخلوق، والفعلِ والمفعول، قال البخاري -رحمه الله- في [«خلق أفعال العباد» (١١٣)]: «وقال أهل العلم: التخليق فعلُ الله، وأفاعيلنا مخلوقةٌ لقوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٣-١٤]، يعني السرَّ والجهرَّ من القول، ففعلُ الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق».
وقد بيَّن ابن تيمية -رحمه الله- هذه المسألة في [«مجموع الفتاوى» (١٢٣)] بقوله: «وأمَّا من قال: خلقُ الربِّ تعالى لمخلوقاته ليس هو نفسَ مخلوقاته قال: إنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ كسائر المخلوقات ومفعولةٌ للربِّ كسائر المفعولات ولم يقل: إنها نفسُ فعل الربِّ وخلقِه، بل قال: إنها نفس فعل العبد، وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتَّصف بها مَن كانت فعلاً له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتَّصف بها من كانت مخلوقةً له إذا كان قد جعلها صفةً لغيره، كما أنه سبحانه لا يتَّصف بما خَلَقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك؛ فإذا كان قد خَلَق لونَ الإنسان لم يكن هو المتلوِّنَ به، وإذا خلق رائحةً منتنةً أو طعمًا مرًّا أو صورةً قبيحةً ونحو ذلك ممَّا هو مكروهٌ مذمومٌ مستقبَحٌ لم يكن هو متَّصفًا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة، ومعنى قبحها كونُها ضارَّةً لفاعلها، وسببًا لذمِّه وعقابه، وجالبةً لألمه وعذابه، وهذا أمرٌ يعود على الفاعل الذي قامت به، لا على الخالق الذي خَلَقها فعلاً لغيره».
ويزيد ابن القيِّم -رحمه الله- في بلورة المسألة في [«مفتاح دار السعادة» (٣/ ٨)] حيث يقول: «فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعةٌ في مفعولاته المنفصلة التي لا يتَّصف بها دون أفعاله القائمة به، ومن انكشف له لهذا المقامُ فَهِمَ معنى قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» [جزءٌ من حديث رواه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٦/ ٥٧-٦٠) باب صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودعائه في الليل من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه]، فهذا الفرق العظيم يزيل أكثرَ الشُّبَه التي حارت لها عقول كثيرٍ من الناس في هذا الباب، وهدى الله الذين آمنوا لِما اختلفوا فيه من الحقِّ بإذنه، والله يهدي من يشاء إلي صراطٍ مستقيمٍ، فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشرِّ فهو بالنسبة إلى فاعله المكلَّف الذي قام به الفعلُ، كما أنه بالنسبة إليه يكون زنًا وسرقةً وعدوانًا وأكلاً وشربًا ونكاحًا، فهو الزاني السارق الآكل الناكح، والله خالقُ كلِّ فاعلٍ وفعلِه وليست نسبةُ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به، كما أنَّ نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقِصَره وحُسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه، فتأمَّل هذا الموضعَ وأَعْطِ الفرقَ حَقَّه وفرِّقْ بين النسبتين، فكما أنَّ صفاتِ المخلوق ليست صفاتِ لله بوجهٍ وإن كان هو خالقَها فكذلك أفعالُه ليست أفعالاً لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها».
(٥) الكسب وقع في القرآن على ثلاثة معانٍ: أحدها: عقدُ القلب وعزمه كقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، والثاني: كسب المال من التجارة مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فالأوَّل: للتُّجَّار، والثاني: للزُّرَّاع، والمعنى الثالث: السعي والعمل كقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩، يونس: ٥٢]، وقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: ٧٠].
وعرَّف ابن تيمية -رحمه الله- الكسبَ في [«مجموع الفتاوى» (٨/ ٣٨٧)] بأنه «الفعل الذي يعود على فاعله بنفعٍ أو ضرٍّ»، وعرَّفه القرطبيُّ -رحمه الله- في [«تفسيره» (٥/ ٣٨٠)] بأنه «ما يجرُّ به الإنسان إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنه به ضررًا»، ثمَّ قال: «ولهذا لا يسمَّى فعلُ الربِّ تعالى كسبًا».
والعلماء يختلفون في الكسب والاكتساب: أهما بمعنًى واحدٍ -وهو ما عليه أهل اللغة، وصحَّحه أبو الحسن عليُّ بن أحمد الواحديُّ-، خلافًا لمن يرى أنَّ بينهما فرقًا، فالاكتساب أخصُّ مِن الكسب مِن جهةِ نفسه ولا يتناول غيرَه، بينما الكسب ينقسم إلى: كسبٍ لنفسه وكسبٍ لغيره.
وقد ذكر ابن القيِّم -رحمه الله- فرقًا دقيقًا وهو أنَّ الاكتساب يستدعي اهتمامًا واجتهادًا ومعاناةً، والعبد لم يُجعل عليه إلاَّ ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه وتعمُّله ومعاناته، وأمَّا الكسب فيحصل بأدنى شيءٍ كالملابسة حتى بالهمِّ بالحسنة ونحو ذلك، فخصَّ الشرَّ بالاكتساب والخيرَ بأعمَّ منه، ففي قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ -وهو جانب الفضل- جعل لها ما لها فيه أدنى سعيٍ، وفي قوله: ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ -وهو جانب العدل- لم يجعل عليها إلاَّ ما لها فيه اجتهادٌ واهتمامٌ [انظر: «شفاء العليل» (١/ ٣٦٤) و«بدائع الفوائد» (٢/ ٧٤) كلاهما لابن القيِّم].
(٦) جزءٌ من الآية ٣ من سورة فاطر.
(٧) جزءٌ من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
قال الشوكاني -رحمه الله- في [«فتح القدير» (١/ ٣٠٧)] شارحًا الآية: «فيه ترغيبٌ وترهيبٌ، أي: لها ثوابُ ما كسبت من الخير، وعليها وزرُ ما اكتسبت من الشرِّ، وتقدُّم «لها» و«عليها» على الفعلين ليفيد أنَّ ذلك لها لا لغيرها، وعليها لا على غيرها، وهذا مبنيٌّ على أنَّ: «كَسَب» للخير فقط، و«اكتسب» للشرِّ فقط، كما قاله صاحب «الكشَّاف» وغيرُه، وقيل: كلُّ واحدٍ من الفعلين يصدق على الأمرين، وإنما كرَّر الفعلَ وخالف بين التصريفين تحسينًا للنظم كما في قوله تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق: ١٧]».
(٨) الآيتان: ٧، ٨ من سورة الزلزلة.
والآيات السابقة التي استدلَّ بها المصنِّف -رحمه الله- تدلُّ على أنَّ مِن مقتضى توحيد الله تعالى في ربوبيته: اعتقادَ أنَّ الله خالقُ أفعال العبد، وأنه لا يخرج شيءٌ من عموم الخلق، وأنَّ العبد فاعلٌ حقيقةً أي: له مباشرةٌ لأفعاله باختياره، سواءٌ كانت خيرًا أو شرًّا، ولكنَّها مخلوقةٌ ومفعولةٌ لله تعالى، وليس هو نفسَ فعلِ الله، وإنما تلك المباشرة هي كسبُ العبد وعملُه الذي يُسأل عنه ويجازى به.
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 6636 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)