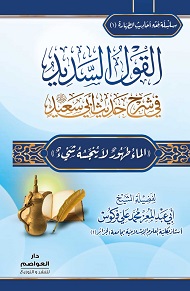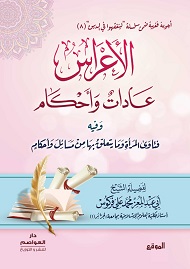البراءة من المشركين (٣)
﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ١ ـ ٦].
ومن أوجه البلاغة والبيان أيضًا:
المسألة السابعة: وهي ما هي الفائدة في قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، وهل أفاد هذا معنًى زائدًا على ما تقدَّم؟ فيقال في ذلك من الحكمة والله أعلم أنَّ النفي الأوَّلَ أفاد البراءة وأنه لا يُتصوَّر منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم، وهم أيضًا لا يكونون عابدين لمعبوده، وأفاد آخرُ السورة إثباتَ ما تضمَّنه النفيُ من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظُّهم وقسْمُهم ونصيبهم، فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضًا فقال له: «لا تدخل في حدِّي ولا أدخل في حدِّك، لك أرضك ولي أرضي». فتضمَّنت الآية أنَّ هذه البراءة اقتضت أنَّا اقتسمنا خطَّتَنا بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان فهو نصيبنا وقسْمُنا الذي نختصُّ به لا تشركونا فيه، وأصابكم الشرك بالله والكفر به فهو نصيبكم وقسْمُكم الذي تختصُّون به لا نشرككم به، فتبارك من أحيا قلوبَ من شاء من عباده بفهم كلامه. وهذه المعاني ونحوُها إذا تجلَّت للقلوب رافلةً في حُلَلِها فإنها تسبي القلوبَ وتأخذ بمجامعها، ومن لم يصادف من قلبه حياةً فهي خودٌ تُزَفُّ إلى ضريرٍ مقعدٍ، فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لها ونسأله إتمامَ نعمته.
المسألة الثامنة: وهي تقديم قسْمِهم ونصيبهم على قسْمِه ونصيبه وفي أوَّل السورة قدَّم ما يختصُّ به على ما يختصُّ بهم، فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلَّا فحول البلاغة وفرسانها، فإنَّ السورة لمَّا اقتضت البراءةَ واقتسامَ دينَيِ التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كلٌّ بقسْمِه وكان المحقُّ هو صاحبَ القسمة، وقد برَّز النصيبين وميَّز القسمين، وعلم أنهم راضون بقسْمِهم الدون الذي لا أردى منه، وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظِّ الأعظم، بمنزلة من اقتسم هو وغيره سمًّا وشفاءً فرضي مقاسمُه بالسمِّ، فإنه يقول له: «لا تشاركني في قسْمِي ولا أشاركك في قسْمِك، لك قسْمُك ولي قسْمِي»، فتقديم ذكر قسْمِه ههنا أحسن وأبلغ كأنه يقول: هذا هو قسْمُك الذي آثرته بالتقديم وزعمتَ أنه أشرف القسمين وأحقُّهما بالتقديم. فكان في تقديم ذكر قسْمِه من التهكُّم به، والنداءِ على سوء اختياره، وقبحِ ما رَضِيَه لنفسه، من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسْمِ نفسه، والحاكم في هذا هو الذوق، والفَطِنُ يكتفي بأدنى إشارةٍ، وأمَّا غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. ووجهٌ ثانٍ: وهو أنَّ مقصودَ السورة براءتُه صلَّى الله عليه وسلَّم من دينهم ومعبودهم، هذا هو لبُّها ومغزاها، وجاء ذكرُ براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكمِّلًا لبراءته، ومحقِّقًا لها، فلمَّا كان المقصود براءتَه من دينهم بدأ به في أوَّل السورة ثمَّ جاء قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ [الكافرون: ٦] مطابقًا لهذا المعنى أي: لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه، بل هو دينٌ تختصُّون أنتم به لا أشرككم فيه أبدًا. فطابق آخر السورة أوَّلَها فتأمَّلْه.
المسألة التاسعة: وهي أنَّ هذا الإخبار بأنَّ لهم دينَهم وله دينَه: هل هو إقرارٌ فيكون منسوخًا أو مخصوصاً، أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ فهذه مسألةٌ شريفةٌ ومن أهمِّ المسائل المذكورة، وقد غلط في السورة خلائق وظنُّوا أنها منسوخةٌ بآية السيف لاعتقادهم أنَّ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظنَّ آخرون أنها مخصوصةٌ بمن يُقَرُّون على دينهم وهم أهل الكتاب وكلا القولين غلطٌ محضٌ فلا نسخ في السورة ولا تخصيصَ، بل هي محكمةٌ عمومُها نصٌّ محفوظٌ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإنَّ أحكام التوحيد التي اتَّفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخولُ النسخ فيه، وهذه السورة أخلصت التوحيدَ، ولهذا تسمَّى سورةَ الإخلاص كما تقدَّم، ومنشأ الغلط ظنُّهم أنَّ الآية اقتضت إقرارَهم على دينهم، ثمَّ رأَوْا أنَّ هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا: منسوخٌ، وقالت طائفةٌ: زال عن بعض الكفَّار وهم مَن لا كتاب لهم، فقالوا: هذا مخصوصٌ. ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم أو إقرارًا على دينهم أبدًا، بل لم يَزَلْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أوَّل الأمر وأشدِّه عليه وعلى أصحابه أشدَّ على الإنكار عليهم، وعيبِ دينهم وتقبيحه، والنهي عنه والتهديد والوعيد كلَّ وقتٍ وفي كلِّ نادٍ، وقد سألوه أن يكفَّ عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنَه فأبى إلَّا مضيًّا على الإنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال: إنَّ الآية اقتضت تقريرَه لهم؟ معاذَ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما الآية اقتضت البراءةَ المحضة كما تقدَّم، وأنَّ ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدًا فإنه دينٌ باطلٌ، فهو مختصٌّ بكم لا نشرككم فيه، ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحقِّ، فهذا غاية البراءة والتنصُّلِ من موافقتهم في دينهم، فأين الإقرار حتى يُدَّعى النسخُ أو التخصيص؟ أفَتَرى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجَّة لا يصحُّ أن يقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾؟ بل هذه آيةٌ قائمةٌ محكمةٌ ثابتةٌ بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهِّر الله منهم عبادَه وبلادَه، وكذلك حكمُ هذه البراءة بين أتباع الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أهلِ سنَّته وبين أهل البدع المخالفين لِما جاء به، الداعين إلى غير سنَّته إذا قال لهم خلفاء الرسول ووَرَثَتُه: «لكم دينكم ولنا ديننا» لا يقتضي هذا إقرارَهم على بدعتهم، بل يقولون لهم: هذه براءةٌ منها، وهم مع هذا منتصبون للردِّ عليهم ولجهادهم بحسَب الإمكان، فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديعِ نظمها، من غير استعانةٍ بتفسيرٍ ولا تتبُّعٍ لهذه الكلمات من مظانَّ توجد فيه، بل هي استملاءٌ ممَّا علَّمه الله وألهمه بفضله وكرمه، والله يعلم أنِّي لو وجدتُها في كتابٍ لأضفتُها إلى قائلها ولبالغتُ في استحسانها، وعسى الله المانُّ بفضله الواسعُ العطاءِ الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب.
[«بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٢/ ١١٢)]
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 4455 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)