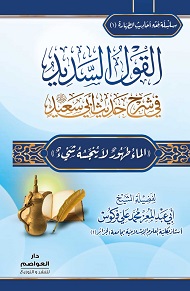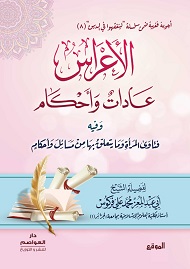الكلمةُ الشَّهريةُ رقمُ: ١٦١
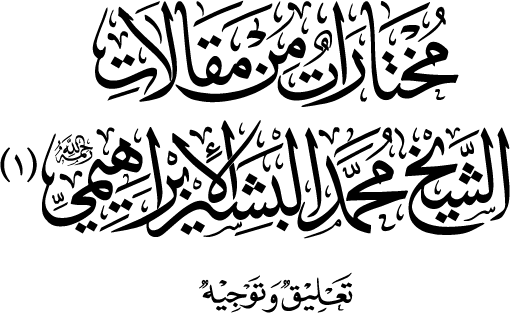
«فلسفة(٢) جمعية العلماء»(٣)
[الحلقة الأولى]
¨ قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ـ رحمه الله ـ:
«الحمدُ لله ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمُتَّقِين، ولا عدوانَ إلَّا على الظالمين، والصَّلاةُ والسلام على سيِّدنا محمَّدٍ أشرفِ المُرسَلين وإمامِ المُتَّقِين، وعلى آله وصحبِه أجمَعين.
﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣﴾ [آل عمران]، آمنتُ بالله ربًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبالكعبةِ قِبلةً، وبالقرآن إمامًا، وبسيِّدِنا محمَّدٍ نبيًّا ورسولًا.
أُقسِمُ ما كنتُ أدري لِمَ فاضت نفسي بهذه الآيةِ عندما أخذتُ القلمَ لِأكتبَ هذا التصديرَ لنشرةِ جمعيَّة العلماء؟ ولِمَ جاشت بهذا الاعترافِ الشاملِ لكُلِّيَّات الإيمان(٤) في هذا الوقت؟ ولكنَّني بعد أَنْ كتبتُ الآيةَ وسجَّلْتُ الاعترافَ وضعتُ القلمَ ورجعتُ إلى نفسي أُسائِلُها فيما بيني وبينها: بأيِّ شعورٍ كانت مغمورةً؟ أو أيُّ انفعالٍ كان يُساوِرُها حين أَمْلَتْ على القلمِ هذه الآيةَ، وحين فاضت بهذا الإقرارِ الذي لا داعِيَ إليه مِنْ مِثلِها في مِثلِ هذا الوقت؟ فخفقَتْ خفقةً هي أشبَهُ شيءٍ بلفتةِ المَذعور(٥)، كأنَّها تبحثُ عن هذا الشعورِ في الماضي المُتَّصِل بالحال، وتَبيَّن لي أنَّها كانت سابحةً في جوٍّ مِنَ التفكير في حال المسلمين، واستعراضِ ماضيهم السعيدِ وحاضرهم الشقيِّ، وتلمس الأسبابَ والعِلَلَ لهذا الانحطاطِ المُريع، بعد ذلك الارتفاعِ السريع، وكأنها وقفَتْ ـ بعد ذلك الاستعراضِ ـ موقفَ الحيرانِ المدهوشِ تسأل: كيف يشقى المسلمون وعندهم القرآنُ الذي أَسعدَ سلَفَهم؟ أم كيف يتفرَّقون ويَضِلُّون وعندهم الكتابُ الذي جمَعَ أوَّلَهُم على التقوى؟ فلو أنَّهم اتَّبَعوا القرآنَ وأقاموا القرآنَ لَمَا سَخِر منهم الزمانُ وأنزلهم منزلةَ الضَّعَةِ(٦) والهوان، ولكنَّ الأوَّلين آمَنوا فأَمِنوا واتَّبَعوا فارتفعوا، ونحن... فقد آمَنَّا إيمانًا معلولًا، واتَّبَعنا اتِّباعًا مدخولًا، وكُلٌّ يجني عواقبَ ما زرَعَ، ثمَّ أَدركَتْها الرهبةُ فلجَأَتْ إلى الابتهال فالْتَقى اللِّسانُ والقلمُ على هذه الآية: ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣﴾ [آل عمران](٧).
أمَّا أنَّ المسلمين الأوَّلين سَعِدوا بالقرآنِ واتِّباعِ الرَّسولِ فهذا ما لا مِراءَ فيه، وهو الحقيقةُ العارية التي جلَّاها التاريخُ على الناس مِنْ جميع الأجناس، وزكَّاها بشاهدَيْن مِنْ آثار العلم ونتائجِ العقل؛ فإِنِ احتُمِل أَنْ يَجهلَ ـ هذه الحقيقةَ ـ جاهلٌ فهُم سوادُ المسلمين قبل غيرِهم، وإِنْ وقف باحثٌ عند الظواهر السَّطحيَّة وقال: سَعِدوا بالاتِّحاد مَثَلًا قُلنا له: وما الذي وحَّدهم بعد ذلك التفرُّقِ الشنيع غيرُ القرآن؟ أو قال قومٌ: استيقظت فيهم عواطفُ الخيرِ ونوازعُ الشَّرفِ حين ماتت في الأُمَم فسَادوها وقادوها، قُلنا له: نعم، ولكِنْ ما الذي أَيقظَ فيهم تلك العواطفَ وتلك النوازعَ وما هم إلَّا ناسٌ مِنَ النَّاسِ، بل قد كانوا قبل القرآنِ أضلَّ النَّاسِ، وليسوا مِنْ جِذمٍ(٨) واحدٍ حتَّى تتقارب فيهم النوازعُ الجنسيَّةُ التي يتوارثها أبناءُ الجِذمِ الواحد ويترابطون بها، وسَهُلَ استيقاظُها فيهم فجأةً، لأنَّنا لسنا نعني بالمسلمين الأوَّلين: العربَ وَحْدَهم، وإنَّما نعني بهم: الأُمَمَ التي دانت بالإسلام في قرونه الأولى، تَربَّتْ في كنفِ القرآن وتحت رعايَتِه، وطُبِعَتْ على غرار الهدي المحمَّديِّ، فحرَّر القرآنُ أرواحَها مِنَ العبوديَّة للأوثان الحجريَّة والبشريَّة، وحرَّر أبدانها مِنَ الطاعة والخضوع لجبروت الكسرويَّة والقيصريَّة، وجَلَا عقولَهَا على النُّورِ الإلهيِّ فأَصبحَتْ تلك العقولُ كشَّافةً عن الحقائق العُليا، وطهَّر نفوسَها مِنْ أدران السُّقوطِ والإسفافِ(٩) إلى الدنايا، فأصبحت تلك النفوسُ نزَّاعةً(١٠) إلى المَعالي مُقدِمةً على العظائم، وحدَّد لها ـ لأوَّلِ مرَّةٍ في التاريخ ـ صِلَةَ الرُّوح بالجسم ومدى تعاوُنِهما في التَّدبير، وكيفيَّةَ الجمع بين مَطالبِهما المتبايِنة، وعلَّمها ـ لأوَّلِ مرَّةٍ في التَّاريخ ـ كيف يستغلُّ الإنسانُ استعدادَه وفِكرَه، ففتَحَ أمامَه ميادينَ التفكُّر والاعتبار، وأمَرَه أَنْ يسير في الأرضِ ويمشِيَ في جوانبها ويتفكَّر في مَلَكوت السَّماواتِ والأرضِ، وقد كان النَّاسُ قبل القرآن على جهلٍ مُطبِقٍ بهذا «الاستعمار الفكريِّ» حتَّى بيَّنه القرآنُ الكريم، ووضَعَ قواعدَه، وأَرشدَها ـ لأوَّلِ مرَّةٍ في التاريخ ـ أنَّ الإنسان أخو الإنسانِ لا سيِّدُه ولا عبدُه، وأنَّ فضلَه في المواهبِ، وأنَّ تَساوِيَ النَّاسِ في استعمار الأرض تابعٌ لِتَساوِيهم في النشأة، وهذا تقريرٌ لمبدإ المساواة وهو المبدأُ الذي لم يَسبِقِ الإسلامَ إليه سابقٌ، ولم يَلحَقهُ فيه لاحقٌ، وإِنْ زعم المتبجِّحون(١١).
بهذه الرُّوحِ القرآنيَّةِ اندفعت تلك النُّفوسُ بأصحابها تفتح الآذانَ قبل البلدان، وتمتلك ـ بالعدل والإحسانِ ـ الأرواحَ قبل الأشباح، وتُعلِن ـ في صراحة القرآن وبيانِه ـ حقوقَ الله على الإنسان، وحقوقَ الإنسان في مُلْكِ الله، وحقوقَ الإنسان على أخيه الإنسان؛ إنَّ الذي صنَعَ هذا كُلَّه ـ وأبيك(١٢) ـ لَلْقرآنُ.
ولكِنْ ما هو هذا القرآنُ الذي نُكرِّرُه في كُلِّ سطرٍ؟ أهو هذه «الأحزابُ السِّتُّون» أو «الأجزاءُ الثلاثون» التي نحفظها ونُنفِقُ على حِفظِها سنواتِ الطفولة العَذْبة، وسنواتِ الشَّباب الزُّهْرِ(١٣)، ثمَّ لا يكون حظُّنا منه ـ عند هجوم الكِبَر ـ إلَّا قراءتَه على الأموات بدُرَيْهِماتٍ(١٤)، واتِّخاذَه جُنَّةً مِنَ الجِنَّةِ(١٥) وغيرِ ذلك مِنَ الهَنَات الهَيِّنات(١٦)؟
إِنْ كان هو هذا فلِمَ لم يفعل في الآخِرِين فِعلَه في الأوَّلين؟! ولِمَ نرى حُفَّاظه اليومَ ـ على كثرتهم ـ أنقى النَّاسِ مِنْ هذه المَعاني التي كان القرآنُ يُفيضها على نفوس حُفَّاظه بالأسى؟! ونجدهم دائمًا في أُخرَيَاتِ الناس أخلاقًا وأعمالًا! حتَّى لقد أصبحوا هدفًا لسُخرِيةِ السَّاخر، يتكسَّبون بالقرآن فلا يُجدِيهم! ويقعون في المزالق فلا يَهدِيهم! مع أنَّهم يقرأون فيه: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].
فنَعَمْ: إنَّ القرآنَ هو هذه الأحزابُ السِّتُّون التي نقرأها اليومَ بألفاظها وحروفِها ونقوشِها، منقولًا بالتواتر القطعيِّ، محفوظًا بحفظ الله مِنْ كُلِّ ما أصاب الكُتُبَ السماويَّةَ مِنْ قبلِه مِنَ النسيان والتبديل وتحريفِ الكَلِم عن مواضعه، كَبُرَ بتواتره عن الإسناد والمُسنِدين، وشهادةِ المُعدِّلين والمجرِّحين، قد نيَّف على ثلاثةَ عَشَرَ قرنًا ولم يشكَّ المسلمون في حرفٍ منه فضلًا عن كلمةٍ، وفي الأرض عددَ حصاها أعداءٌ له يتمنَّوْن ـ بقاصمة الظَّهر ـ أَنْ لو ينطفئ نورُه، ويَستسِرُّ ظهورُه، ويَرْضَخون(١٧) ـ في سبيلِ محوه مِنَ الأرض ـ بما كسَبَتِ الأيدي واحتقبَتِ(١٨) الخزائنُ مِنَ الأموال، وبما أخرجت بطونُ النِّساء مِنَ الرِّجال، وبما أنتجت القرائحُ مِنْ مكرٍ واحتيالٍ وكيدٍ ومِحالٍ، فلم ينالوا منه نيلًا إلَّا مضضًا تنطوي عليه جوانحُهم، ووغرًا(١٩) تنكسر عليه صدورُهم، وشجًى تنثني عليه لَهَواتُهم(٢٠)، وحقدًا تغلي مراجلُه في نفوسهم، وقد أبقاهم اللهُ وأبقى لهم منه المُقيمَ المُقعِدَ(٢١)، وهم بهذا الحالِ وهو بهذا الحالِ إلى يومِنا هذا، فلْيَنَمِ المسلمون مِلءَ جفونِهم، ولْيَنْعَموا بالًا مِنْ هذه الناحية، ولْيَعلموا أنَّ القرآن أُتِيَ مِنْ قِبَلهم...
ولكنَّ سِرَّ القرآنِ ليس في هذا الحفظِ الجافِّ الذي نحفظه، ولا في هذه التلاوةِ الشَّلَّاء(٢٢) التي نتلوها، وليس مِنَ المقاصِد التي أُنزِلَ لتحقيقها: تلاوتُه على الأموات، ولا اتِّخاذُه مَكسَبةً(٢٣)، والاستشفاءُ به مِنَ الأمراض الجسمانيَّة(٢٤).
وإنَّما السِّرُّ كُلُّ السِّرِّ في تدبُّرِه وفهمِه، وفي اتِّباعه والتخلُّقِ بأخلاقه، ومِنْ آياته: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص]، ومِنْ آياته ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥﴾ [الأنعام]، ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، و﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣].
هذه هي الطريقةُ الواحدةُ التي اتَّبَعها المسلمون الأوَّلون فسَعِدوا باتِّباعها والاستقامةِ عليها، وهذا هو الإسلامُ مُتجلِّيًا في آياتِ القرآن: دِينٌ واحدٌ جاء به نبيٌّ واحدٌ عن إلهٍ واحدٍ، وما ظنُّك بدِينٍ تحفُّه الوَحدةُ مِنْ جميعِ جِهاتِه؟! أليس حقيقًا أَنْ يسوق العالَمَ إلى عملٍ واحدٍ وغايةٍ واحدةٍ واتِّجاهٍ واحدٍ على السبيل الجامعة مِنْ عقائده وآدابه؟! أليس حقيقًا أَنْ يجمع القلوبَ التي فرَّقَتْ بينها الأهواءُ، والنفوسَ التي باعدَتْ بينها النَّزَعاتُ، والعقولَ التي فرَّق بينها تفاوتُ الاستعداد؟!
بلى ـ واللهِ ـ إنه لَحَقيقٌ بكُلِّ ذلك.
...
إنَّ الإسلامَ ـ في جوهره ـ لَإِصلاحٌ عامٌّ مَنَّ اللهُ به على العالَمِ الإنسانيِّ بعد أَنْ طغَتْ عليه غَمرةٌ(٢٥) حيوانيَّةٌ عارمةٌ، اجتاحت ما فيه مِنْ فطرةٍ صالحةٍ ركَّبها ربُّ العالَمِين، وما فيه مِنْ أخلاقٍ قيِّمةٍ وشرائعَ عادلةٍ قرَّرها الهُداةُ مِنَ الأنبياء والمُرسَلين والحُكَماء المُصلِحين، وصَحِبَتْها غمرةٌ وثنيَّةٌ وقفَتْ في طريق الفِكر فعاقَتْه عن التَّقدُّم وابتلَتْه بما يُشبِه الشَّللَ، وقطعَتِ الصِّلَةَ بين الإنسان وبين خالقه، وعبَّدَتْ بعضَه لبعضٍ، ثمَّ عبَّدته للأصنام وعبَّدته للأوهام، ولكنَّ اللهَ تَدارَكَه برحمَتِه فجاءه بالإسلام بعد أَنْ مدَّتْ هذه الغمراتُ مَدَّها، وبلغت حدَّها، واستشرف لحالٍ خيرٍ مِنْ حالِه ونورٍ يجلو ظُلمَتَه، وكان ذلك النورُ هو الإسلامَ.
وكان مُستقَرُّ الدِّين مِنْ نفوس البشر تتعاوره(٢٦) نزعتان مختلفتان وهما: التعطيلُ المحضُ والشِّركُ(٢٧)، وكان العالَمُ كُلُّه يضطرب بين هاتين النزعتين وقد مَلَكتَا عليه أَمْرَه، فلا تُسلِمُه المُهلِكة منهما إلَّا للمُوبِقة، ولم يَسْلَمْ مِنْ شرِّهما حتَّى المِلِّيُّون الكتابيُّون، فجاءه الإسلامُ بالدواء الشافي وهو التوحيدُ الخالصُ مؤيَّدًا بالأدلَّة التي تبتدئ مِنَ النفس، وإنَّ نظرةً في النفوس حين تتجلَّى بغرائبها، ونظرةً في الآفاق حين تتعرَّض بعجائبها لَتُفْضِيَانِ بصاحبها إلى اليقين الذي لا شكَّ بعده، وهذا هو ما حُرِمَه البشرُ قبل نزول القرآن، فوقفوا في الطَّرَفين المُتناقِضَيْن مِنْ شركٍ وتعطيلٍ، وهذا هو ما دَعَا إليه القرآنُ، فهداهم به إلى سواء السبيل».
ـ يُتبَعُ ـ
(١) هو محمَّد البشير بنُ محمَّد السعدي بنِ عمر بنِ عبد الله بنِ عمر الإبراهيميُّ، أحَدُ أعضاءِ جمعيَّة العُلَماء المسلمين الجزائريِّين ورئيسُها بعد وفاةِ مُؤسِّسها ابنِ باديس ـ رحمه الله ـ وعضوُ المجمع اللغويِّ بالقاهرة والمجمعِ العلميِّ بدمشق، وعضوُ مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر، يَرْتفِعُ نَسَبُه إلى إدريس بنِ عبد الله مُؤسِّسِ دولةِ الأدارسة بالمغرب الأقصى، كان ـ رحمه الله ـ عالِمًا فذًّا وإمامًا مِنْ أئمَّةِ السلفيَّة وأديبًا مُرَبِّيًا، ومُجاهِدًا مُصْلِحًا، شَمِلَتْ كتاباتُه قضايَا الوطنِ العربيِّ وهمومَ العالَمِ الإسلاميِّ. تُوُفِّيَ بالجزائر سنةَ: (١٣٨٥ﻫ)؛ [انظر ترجمته في: مقالة الإبراهيمي تحت عنوان: «أنا» في: «مجلَّة مَجْمَع اللغة العربيَّة» (٢١/ ١٣٥)، مقالة الهاشمي التيجاني نَشَرَها بمجلَّة: «التهذيب الإسلامي» (ع: ٥، ٦ س/ ١)، «البشير الإبراهيمي، نضالُه وأدَبُه» لمحمَّد المهداوي، رسالة ماجستير بعنوان: «البشير الإبراهيمي أديبًا» قدَّمها السيِّد عبَّاس محمَّد بكُلِّيَّة الآداب ـ جامعة بغداد سنة: (١٩٨٣م)، «الأعلام» للزركلي (٧/ ٥٤)، ومُؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٣٧٦)].
(٢) الفَلْسَفة [مُفرَد]: مصدرُ فَلْسفَ، وفَلْسَفَ الشيءَ: فسَّره تفسيرًا فلسفيًّا، أي: عرَّفه بعِلَلِهِ وأسبابه اعتمادًا على العقل، يقال: مذهبٌ فلسفيٌّ؛ وفي الفلسفة والتَّصوُّف: هي علمٌ يُعنى بدراسة المبادئ والعِلَل الأولى للأشياء وتفسيرِ الأحداث والظواهر تفسيرًا عقليًّا، ويَشمَلُ: المنطقَ والأخلاقَ وعِلمَ الجمال وما وراء الطبيعة وتاريخَ الفلسفة، يقال: مدرسةٌ فلسفيَّةٌ وتفكيرٌ فلسفيٌّ؛ والفلسفةُ المدرسيَّة ـ في علم النَّفس ـ: هي الفلسفة المبنيَّة على فلسفةِ أرسطو الكلاميَّة، وتتميَّز بإخضاع الفلسفة لِلَّاهوت، وإقامةِ صِلَةٍ بين العقل والدِّين؛ [انظر: «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (٣/ ١٧٣٩)].
قال ابنُ تيميَّة في مَعرِض الحديث عن السَّفسطة في [«بيان تلبيس الجهميَّة» ـ مجمع الملك فهد ـ (٣/ ٤٥٠)]: «السَّفسطة هي كلمةٌ معرَّبةٌ، وأصلُها يونانيَّةٌ سُوفِسقِيَا [كذا، ولعلَّ الصوابَ الموافق للنطق اليونانيِّ: سُوفِسْتِيَا]، ومعناها: الحكمةُ المموَّهة؛ فإنَّ لفظَ سُوفِيَا يدلُّ في لُغَتِهم على الحكمة؛ ولهذا يقولون: فِيلَاسُوفَا أي: مُحِبُّ الحكمة» [وانظر: (٢/ ٣٣٧)].
وقال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ [في «الصَّفَديَّة» ـ تحقيق: محمَّد رشاد سالم ـ (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٥)]: «والفلسفة لفظٌ يونانيٌّ، ومعناها: محبَّةُ الحِكمة؛ والفيلسوف في لُغَتِهم: مُحِبُّ الحكمة؛ ولهذا يقولون: سُوفِسْتِيَا أي: حكمةٌ مموَّهةٌ؛ ثمَّ كَثُرَتْ في الألسنة فقِيلَ: سفسطةٌ أي: حكمةٌ مموَّهةٌ... والمقصودُ أنَّ الفلاسفةَ هم حُكَماءُ اليونان، وكُلُّ أمَّةٍ مِنْ أهل الكُتُب المُنزَلة وغيرِهم فلَهُم حُكَماءُ بحسَبِ دِينِهم كما للهند المُشرِكين حُكَماءُ، وكان للفُرْس المَجوسِ حُكَماءُ، وحُكَماءُ المسلمين هم أهلُ العلم بما بعَثَ اللهُ به رسولَه وأهلُ العمل به؛ قال مالكٌ: الحكمةُ معرفةُ الدِّينِ والعملُ؛ وقال ابنُ قُتَيْبةَ وغيرُه: الحكمةُ في اللُّغة هي العلمُ والعملُ، فمَنْ عَلِم ما أَخبرَتْ به الرُّسُلُ فآمن به وصدَّق بعلمٍ ومعرفةٍ، وعَلِمَ ما أُمِر به فسَمِع وأطاع، فقَدْ أُوتِيَ الحكمةَ، ﴿وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾ [البقرة: ٢٦٩]؛ فلمَّا كان هذا أصلَ لفظِ الفلسفة صار هذا مُطلَقًا على كُلِّ مَنْ سلَكَ سبيلَ أولئك اليونانِ واتَّبَعهم في حِكمتهم، والذين اتَّبَعوهم مِنَ المتأخِّرين فصرَّحوا فيها بأشياءَ وقرَّبوها إلى المِلَل؛ وإلَّا فإذا ذُكِرَتْ على وجهها ظهَرَ فيها مِنَ الباطل ما يُنفِّر عنها كُلَّ عاقلٍ عرَفَ دِينَ الرُّسُل؛ فإنَّ الرُّسُلَ قد جاءوا مِنَ العلم والبيان في الأمور الإلهيَّة ما يكون في حكمة اليونان معه مِنْ جنسِ نسبةِ طبِّ العجائز إلى طبِّ أبقراط، أو مِنْ جنسِ نسبةِ «مُلحة الإعراب» إلى «كتابِ سِيبوَيْه»».
هذا، والمصنِّف ـ رحمه الله ـ وإِنْ كان في استخدامه لمُصطلَحِ «الفلسفة» لا يقصد مدلولَه الفلسفيَّ القائم على البحث في عِلل الأشياء وكُنهها ومحاولةِ الوصول عن طريق العقل إلى فهم المجهول، والإجابةِ عن الأسئلة التي يعجز العلمُ عن بحثها والفصلِ فيها ممَّا يُسمَّى بما وراء الطبيعة والإلهيَّات، وذلك في منأًى عن مصادر الإسلام وهديِه، فلعلَّه ـ فيما يبدو ـ عَنَى بها الحكمةَ بمفهومها الإسلاميِّ، أي: قصَدَ حكمةَ جمعيَّةِ العلماء وحُسْنَ تدبيرِها وتسييرِها في إصابة الحقِّ في القول والعمل، أو لعلَّه عَنَى ما يَعنِيه بعضُ مَنِ استعملها مِنَ العلماء المُعاصِرين أو يظهر مِنْ سياقِ استعمالهم لها، ومنهم الشيخ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ عندما ينسبها إلى نفسه أو العلماء أو يأتي بها بسياقٍ غير مُشعِرٍ بالإنكار، وهو قريبٌ مِنْ معنى المفهوم أو المسلك الفكريِّ، ومع ذلك ـ وإِنْ كان هذا اصطلاحًا ولا مُشاحَّةَ فيه إذا صحَّ المعنى المُرادُ وبلَغَ إلى السامع أو القارئ وفَهِمَه دون الْتِباسٍ ـ لكنَّه قَدْ يترتَّب على استخدامِ مثلِ هذا المُصطلَحِ آثارٌ غيرُ مرغوبٍ فيها عند كثيرٍ ممَّنْ يقف على الكلام، فلو كان استغنى ـ عن هذا اللفظ الدخيلِ المرادِ به غيرُ معناه بِلُغَتِه ـ بمُصطلَحِ الحكمةِ مَثَلًا لَمَا تغيَّر المعنى الحقيقيُّ الذي يَعنِيه المصنِّفُ عِوَضًا عن مُصطلَحِ «الفلسفة» كائنًا ما كان مُرادُه بها لِيَسُدَّ الذريعةَ على مَنْ يَتذرَّع بذلك إلى ترويج المفاهيم المرذولة، إذ ليس في استخدامه زيادةٌ في الصِّياغة لها اعتبارٌ عِلميٌّ أو منهجيٌّ، بل بالعكسِ فهو يوحي بتبعيةٍ وانسياقٍ مع أسلوب الكتابة بمفهومها الغربيِّ (أو اليونانيِّ أو الرومانيِّ) الذي لا يسير على ضوء المُسلَّماتِ الشَّرعيةِ، ولا يتَّفق ـ في دلالاته ومعانيه الحقيقيَّة ـ مع المنهج الإسلاميِّ، وخاصَّةً إذا نُسِب مِثلُ هذا المُصطلَحِ إلى الإسلام أو إلى مصدرَيْه: الكتاب والسُّنَّة، أو إلى مَعانٍ شرعيَّةٍ، ذلك لأنَّ الفلسفةَ ـ في مفهومها الغربيِّ ـ لا تعني الحكمةَ، وإنَّما مقصودُهم منها: المَيلُ إلى الحكمة وحُبُّها والبحثُ عنها بالأدلَّة العقليَّةِ، وهذا لو كان مفهومُهم للحكمة مُطابِقًا لمفهومها في الإسلام لكان قريبًا إِنِ انضمَّ إلى المَحَبَّةِ لازمُها الذي هو إرادتُها وقصدُها، فإنه باعثٌ على العمل لتحصيلها؛ فإنَّ الحكمةَ الحقيقيَّةَ هي العلمُ النافع الصحيح والعملُ الصالح؛ ولكنَّ مفهومَهم لها بعيدٌ كُلَّ البُعد عن المسلَّمات الشَّرعيَّة، بل بالأحرى فهي تهدفُ إلى إخضاعِ المُسلَّمات الشَّرعيةِ إلى حَيِّز الفلسفة ومنهجها العقليِّ؛ ولا يخفى أنَّه يستحيل التَّوفيقُ بين المنهج الإسلاميِّ الذي مصدرُه الوحيُ الإلهيُّ المُنزَّل بقواعده الرَّبَّانيَّة وأحكامِه المُستمدَّة مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو المُستلهَمةِ مِنْ مقاصد الشَّريعة وأسرارها، وبين منهجٍ يعتمد على نظريَّات النَّاس وأعرافهم، وما جنَحَ إليه العقلُ البشريُّ القاصرُ ـ إِنْ لم يكن في ذاته حائرًا وعن سواءِ السَّبيل جائرًا ـ وما نَتَجَ عن الأوضاع المتوارثة، فشَّتَّان بين المنهجين!! ذلك لأنَّ قوَّةَ العقلِ لا تَستقِلُّ بتحصيلِ الاستقامة والسَّدادِ عمَّا في الوحي مِنَ الهداية والإرشادِ، كما أنَّ قوَّةَ العَيْنِ لا تَستقِلُّ بحصول الرؤية عن مَنبَعِ النُّور.
لذلك حارب العُلَماءُ ـ قديمًا وحديثًا ـ استخدامَ المنهج الفلسفيِّ في كُلِّ المجالات بما في ذلك مجال المُصطلَحات، خروجًا مِنَ التَّبعيَّة أوَّلًا، وتجنُّبًا ـ ثانيًا ـ لِلدَّلالات والمعاني التي لا تتَّفِق والمنهجَ الإسلاميَّ؛ [انظر: «مصطلح فلسفة التربية في ضوء المنهج الإسلامي» (دراسة نقدية) لخالد بن حامد الحازمي (٣١٢ وما بعدها)].
(٣) «آثار الإبراهيمي» (١/ ١٥٨)؛ مِنْ كتابِ سِجِلِّ مؤتمر جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين المُنعقِد بنادي التَّرَقِّي بالعاصمة في سبتمبر سَنَةَ ١٩٣٥، المطبعة الإسلاميَّة الجزائريَّة، قسنطينة، (ص: ٥ ـ ٧٢).
(٤) لعلَّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ عَنَى بكُلِّيَّات الإيمانِ ما تَقدَّم مِنْ قوله: «آمنتُ بالله ربًّا، وبالإسلام دِينًا، وبالكعبة قِبلةً، وبالقرآن إمامًا، وبسيِّدنا محمَّدٍ نبيًّا ورسولًا»؛ يشهد لذلك السِّباقُ والسِّياقُ؛ فإنها كُلِّيَّاتٌ للإيمان بمعناه الأعمِّ الذي يدخل فيه الإسلامُ والإحسانُ على ما هو مقرَّرٌ مِنْ أنَّ الإيمان إذا انفرد شَمِل الدِّينَ كُلَّه؛ علمًا أنَّ الجملة السابقةَ لا تخرج عن الشهادة بأركانها المعلومة مِنَ: الرِّضا بالله ربًّا وبالإسلام دِينًا وبمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم رسولًا؛ ولا يخفى أنَّ الشهادة مِنَ الإسلام وهي ركنٌ واحدٌ مُستلزِمٌ لأركان الإيمان لا يَشمَلُها إلَّا باعتبارِ استلزامه لها، هذا مِنْ جهةٍ.
ولعلَّه يعني بكُلِّيَّات الإيمان ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ: الأُصولَ السِّتَّةَ التي هي أصولُ الدِّينِ كُلِّه، متمثِّلةً في: الإيمان بالله وملائكتِه وكُتُبِه ورُسُله وباليوم الآخِرِ وبالقَدَر خيرِهِ وشَرِّه، فهي العقيدة التي تلقَّاها أهلُ السُّنَّة والجماعة عن أصحاب النَّبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وتلقَّاها أصحابُ النَّبيِّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم؛ مع أنه ـ مِنْ جهةٍ ثالثةٍ ـ قد يُعنَى به الأمران معًا.
(٥) أي: اضطراب النَّفْسِ الخائفة الفَزِعَةِ كأنَّها الْتِفاتُ خائفٍ نُبِّه بغتةً على حينِ غِرَّةٍ وطولِ سُبَاتٍ، فصار يُقلِّبُ بصرَه يتلمَّسُ بشَغَفٍ ولهفةٍ باحثًا عمَّا عزَبَ عنه لُبُّه مِنَ التفكير في ماضي الأُمَّة السَّعيد والتَّحدِيات التي تواجهها في حاضرها الشَّقيِّ، فقد سَعِد المُسلمون الأَوَّلون بالقرآن واتِّباعِ الرَّسول صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فما الذي أدَّى بالأمَّةِ إلى الشَّقاءِ والضَّلال والتَّفرُّقِ والتَّشتُّتِ المُفضي إلى الضَّعف والهوان، وعندهم القرآنُ الذي أسعد سَلَفهم، وجمَعَ أوَّلَهُم على التَّقوى، ووحَّدهم على الحقِّ المُبين بعد تفرُّقهمُ الشَّنيع؟ فما هي ـ يا ترى ـ أسبابُ مُعاناتِهم وعِللُ شقاوتِهم وتَدنِّيهم المُريع؛ وما هي موجِباتُ انحطاطِهم المُخيف؟
ومِنْ أهمِّ الفوارق بين الأُمَّة في ماضيها وحاضرها: أنَّ إيمانَها في حاضرِها الشَّقيِّ معلولٌ، واتِّباعَها مدخولٌ، فأنَّى ترتقي وترتفع وأبناؤها يريدون ـ وعبثًا يحاولون ـ أَنْ يأتوا بيتَ الرِّفعة والرُّقِيِّ والعِزَّةِ مِنْ ظَهرِه لا مِنْ بابه، ولم يَسْعَوْا لهما سعيَهما ولم يبذلوا أسبابَهما بالرجوع إلى دِينهم الذي ـ به وَحْدَه ـ أَعزَّهم اللهُ مع قِلَّتِهم بعدما كانوا في ذِلَّةٍ، ولا عِزَّةَ لهم ولا مَخرجَ مِنَ الذُّلِّ الذي هم فيه إلَّا بالرجوع إليه؟!
(٦) أي: خلاف الرِّفعة في القَدْر، يقال: «في حَسَبِه ضَعَةٌ ويُكسَر»: انحطاطٌ ولؤمٌ وخِسَّةٌ ودناءةٌ، وقد وَضُعَ ككَرُمَ ضَعَةً ويُكسَر ووَضاعةً فهو وضيعٌ، واتَّضع ووضَعَه غيرُه ووضَّعه توضيعًا، [انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٩٩٧)].
(٧) في هذه الآية خبرٌ مِنَ الله تعالى عن الحواريِّين أنَّهم ـ بعد أَنْ أَشهَدوا نبيَّهم عيسى عليه السلام على إيمانِهم بالإسلامِ وانقيادِهم لرسالتِه ـ أَشهَدوا اللهَ تعالى بقولهم: ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣﴾ [آل عمران] أي: ربَّنا آمَنَّا بِما أنزلتَ مِنَ الإنجيلِ، واتَّبعنا عيسى عليه السلام، فاكتُبْنا ـ جزاءً على إيمانِنا بكتابِك واتِّباعِنا لرسولك ـ مع الشَّاهدِينَ مِنَ الأنبياءِ والمؤمنين، أي: «أَثبِتْ أسماءَنا مع أسماء الذين شهِدوا بالحقِّ، وأَقَرُّوا لك بالتَّوحيدِ، وصَدَّقوا رُسُلَك، واتَّبعوا أمرَك ونَهيَك، فاجْعَلْنا في عِدادِهم ومَعَهم فيما تُكرِمُهم به مِنْ كرامتِك، وأَحِلَّنا محلَّهم، ولا تَجعَلنا ممَّنْ كَفَرَ بك، وصدَّ عن سبيلِك، وخالَف أمرَك ونهيَك» [«تفسير الطبري» [(٦/ ٤٥٢)].
هذا، ويحتَملُ أنَّ هؤلاء الشَّاهدين هم الَّذين شهِدوا للنَّبيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بالرِّسالةِ، فشَهِدوا: «أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله»، ولهذا فسَّر ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما وغيرُه معنَى: ﴿مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣﴾ بقوله: مع محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وأمَّتِه؛ [انظر: «تفسير القرطبي» (٤/ ٩٨)].
(٨) الجَذْم: القَطْع، وجِذْمُ كُلِّ شَيْءٍ: أصلُه؛ والجِذْمة: القطعَة مِنَ الشَّيْء يُقطَعُ طَرَفُه ويبقى أصلُه؛ [«المُحكمُ والمُحيطُ الأعظمُ» لابن سِيدَه (٧/ ٣٦٦)].
(٩) الإسفاف ـ هنا ـ هو: الدُّنوُ والقُربُ مِنَ الأمورِ الدَّنيئةِ، والإسفاف يأتي ـ أيضًا ـ بمعنَى شِدَّةِ النظر وحِدَّتِه ومنه: رُوِي عن الشَّعبيِّ: أنه كَرِه أَنْ يُسِفَّ الرَّجلُ النَّظرَ إلى أُمِّه أو ابنتِه أو أُختِه؛ وكُلُّ شيءٍ لَزِمَ شيئًا ولَصِقَ به فهو مُسِفٌّ؛ [انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٩/ ١٥٤)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٠٥٩)].
(١٠) نزَعَ إلى الشيءِ يأتي بمعنَى مال وانجذب، ونزَعَ الشيءَ: جذَبَه أو قلَعَه، ويأتي بمعنَى: أَشبَهَ، تقول: نَزَعَ الرَّجُلُ أخوالَه وأعمامَه ونَزَعوهْ ونَزَعَ إليهم، أي: أشبَهُوهُ وأشبَهَهُمْ؛ ونزَعَ إلى أهله أو الشيء: ذهَبَ، ونزَعَ عن الشيء: انتهى وكفَّ؛ [انظر: «العين» للخليل (١/ ٣٥٨)، «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٤١)، «مختار الصِّحاح» للرازي (٣٠٨)].
والمقصود هنا: أنَّ تلك النفوسَ أصبحت ميَّالةً مُنجذِبةً إلى المَعالي.
(١١) بَجِحَ بالشيء يَبْجَحُ بَجَحًا فهو بَجِحٌ: فَرِحَ به وفَخَر؛ وتبجَّحَ يتبجَّح تَبَجُّحًا فهو مُتبجِّحٌ، والتَّبجُّح: جُرأةٌ مُستهَجنةٌ وسوءُ أدبٍ وسلاطةُ لسانٍ، يقال: تبجَّحَ الشَّخصُ: إذا تكبَّر وافتخر وتباهى في صلفٍ وادِّعاءٍ، يقال: «العالم الحقُّ لا يتبجَّحُ بعِلْمه»، وتبجَّح: إذا أجاب بصفاقةٍ، ولم يُراعِ قواعدَ الأدب؛ [«مُعجَم اللغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (١/ ١٥٩ ـ ١٦٠)].
(١٢) قول المصنِّف ـ رحمه الله ـ: «وأبيك» هي كلمةٌ يُؤتى بها للقَسَم يُراد بها الحَلِفُ والتَّعظيم، وقد ثبت النَّهيُ عن الحَلِفِ بها، فعن نافعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب: كيف يُستحلَف؟ (٢٦٧٩) وفي «مناقب الأنصار» بابُ أيَّامِ الجاهليَّة (٣٨٣٦) وفي «الأدب» بابُ مَنْ لم يَرَ إكفارَ مَنْ قال ذلك متأوِّلًا أو جاهلًا (٦١٠٨) وفي «الأيمان والنذور» (٦٦٤٦، ٦٦٤٧، ٦٦٤٨) باب: لا تحلفوا بآبائكم، وفي «التوحيد» (٧٤٠١) باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ومسلمٌ في «الأيمان» (١٦٤٦) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا [بِاللهِ] إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» [أخرجه أبو داود في «الأيمان والنذور» بابٌ في كراهِيَةِ الحَلِف بالآباء (٣٢٤٨)، والنسائيُّ في «الأيمان والنذور» باب الحَلِف بالأُمَّهات (٣٧٦٩)؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٢٤٩)].
وأمَّا ما وقع ممَّا يخالف النَّهيَ السَّابقَ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم للأعرابيِّ: «أَفْلَحَ ـ وَأَبِيهِ ـ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ وَأَبِيهِ ـ إِنْ صَدَقَ» [أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (١١)، وأبو داود في «الصلاة» بابُ فرضِ الصلاة (٣٩٢) وفي «الأيمان والنذور» بابٌ في كراهِيَةِ الحَلِف بالآباء (٣٢٥٢)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٢٤١١)، والدارميُّ في «مُسنَده» (١٦١٩)، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٣٠٦)، وأبو عَوانة في «مُستخرَجه» (١٢)، والطحاويُّ في «شرح مُشكِل الآثار» (٨٢١)، وأبو نُعَيْمٍ في «مُستخرَجه» (٩٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٤١٣٢، ٧٩٠٣)، مِنْ طريق إسماعيلَ بنِ جعفرٍ المقرئ المدنيِّ، عن أبي سُهَيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ الحِمْيَريِّ الأصبحيِّ عن أبيه عن طلحةَ بنِ عُبيد الله التَّيميِّ رضي الله عنه؛ وانظر: «حديثَ عليِّ بنِ حُجرٍ السعديِّ عن إسماعيل بنِ جعفرٍ المدنيِّ» (٤٥٩)].
فهذه اللَّفظة بزيادةِ: «وأبيه» شاذَّةٌ مخالفةٌ للرِّواية المَحفوظةِ: «أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» سواءٌ كانت مِنْ طريق مالكٍ أو مِنْ طريقِ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ كلاهما عن أبي سُهيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ عن أبيه عن طلحةَ رضي الله عنه، أو كانت مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه:
· فمِنْ طريق مالكٍ: أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» ـ ت الأعظمي ـ (٦٠٤)، والشافعيُّ في «مُسنَده» (ص ٢٣٤)، وأحمد في «مُسنَده» (١٣٩٠)، والبخاريُّ في «الإيمان» (٤٦) باب: الزكاةُ مِنَ الإسلام، وفي «الشهادات» باب: كيف يُستحلَف؟ (٢٦٧٨)، ومسلمُ في «الإيمان» (١١) بابُ بيانِ الصلوات التي هي أحَدُ أركانِ الإسلام، وأبو داودَ في «الصلاة» (٣٩١) بابُ فرضِ الصلاة، والنَّسائيُّ في «الصلاة» (٤٥٨) باب: كم فُرِضَتْ في اليوم والليلة، وفي «الإيمان وشرائعه» باب الزكاة (٥٠٢٨)، وابنُ حِبَّان في «صحيحه» (١٧٢٤، ٣٢٦٢)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (١٦٩١، ٤١٣٤)، مِنْ طُرُقٍ عن مالكٍ عن عَمِّهِ أبي سُهيل نافع بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ الحِميَريِّ الأصبحيِّ عن أبيه عن طلحةَ بنِ عُبَيْدِ الله التَّيميِّ رضي الله عنه به.
· ومِنْ طريقِ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ وجوبِ صومِ رمضان (١٨٩١) وفي «الحِيَل» بابٌ في الزكاة وأَنْ لا يُفرَّق بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَع بين مُتفرِّقٍ، خشيةَ الصدقة (٦٩٥٦)، والنسائيُّ في «الصيام» بابُ وجوبِ الصيام (٢٠٩٠) وغيرُهم.
· وأخرجه أحمد في «مُسنَده» (١٣٨١٥)، والطبرانيُّ في «الأوسط» (٥٠٧١)، مِنْ حديثِ قَتادةَ عن أنسٍ رضي الله عنه.
ويحتمل أَنْ تكون اللفظةُ الشَّاذَّةُ تصحيفًا مِنْ كلمةِ: «واللهِ» لِتَوافُقِهما إذا كُتِبتَا دون نقطٍ كما ذكَرَه بعض الشُّرَّاح، وذلك إذا كان حجمُ اللَّامَيْن بحجم الباء والياء؛ فقَدْ رُوِي عن إسماعيلَ بنِ جعفرٍ نفسِه بنفسِ الطريق بلفظِ: «أَفْلَحَ ـ وَأَبِيهِ ـ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ وَاللهِ ـ إِنْ صَدَقَ» [أخرجه البيهقيُّ في «سُنَنه الكبرى» (٤١٣٢، ٧٩٠٣)].
قال ابنُ عبد البرِّ في «التمهيد» (١٤/ ٣٦٧): «والحَلِفُ بالمخلوقات كُلِّها في حكم الحَلِف بالآباء: لا يجوز شيءٌ مِنْ ذلك، فإِنِ احتجَّ مُحتجٌّ بحديثٍ يُروى عن إسماعيلَ بنِ جعفرٍ عن أبي سُهيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ عن أبيه عن طلحةَ بنِ عُبيد الله في قصَّة الأعرابيِّ النَّجديِّ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «أَفلحَ ـ وأبيه ـ إِنْ صدق» قِيلَ له: هذه لفظةٌ غيرُ محفوظةٍ في هذا الحديث مِنْ حديثِ مَنْ يُحتجُّ به، وقد روى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُه عن أبي سُهيلٍ، لم يقولوا ذلك فيه؛ وقد رُوِي عن إسماعيلَ بنِ جعفرٍ هذا الحديثُ وفيه: «أَفْلَحَ ـ وَاللهِ ـ إِنْ صَدَقَ» أو «دَخَلَ الجَنَّةَ ـ وَاللهِ ـ إِنْ صَدَقَ»؛ وهذا أَوْلى مِنْ روايةِ مَنْ روى: «وأبيه» لأنها لفظةٌ مُنكَرةٌ تردُّها الآثارُ الصِّحاح».
قال الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في [«سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة» (١٠/ ٢/ ٧٦٤)] ـ بعد دراسةٍ مُستفيضةٍ للحديث ـ ما نصُّه: «والخلاصةُ: أنَّ الزِّيادةَ المذكورةَ في حديثِ طلحةَ ـ وكذا في حديثِ أبي هريرة الذي قبله ـ زيادةٌ شاذَّةٌ لا تصحُّ عندي، ومَنْ صحَّحها فإنَّما نظَرَ إلى كونِ راويها ـ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ ـ ثِقَةً، دون النَّظر إلى مُخالَفةِ مالكٍ له فيها، واختلافِ الرُّواة على إسماعيلَ في إثباتها، فلا جرَمَ أَنْ أَعرضَ عن روايتها إمامُ الأئمَّةِ أبو عبد الله البخاريُّ، وهذا هو غايةُ الدِّقَّة في التَّخريج، جزاه اللهُ خيرًا، ثمَّ إنَّه قد بَدَا لي شيءٌ آخَرُ أكَّد لي نكارةَ الزِّيادة في حديثِ طلحةَ خاصَّةً، ألَا وهو أنَّه بينما نرى الأعرابيَّ السائلَ لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن الإسلام؛ يحلف بالله دون سواه؛ إذا بالرسول صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يحلف بأبيه كما تقول الزِّيادةُ! فهذه المقابلةُ مُستنكَرةٌ عندي مهما قِيلَ في تأويل الزِّيادة، واللهُ أَعلَمُ، ثمَّ رأيتُ ابنَ عبد البرِّ قد جزَمَ في «التمهيد» (١٤/ ٣٦٧) بأنَّ الزِّيادةَ غيرُ محفوظةٍ».
وهذِه الزِّيادةُ وإِنْ ثبتَت صحيحةً في أحاديثَ أخرى؛ فإنَّ للعلماءِ عِدَّةَ أجوبةٍ عنها أَحسَنُها ـ عندي ـ أنَّ هذا القَسَمَ كان مُستعمَلًا في أوَّلِ الأمر قبل النَّهي، ثمَّ نُسِخ بعد ذلك؛ قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ:«قاله الماورديُّ، وحكاه البيهقيُّ، وقال السبكيُّ: أكثرُ الشُّرَّاح عليه، حتَّى قال ابنُ العربيِّ: ورُوي أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يحلف بأبيه حتى نُهي عن ذلك» [انظر أجوبة العلماء في: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٢٤) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٥٣٤)، و«ذخيرة العقبى» للأثيوبي (٣٠/ ٢٨٨)]؛ فإِنْ لم تثبت فهي إمَّا شاذَّةٌ أو مصحَّفةٌ [انظر: الفتوى رقم: (١٣٢٨) بعنوان «في وجوه الجمع بين حديث النهي عن الحَلِف بالآباء وحديثِ: «أَفْلَحَ ـ وَأَبِيهِ ـ..»» على الموقع الرسمي].
(١٣) الزُّهْر: جمعُ أَزهرَ وزَهراءَ؛ وزُهْر: صفةٌ مشبَّهةٌ تدلُّ على الثُّبوت مِنْ زهِرَ: أبيضُ صافٍ مضيءٌ مُشرِقٌ؛ [«مُعجَم اللغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (٢/ ١٠٠٣) وانظر: «مختار الصِّحاح» للرازي (١٣٨)].
(١٤) قراءةُ القرآن على أموات المسلمين سواءٌ كان ذلك تطوُّعًا أو في مُقابلِ أجرٍ ماليٍّ، أو كان بقراءةٍ جماعيَّةٍ أو مُنفرِدةٍ، أو بِنيَّةِ التَّقرُّب إلى الله أو بغرضِ إهداء ثواب القِراءة إليهم؛ فهذا العمل بمُختلفِ صُوَره لا أصلَ له، إذ لم يُحفَظ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ولا أصحابِه رضي الله عنهم أنَّهم كانوا يقرؤون على المَوتى، وقد جاء في الصِّحيحين مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [أخرجه ـ بهذا اللفظ ـ مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) بابُ نقضِ الأحكام الباطلة وردِّ مُحدَثاتِ الأمور، والبخاريُّ في «الصُّلح» (٢٦٩٧) باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ بلفظ: «...مَا لَيْسَ فِيهِ...»، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها]؛ والمعلومُ أنَّ كُلَّ أمرٍ مِنْ أمور العبادات لا يمكن أَنْ يُشرَعَ إلَّا بنصٍّ أو توقيفٍ، ولا نصَّ عليه، وكُلَّ ما عارض السُّنَّة مِنَ الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهادٍ، وكلَّ عبادةٍ أطلقها الشَّارعُ وقيَّدها النَّاسُ ببعض القيودِ مثل المكان أو الزَّمان أو الصفة أو العدد، فهو داخلٌ في البدعة المنصوصِ على ضلالها كما في صحيحِ مسلمٍ وغيرِه واللفظُ للنسائيِّ عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «...إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، [وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ]، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، [وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ]»؛ [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٦٧) باب تخفيف الصلاة والخطبة، وابنُ ماجه في «افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» (٤٥) بابُ اجتنابِ البِدَع والجدل، وأحمد (١٤٣٣٤)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، وما بين المعقوفين مِنْ زيادةِ النسائيِّ في «صلاة العيدين» (١٥٧٨) باب: كيف الخُطبة؟ انظر: «إرواء الغليل» للألباني (٣/ ٧٣)]، ولأنَّه لم يَكُنْ مِنْ عادةِ السَّلفِ إهداءُ الثَّوابِ إلى الأمواتِ فيما لم يَرِدْ فيهِ نصٌّ لكونهم أَحْرَصَ على نيلِ الثَّوابِ مِنْ غيرِهم؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ في [«اختيارات ابن تيميَّةَ» للبعلي (٨٤)]: «ولم يكُنْ مِنْ عادةِ السَّلفِ ـ إذَا صَلَّوْا تطوُّعًا أو صامُوا تطوُّعًا أو حَجُّوا تطوُّعًا أو قَرَؤُوا القرآنَ ـ يُهدونَ ثوابَ ذلكَ إلى أمواتِ المسلمينَ؛ فلا ينبغِي العدولُ عن طريق السَّلفِ؛ فإنَّه أفضلُ وأكملُ»، وقد ذكَرَ ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ [في «تفسيره» (٤/ ٢٥٨)] أنَّ الشَّافعيَّ ـ رحمه الله ـ استنبطَ مِنْ قولهِ تعالى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النَّجم]: «أنَّ القراءةَ لا يَصِلُ إهداءُ ثوابِها إلى الموتى لأنَّه ليسَ مِنْ عملهم ولا كسبِهم، ولهذا لم يَندُبْ إليه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أُمَّتَهُ، ولا حثَّهم عليهِ، ولا أرشَدَهم إليهِ بنصٍّ ولا إيماءٍ، ولم يُنقَلْ ذلكَ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، ولو كان خيرًا لَسَبَقونا إليهِ، وبابُ القُرُباتِ يُقتصَرُ فيه على النُّصوصِ، ولا يُتصرَّفُ فيه بأنواعِ الأقيِسةِ والآراء».
وأمَّا ما رُويَ مِنِ استحبابِ قراءَةِ «يس» عند الميِّتِ: «اقرؤوا «يس» على موتاكم» [أخرجه أبو داود في «الجنائز» (٣/ ٤٨٩) باب القراءة عند الميِّت (٣١٢١)، وابنُ ماجه في «الجنائز» (١/ ٤٦٦) بابُ ما جاء فيما يُقالُ عند المريض إذا حُضِر (١٤٤٨)، وأحمدُ في «المُسنَد» (٥/ ٢٦، ٢٧) (٢٠٣٠٠، ٢٠٣٠١، ٢٠٣١٤)، والحاكم في «المُستدرَك» (١/ ٥٦٥) (٢٠٧٤)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٨٣) (٦٦٠٠)، مِنْ حديثِ مَعقِل بنِ يسارٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه؛ والحديث ضعَّفه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ١٥٠) رقم: (٦٨٨)].
وكذا قراءةِ سورةِ البقرةِ وغيرها: فهي أحاديثُ ضعيفةٌ لا تَنهضُ للاستِدلالِ؛ [انظر: «تقريب الأفهام إلى ما في النية من الأحكام» للمؤلِّف].
علمًا أنَّ ثوابِ عبادةِ الدُّعاءِ والاستِغفارِ والصَّدقَةِ وكذلك قضاءِ الدَّيْنِ يصِلُ إلى الميِّتِ، وقَدْ نقَلَ النَّوويُّ وابنُ كثيرٍ وغيرُهما رحمهم الله: إجماعَ العلماءِ على ذلك؛ [انظر: «المغني» لابن قدامةَ (٢/ ٥٦٧)، «شرح مسلم» للنَّوويِّ (٧/ ٩٠)، «تفسير ابنِ كثيرٍ» (٤/ ٢٥٨)، «شرح الزُّرقاني» على «المواهب اللَّدُنيَّة» للقسطلاني (٧/ ٤٩٩)].
هذا؛ ولا يُفهَمُ مِنْ كلام المصنِّف ـ رحمه الله ـ أنَّه يُجيزُ قراءةَ القرآن على الأموات، وإنَّما ساق هذا الكلامَ على جهة الذَّمِّ والإنكار كما سيأتي مِنْ كلامه، وقد ردَّ على الشيخ الطاهر بن عاشور ـ في زمانه ـ لمَّا أفتى بجواز قراءة القرآن على الأموات وشدَّد في الرَّد حيث قال فيه: «فما قولكم ـ يرحمكم الله ـ في شيخ الإسلام صاحب الفتوى في قراءة القرآن [أي: على الأموات]؟ قولوا ما شئتم، فإنَّني لا أدعوه بعد اليوم إلَّا شيخ المسلمين في غير ظلمٍ ولا تحيُّزٍ، بل أعتقد أنَّني ـ إذ أُسمِّيه بهذا ـ إنَّما أسمِّيه بأحبِّ الأسماء إليه لأنه آثر رضاهم على رضى الحقِّ، وإرضاءهم على إرضاء الدِّين» [«آثار البشير الإبراهيمي» (١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣)].
(١٥) ـ جُنَّة [مُفرَد]: ج جُنَن: سُترَة ووقايةٌ، كُلُّ ما سَترَ أو وَقى من سلاحٍ وغيرِه؛ كقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» [مُتَّفَقٌ عليه] أي: وقايةٌ مِنَ الشَّهواتِ ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [المجادلة: ١٦].
ـ جِنَّةٌ [جمع]: جِنٌّ، أو طائفةٌ مِنَ الجِنِّ، ﴿لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١١٩﴾ [هود]، [مصدر]: جنونٌ: كقوله تعالى: ﴿بِهِۦ جِنَّةٞ﴾ [المؤمنون: ٢٥، وغيرها]؛ [انظر: «مُعجَم اللغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (١/ ٤٠٨)].
وقد اختلف السَّلفُ في حكم التَّمائم مِنَ القرآن وأسماءِ الله وصِفَاته ومِنَ الأحاديث النَّبويَّة الصَّحيحةِ، والدعاءِ المُباح لدفع العين والجِنِّ وغيرهما، على مذهبين:
فقَدْ رَخَّصَ فيها وأجازها بعضُهم مثل: عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص وغيرِه مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين، وحملوا قولَه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» [أخرجه أبو داود في «الطِّبِّ» بابٌ في تعليق التَّمائم (٣٨٨٣)، وابنُ ماجه في «الطِّبِّ» بابُ تعليقِ التَّمائم (٣٥٣٠)، وأحمد في «مُسنَده» (٣٦١٥)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣٣١، ٢٩٧٢) و««صحيح الجامع» (١٦٣٢)، وقال محقِّقو طبعةِ الرسالة مِنَ «المُسنَد» (٦/ ١١٠): «صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالةِ ابنِ أخي زينبَ، لكنَّه مُتابَعٌ»] على التَّمائم التي فيها شركٌ، أو هي مَظِنَّتُه كالذي يكون بغير العربيَّة لمَنْ لا يفهم معنى الكلام.
ومنهم مَنْ لم يُرَخِّصْ فيها مُطلَقًا مثل: عبد الله بنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ وغيرِهما مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتابعين، قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ ـ رحمه الله ـ: «كانوا ـ أي: أصحابُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ـ يكرهون التَّمائم كُلَّها مِنَ القرآن وغيرِ القرآن» [أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢٣٤٦٧، ٢٣٤٧١)، والقاسم بنُ سلَّام في «فضائل القرآن» (٣٨٢)]، وهذا هو الأَوْلى بالصَّواب، وبه قال جمهورُ أهل العلم؛ وذلك لِلِاعتبارات الآتية:
· أوَّلًا: أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين فالمَوقفُ الصحيحُ المُتَّخَذُ مِنِ اختلافهم هو التَّخيُّرُ مِنَ القولين بما يوافقُه الدَّليلُ وتدعِّمه الحُجَّةُ؛ قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «...وإذا تَنازَعُوا فالحَقُّ لا يَخرُجُ عنهم، فَيُمكِنُ طَلَبُ الحَقِّ فِي بَعضِ أقاوِيلِهِم، ولا يُحكَمُ بِخَطَإِ قَولٍ مِنْ أقوالِهِم حتَّى يُعرَفَ دَلالَةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَلى خِلافِه»؛ [«مجموع الفتاوى» (١٣/ ٢٤)].
ولا يخفى أنَّه لم يُعلَم عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَنَّه جعَلَ التَّمائمَ سببًا للحفظ مِنَ الشَّيطان والجِنِّ والعين والهوامِّ ونحوِها، مع قيامِ المُقتضي في زمانِه وانتفاءِ الموانعِ، فإذا لم يكن ذلك سببًا لا مِنْ جهة الشَّرع ولا مِنْ جهة الطِّبِّ فلا يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يُعتقَد الجوازُ في التَّمائم مُطلَقًا لأنَّ سببها غيرُ مُعتبَرٍ، ذلك لأنَّ مِنْ خصائصِ القرآنِ أنَّه نزَلَ ليُقرَأ ويُتلى، لا لِيُعلَّقَ على الصُّدورِ والجُدرانِ، والتِّلاوةُ باللِّسانِ هي الحِرزُ الصَّحيحُ وهو سببُ الشِّفاءِ والحفظِ مِنَ الشيطان، كما جاء في الحديث عن آية الكرسيِّ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ» [أخرجه البخاريُّ في «فضائل القرآن» (٥٠١٠) بابُ فضلِ سورة البقرة، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه]، ثمَّ إنَّ كُلَّ عبادةٍ أَطلقَها الشارعُ فلا يجوزُ ـ شرعًا ـ أَنْ يقيِّدَها النَّاسُ بقيودِ المَكانِ أو الزَّمانِ أو الصِّفةِ أو العدَدِ، علمًا أنَّ بعضَ الجُهَّال قد يتعلَّق قلبُه بالتَّمائم مِنَ القرآن، لا لِمُجرَّدِ كونها أسبابًا ـ وهي في الحقيقة ليست سببًا صحيحًا شرعيًّا ولا طِبِّيًّا كما تَقدَّم ـ بل يَعتَقِدُ في ذاتها خاصيَّةَ جلبِ النَّفعِ أو دفعِ الضرِّ، وذلك يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى مُعتقَدٍ فاسدٍ، لذلك وجَبَ المنعُ منه عملًا بمبدإِ سدِّ الذريعة.
· ثانيًا: أنَّ تعليق التَّمائم مِنَ القرآن والأدعية والأذكار المشروعةِ بهذه الصِّفةِ يُعَدُّ عبادةً مِنَ العبادات، لأنَّه نوعٌ مِنَ الاستعاذةِ وطلبِ الحاجةِ بلسان الحال، و«الأصلُ في العبادات: التَّوقيفُ والمنع»، إذ لم يَرِدْ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ ما يُجيزُ هذه الصِّفةَ.
· ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ النَّاهيةَ عن التَّمائمِ جاءت عامَّةً فلا يُخَصُّ منها شيءٌ ولا صفةٌ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ، ولم يأتِ حديثٌ واحدٌ في تخصيصِ فردٍ منها؛ لذلك لا يجوز إحداثُ صورةِ عبادةٍ مُستثناةٍ مِنْ عمومِ المنعِ لا يدلُّ دليلٌ على تخصيصها، بخلاف نصوص الرُّقية.
· رابعًا: عملًا بالأحوط في حكمِ تعليقِ التَّمائمِ مِنَ القرآن والأدعية والأذكار المشروعة، لكونِ حكمِه يتردَّد بين الحِلِّ والحُرمةِ، ولا شكَّ أنَّ الاحتياطَ إنَّما يكونُ في تركِه ومنعِه، وهو الأصلُ الثابتُ في العبادات، ولا نصَّ على الاستثناء، ولا يمكن قياسُه على المستثنى مِنْ منع الرُّقية لظهور الفارق.
· خامسًا: أنَّ تعليقَ التَّمائمِ مِنَ القرآنِ قد يُفضي إلى امتهانِه مِثل أَنْ يدخلَ به إلى الحمَّام عند قضاء الحاجة أو إلى مواضعَ قذرةٍ أخرى، أو ينامَ عليه، ونحوِ ذلك ممَّا تنبغي الحيلولةُ دون الوقوعِ فيه.
· سادسًا:أنَّ تعليقَ التَّمائمِ مِنَ القرآن بَريدٌ إلى تعليقِ التَّمائمِ مِنْ غير القرآن ممَّا يَحرُم فِعلُه باتِّفاقٍ لِتَضمُّنه معصيةً أو شركًا، أو قد تَفتَح البابَ لِيَدَّعيَ كُلُّ مَنْ علَّق تميمةً أنَّها مِنَ القرآن وإِنْ لم تكن منه، لأنَّ غالِبَ التَّمائمِ تكونُ مخفيَّةً داخلَ جِلدٍ أو قُماشٍ ونحوِهما، فيتذرَّعُ بهذه الوسيلةِ لإخفاءِ التَّمائمِ الشِّركيَّة مِنْ جهةٍ، ولا يُنكَرُ عليه فِعلُه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ حملًا للنَّاسِ على السَّلامةِ.
· سابعًا: أنَّ تعليقَ التَّمائمِ طلبًا لدفعِ الضَّرِّ أو تحصيل النفع يُفضي إلى تعليق القلبِ بالتَّميمة، الأمر الذي يُفضي إلى الاتِّكال عليها أو الاكتفاءِ بها، وإهدارِ المطلوب مِنَ العبد فعلُه مِنَ الذِّكر والدُّعاء وقراءةِ القرآن، وهي أدعى إلى تعليقِ القلبِ بالله سبحانه وتعالى، وشتَّان بين مَنْ يَضَعُ مُصحَفًا على مَكتبه ولا يفتحه، وبين مَنْ يقرأ مِنَ المُصحَف أو مِنْ حِفظه.
هذا، وأخيرًا، فإنَّ الصَّحيحَ الرَّاجحَ في المسألة هو: وجوبُ تركِ تعليقِ التَّمائمِ مُطلَقًا مِنَ القرآن وغيره، مع إمكانِ الاستعاضةِ عن ذلك بالرُّقية الشرعيَّة بالقرآنِ والمعوِّذاتِ والأذكارِ المشروعةِ وغيرِها كما ثبَتَ ذلك في أحاديثَ كثيرةٍ. [انظر هذا التفصيل في الفتوى رقم: (١٣٣٢) الموسومة ﺑ: «في حكم تعليق التَّمائم مِنَ القرآن والذِّكر ونحوِهما» على الموقع الرسميِّ].
(١٦) هَنَة [مُفرَد]: مؤنَّثُ الهَنِ جمعُها: هَنَاتٌ وهَنَوَاتٌ: مُعضِلاتٌ وشدائدُ وأمورٌ عظامٌ، أو شرورٌ وفسادٌ، يقال: ليس مِنَ الهَنَات الهيِّنات، أي: ليس ذنبًا صغيرًا؛ [انظر: «تاج العروس» للزَّبيدي (٤٠/ ٣١٩)، «معجم اللغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (٣/ ٢٣٧١)].
ليس مرادُ المصنِّف ـ رحمه الله ـ في قوله: «الهَنَات الهيِّنات» استصغارُ البِدَع ومُحدَثات الأمور التي جنسُها أعظمُ مِنْ جنس المعاصي والتَّهوينُ مِنْ شأنها، قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ في [«الاعتصام» (٢/ ٥٥٧)] عن شرطِ البدعةِ: «أَنْ لا يستصغرَها ولا يستحقرَها ـ وإِنْ فرَضْناها صغيرةً ـ فإنَّ ذلك استهانةٌ بها، والاستهانةُ بالذَّنبِ أعظمُ مِنَ الذَّنبِ، فكان ذلك سببًا لعِظَمِ ما هو صغيرٌ»، ثُمَّ بيَّن أنَّ الذَّنبَ كلَّما استعظمَه العبدُ مِنْ نفسِه صَغُرَ عند اللهِ، وكلَّما استصغَرَه كَبُرَ عند الله؛ لأنَّ استعظامَ الذَّنبِ إنَّما ينبعِثُ مِنْ كراهةِ القلبِ له ونفورِه مِنه؛ وذلك النُّفورُ يَحولُ دون تأثُّرِه به، بخِلافِ استصغارِ الذَّنبِ فإنَّما ينبعِثُ عن تعوُّده والأُنسِ به، وإنَّما وصَفَها المصنِّف ـ رحمه الله ـ بما هو وصفٌ لأهلها مِنَ الهوانِ والمَهانةِ لأنَّهم لم يطلبوا العِزَّةَ مِنْ أسبابها ولم يسلكوا إليها سُبُلَها المشروعة، ولم يأتوا البيوتَ مِنْ أبوابها، وذلك ـ بلا شكٍّ ـ ليس مِنَ البِّرِ والتَّقوى؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٨٩﴾ [البقرة]؛ فمَنْ أراد الفلاحَ فعليه بالتَّقوى؛ فإنَّ التَّقوى لا يُدركُ باقترافِ المنكراتِ والمعاصي، وإنَّما بالخوفِ مِنَ الله تعالى وفِعلِ المَأمور واجتنابِ المَحظور هو بابُ الفلاح.
(١٧) رضَخَ له: أعطاه قليلًا، وبابُه قطَعَ، [«مختار الصِّحاح» للرازي (١٢٣)]، والمعنى: يبذلون ما استطاعوا مِنْ قليلٍ أو كثيرٍ مِنَ الأموال والرِّجال والمكرِ والاحتيال.
(١٨) احتقبه واستحقبه بمعنًى أي: احتمله (أي: حمَلَه)، ومنه قِيلَ: احتقب فلانٌ الإثمَ؛ [«الصِّحاح» للجوهري (١/ ١١٤)].
(١٩) الوَغْرَةُ: شدَّةُ توقُّدِ الحرِّ، ومنه قِيلَ: في صدره عليَّ وَغْرٌ بالتسكين، أي: ضِغْنٌ وعداوةٌ وتوقُّدٌ مِنَ الغيظ؛ والمصدر بالتحريك، تقول: وَغِرَ صدرُه عليَّ يَوْغَرُ وَغَرًا: فهو واغِرُ الصدرِ عليَّ، وقد أوْغَرْتُ صدرَه على فلانٍ أي: أحميتُه مِنَ الغيظ، وأوْغَرْتُ الماءَ أي: أغلَيْتُه؛ [«الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٨٤٦)].
(٢٠) اللَّهَوات: جمعُ لَهَاةٍ، وهي اللَّحَماتُ في سقفِ أقصى الفم؛ [«النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٨٤)].
(٢١) لعل المصنِّف يقصد بعبارته: «وأبقى لهم منه المُقيمَ المُقعِدَ» بمعنى: أبقى لهم مِنَ الحقد والغِلِّ والحسد والمكر والاحتيال ما يُقيمهم ويُقعِدهم؛ أي: يُزعِجهم ويُقلِقهم.
(٢٢) الشَّلَّاءُ على وزنِ فَعْلاءَ: مؤنَّثُ الأشلِّ: وزنِ أَفعَلَ مِنَ الشَّلل.
(٢٣) أي: يُحترَف به للتَّكسُّبِ في الرقية بالقرآن مِنْ حُمَةِ كُلِّ ذي حُمَةٍ أو في غيرها.
والحقيقة أنَّ ـ في هذه المسألة ـ فرقًا بين أخذِ العِوضِ أو الأجرةِ على الرُّقيةِ الشَّرعيةِ وبين اتِّخاذِ الرُّقيةِ حرفةً يُتكسَّبُ بها، وقد بيَّنتُ هذه المسألةَ مفصَّلةً في فتوَى على الموقع موسومةٍ ﺑ «اشتراط العوض عن الرقية» برقم: (٨٨٨).
(٢٤) وقوله ـ رحمه الله ـ: «وليس مِنَ المَقاصِد التي أُنزِلَ لتحقيقها:... الاستشفاءُ به مِنَ الأمراض الجسمانيَّة» غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ مِنْ خصائص القرآن الكريم وميزاتِه أنَّه شفاءٌ ورحمةٌ لجميعِ الأمراض الحِسِّيَّةِ والمَعنويَّةِ لثبوت العلاج به مِنْ ذلك في الرُّقية بالقرآن والأدعية الأذكار مِنْ حُمَةِ كُلِّ ذي حُمَةٍ، وفي ذلك تنبيهٌ على جدواه في علاجِ كثيرٍ مِنَ الأدواء بإذن الله كما ثبَتَ بالتَّجربة: فهو شفاءٌ لأمراضِ الأبدان وأعراضِ الأجسام وأدوائها، وشفاءٌ لأمراض القلوب والنُّفوسِ والعُقول؛ فهو شفاءٌ مِنَ الكفر والشِّرك، والحيرةِ والخوف، والقلقِ والاضطراب، والكِبْرِ والحسد، والعجزِ والكسل، والظُّلمِ والجَوْر، والبخلِ والشُّحِّ؛ فهو شفاءٌ بالتَّذكير والموعظةِ الدَّاعيةِ إلى اكتسابِ كُلِّ فضيلةٍ، والزَّاجرةِ عن كُلِّ رذيلةٍ، قال تعالى: ﴿قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧]، وهذا الشِّفاء خاصٌّ بالمؤمنين بالقرآن، المصدِّقين بآياته، العالِمِين والعامِلين به، أمَّا الظالمون الجاحدون به فإنَّ الحجَّة تقوم عليهم به ولا تزيدهم آياتُه إلَّا خسارةً، قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ٨٢﴾ [الإسراء]؛ [انظر: الكلمة الشهرية على الموقع الرسميِّ برقم: (١٠٠) الموسومة ﺑ: «منزلة القرآن الكريم وخصائصُه بين المُنْتفِع بآياته والجاحد لها»].
(٢٥) الغَمْرة بوزن الجمرة: الشِّدَّةُ والزَّحمةُ؛ والجمعُ: غُمَرٌ بفتح الميم كنَوْبة ونُوَبٍ؛ يقال: خاض غَمَراتِ القتال: اقتحم أهوالَه، غِمار الحياة: تقلُّباتها، غَمَرات الموت: شدائده ومكارهه، سكراته، وغِمار النَّاس: جمعُهم المزدحم؛ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٨٤)، «مختار الصحاح» للرازي (٢٢٩)، «معجم اللغة العربيَّة المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (٢/ ١٦٤١)].
(٢٦) اعتوروا الشيءَ أي: تَداولوه فيما بينهم، وكذلك تعوَّروه وتَعاوَرُوه، [«الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٧٦٢)] والمعنى: أنه تتنازعه أو تتداوله وتتقاذفه نزعتان وتتناوبان عليه.
(٢٧) قالَ ابنُ القَيِّمِ ـ رحمه الله ـ في [«الجَوابِ الكافي» (١٢٩)] ما نصُّهُ:
«الشِّركُ شِركانِ:
· شِركٌ يَتَعَلَّقُ بِذاتِ المَعبودِ وأسمائِهِ وصِفاتِهِ وأفعالِهِ.
· وشِرْكٌ فِي عِبادَتِهِ ومُعامَلَتِهِ، وإِنْ كانَ صاحِبُهُ يَعْتَقِدُ أنَّهُ سُبْحانَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فِي ذاتِهِ، ولا فِي صِفاتِهِ، ولا فِي أفعالهِ.
والشِّرْكُ الأوَّلُ نَوعانِ:
أحَدُهُما: شِركُ التَّعطيلِ: وهُوَ أقبحُ أنواعِ الشِّركِ، كَشركِ فِرعونَ إذ قال: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٣﴾ [الشُّعَراءِ]؛ وقال تعالى مُخبرًا عنهُ أنَّهُ قالَ لِهامانَ: ﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ٣٦ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗا﴾ [غافِرٍ: ٣٦ ـ ٣٧].
فالشِّركُ والتَّعطيلُ متلازمان: فَكُلُّ مشركٍ مُعَطِّلٌ، وكُلُّ مُعَطِّلٍ مشركٌ، لكنَّ الشِّركَ لا يستلزمُ أصلَ التَّعطيلِ، بل يكونُ المُشركُ مُقِرًّا بالخالقِ سبحانَه وصِفَاتهِ، ولكنَّهُ مُعَطِّلٌ حَقَّ التَّوحيدِ.
وأصل الشِّركِ وقاعدتهُ التي يرجعُ إليها هو التَّعطيلُ، وهو ثلاثةُ أقسامٍ:
ـ تعطيل المَصنوع عن صانعهِ وخالقهِ.
ـ وتعطيلُ الصَّانع سبحانَهُ عن كماله المقدَّسِ، بتعطيلِ أسمائهِ وصِفَاتهِ وأفعالِهِ.
ـ وتعطيلُ معاملتِهِ عمَّا يجبُ على العبدِ مِنْ حقيقةِ التَّوْحيدِ...
النَّوْعُ الثَّانِي: شِركُ مَنْ جعَلَ معهُ إلهًا آخَرَ، ولم يُعَطِّلْ أسماءَهُ وصِفاتِهِ وربوبيَّتَهُ، كَشِركِ النَّصارى الذينَ جعلوهُ ثلاثةً، فَجعلُوا المَسيحَ إلهًا، وأُمَّهُ إلهًا.
ومِنْ هذا شِركُ المجوسِ القائلينَ بإسنادِ حوادثِ الخيرِ إلى النُّورِ، وحوادثِ الشَّرِّ إلى الظُّلمةِ؛ ومِنْ هذا شِركُ القَدَريَّةِ القائلينَ بأنَّ الحيوان هو الذي يخلقُ أفعالَ نفسهِ، وأنَّها تحدثُ بدونِ مشيئةِ اللهِ وقدرتهِ وإرادتهِ، ولهذا كانوا مِنْ أشباهِ المَجُوس؛ ومِنْ هذا شِركُ الذي حاجَّ إبراهيمَ في رَبِّهِ: ﴿إِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٥٨]» [بتصرُّف].
ثمَّ تعرَّض ـ رحمه الله ـ لذكرِ فصلٍ يتعَلَّقُ بالشِّركِ في العِبادةِ، وبَيانِ أقسامهِ.
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 21061 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)