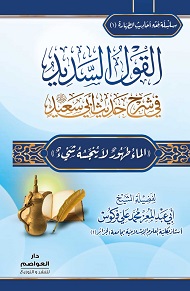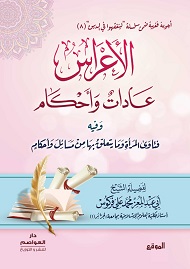العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
التصفيف الخامس والخمسون:
[الباب الثاني عشر]
عقائد الإيمان باليومِ الآخِر
ـ ٣ ـ
[الفصل ٧٥: وزنُ الأعمال والجزاءُ عليها](١)
نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْصِبُ المِيزَانَ ـ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ فَتُوزَنُ أَعْمَالُ العِبَادِ لِيُجَازَوْا عَلَيْهَا(٢) وَيقْتَصَّ مِنْ بَعْضِهِمُ البَعْض، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عُذِّبَ(٣)؛ إِذْ ذَاكَ وَاجِبٌ فِي عَدْلِ اللهِ(٤)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾ [الأنبياء]، وَلِقَوْلِهِ(٥): ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾ [الزلزلة]، وَلِقَوْلِهِ(5): ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ٧ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ٩﴾ [القارعة]، وَلِقَوْلِهِ(5): ﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّئَِّاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءٗ(٦) مَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢﴾ [الجاثية]، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ(٧) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ(٨)؟» قَالُوا: «المُفْلِسُ(8) فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ»، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ(8) مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي(٩) يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ(١٠) شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ(١١) فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١٢)(١٣)(١٤).
ـ يُتبَع ـ
(١) «م.ر»: بزيادةِ عنوانٍ فرعيٍّ: «الميزانُ».
(٢) بيَّن المصنِّف ـ رحمه الله ـ أنَّ الله تعالى بعد أَنْ يبعث عِبادَه ـ يومَ القيامة ـ إلى الموقف الأعظم حيث يجري القضاءُ الإلهيُّ، وتُعْطى الكُتُبُ التي يدور الحسابُ على محتوياتها، فيأخذُها المؤمن بيمينه والكافرُ بشماله وراءَ ظهره، فيقع ـ عند ذلك ـ أمرٌ عظيمٌ آخَرُ وهو نَصْبُ الموازين بالقسط بالغةِ الدقَّةِ في الحساب إلى منتهى ما يمكن أَنْ يُتصوَّر، وتُحْصى الأعمالُ جميعُها، فلا يُتْرَكُ منها عملُ خيرٍ أو شرٍّ ـ وإِنْ قلَّ أو دقَّ ـ إلَّا وخضع لموازين العدل ذاتِ الدِّقَّة المُتناهِيَة؛ ليُجازى بها صاحبُ الأعمالِ بالقسط؛ تحقيقًا للعدل الإلهيِّ بأكمل وجهه؛ فلا تُظْلَمُ نفسٌ مسلمةٌ أو كافرةٌ شيئًا لا بنقصانٍ مِنْ حسناتها ولا بزيادةٍ في سيِّئاتها تحت قضاء الله وحُكمِه، العالمِ بأعمال العباد، الحافظِ لها، والمُثْبِتِ لها في كتابٍ مُبينٍ، لا يضيع منها شيءٌ، ولا يمكن أَنْ يزول منها شيءٌ؛ فاللهُ عالمٌ بمَقاديرِها ومقاديرِ ثوابها وعقابها، في كتابٍ يستحضر جميعَ الأعمال مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نقصٍ؛ ﻓ: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ [الكهف]؛ قال تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩﴾ [الجاثية].
وبحسَبِ نتيجةِ الوزن في رجحان الميزان بالعمل الصالح أو نقصانِه أو فقدانِه تظهر عاقبةُ أهل السعادة مِنْ أهل الشقاء؛ وقد بيَّن اللهُ تعالى هذه الحقيقةَ بقوله: ﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بَِٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩﴾ [الأعراف]، وقولِه تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣ تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ ١٠٤ أَلَمۡ تَكُنۡ ءَايَٰتِي تُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٥﴾ [المؤمنون]، وقولِه تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾ [الأنبياء]؛ فأخبر الله تعالى «أنه يضع الموازينَ القِسْطَ ليوم القيامة؛ فتُوزَنُ أعمالُهُم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف، فلا يظلم اللهُ أحَدًا شيئًا، وأنَّ عمله مِنَ الخير والشر ـ وإِنْ كان في غاية القلَّة والدقَّة كمثقالِ حبَّةٍ مِنْ خردلٍ ـ فإنَّ الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى عليه شيءٌ، وكفى به ـ جلَّ وعلَا ـ حاسبًا؛ لإحاطةِ علمِه بكُلِّ شيءٍ» [«أضواء البيان» للشنقيطي (٤/ ٥٨٣)].
فما يقتضيه العدلُ الإلهيُّ في هذه الدار والدارِ الآخرة أنه لا مُساواةَ بين الأبرار الذين قاموا بحقوق ربِّهم، واجتنبوا مَساخِطَه، ولم يزالوا مُؤْثِرين رِضاهُ على هوَى أنفُسِهم، وبين الفُجَّار المُكْثِرين مِنَ الذنوب، المُقصِّرين في حقوق ربِّهم؛ فالأبرارُ المؤمنون العاملون للصالحات لهم النصرُ والتمكين والفلاح والثواب والسعادةُ في الدارين، كُلٌّ على قَدْرِ إحسانه.
وأمَّا الفُجَّار العاملون للسيِّئات فلهم السخطُ والغضب والمقت واللعنة والإهانة والخزي والعذاب والشقاءُ في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّئَِّاتِ أَن نَّجۡعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءٗ مَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢﴾ [الجاثية].
وما تقدَّم مِنَ الآيات الكثيرة تُثْبِتُ الميزانَ على حقيقته بلا تأويلٍ؛ ويدلُّ عليه مِنَ السُّنَّة النبويَّةِ الصحيحة: قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الدعوات» (١١/ ٢٠٦) بابُ فضلِ التسبيح، وفي «الأيمان والنذور» (١١/ ٥٦٦) باب: إذا قال: واللهِ لا أتكلَّمُ اليومَ، فصلَّى أو قرَأ أو سبَّح أو كبَّر أو حَمِد أو هلَّل؛ فهو على نِيَّتِه، وفي «التوحيد» (١٣/ ٥٣٧) باب قول الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ومسلمٌ في «الذِّكْر والدعاء والتوبة والاستغفار» (١٧/ ١٩) بابُ فضلِ التهليل والتسبيح والدعاء، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه]، وغيرُه مِنَ الأحاديث المُثْبِتة للميزان، والتي بلَغَتْ مَبْلَغَ التواتر، وانعقد إجماعُ أهل الحقِّ مِنَ المسلمين عليه، [انظر: «لوامع الأنوار البهيَّة» للسفَّاريني (٢/ ١٨٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٥٣٨)].
هذا، وقد أنكرَتِ المعتزلةُ ومَنْ وافقهم الميزانَ بعقولهم، وتأوَّلوه بالعدل حملًا على المجاز، وقالوا: إنَّ الله لا يحتاج إلى الميزان لتقويم الأعمال مِنْ جهةٍ، وإنَّ الأعراض يستحيل وزنُها إذ لا تقوم بنفسها مِنْ جهةٍ أخرى؛ فخالفوا ـ بذلك ـ صريحَ الكتاب والسُّنَّة.
وأهل الحقِّ مِنْ أهل السُّنَّة إذ يُثْبِتون الميزانَ فهُمْ لا يُثْبِتونه مِنْ مُنطَلَقِ حاجة الله إليه ـ سبحانه ـ فاللهُ هو الغنيُّ الحميد، وهو أعلمُ بعباده وما يعملونه مِنْ خيرٍ أو شرٍّ، ولكنَّه ـ سبحانه ـ أخبر أنه يضع الموازينَ لوزنِ الأعمال ـ حقيقةً ـ ليرى العبادُ أعمالَهُم ممثَّلةً ليكونوا على أَنْفُسهم شاهدين، واللهُ تعالى قادرٌ على جعلِ الأعراض ـ بحدِّ ذاتها ـ تقبل الوزنَ، كما هو قادرٌ على قلب الأعراض أجسامًا فيَزِنُها، وليس في قلبِ العَرَضِ إلى جسمٍ إحالةٌ عقليَّةٌ؛ فاللهُ لا يُعْجِزه شيءٌ، وقدرتُه ـ سبحانه ـ أعظمُ مِنْ كُلِّ شيءٍ، ولا يجوز أَنْ تُجْعَلَ السُّنَنُ الكونيَّة المُشاهَدةُ في الحياة الدنيا مقياسًا في كُلِّ شيءٍ، وقد صحَّتْ عِدَّةُ أحاديثَ تدلُّ على قلب المعاني إلى محسوساتٍ والأعراضِ إلى أجسامٍ.
فمِنْ نظائرِ ذلك:
• مجيء العمل الصالح في صورةِ رجلٍ حَسَنِ الوجه، كما في حديثِ البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «وَيَأْتِيهِ ـ أي: المؤمنَ ـ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: «أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ»، فَيَقُولُ لَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالخَيْرِ»، فَيَقُولُ: «أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ»»، وذَكَر عَكْسَه في شأن الكافر والمنافق؛ [أخرجه أبو داود في «السُّنَّة» (٥/ ١١٤) بابٌ في المسألة في القبر وعذابِ القبر، وأحمد في «مسنده» (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨، ٢٩٥ ـ ٢٩٦) واللفظُ له، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧ ـ ٣٨). والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «أحكام الجنائز» (١٥٩)].
• مجيء القرآن في صورة شابٍّ شاحبٍ؛ ويدلُّ عليه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ» [أخرجه ابنُ ماجه في «الأدب» (٢/ ١٢٤٢) بابُ ثواب القرآن، مِنْ حديثِ بُرَيْدةَ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٢/ ٧٩٢) رقم: (٢٨٢٩) و«صحيح ابن ماجه» (٣/ ٢٣٩)].
• مجيء البقرة وآل عمران كأنَّهما غمامتان، ويدلُّ عليه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «اقْرَءُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: البَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا» [أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٦/ ٩٠) بابُ فضلِ قراءة القرآن وسورةِ البقرة، مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه].
• الموت في ذاته ـ وهو معنًى وليس بجسمٍ ـ يصيِّره اللهُ تعالى بقدرته ـ يومَ القيامة ـ جسمًا يُشاهَدُ ويُرى؛ فقَدْ صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنه قال: «يُجَاءُ بِالمَوْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ ـ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الحَدِيثِ ـ فَيُقَالُ: «يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟» فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: «نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ»»، قَالَ: «وَيُقَالُ: «يَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟»» قَالَ: «فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: «نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ»»، قَالَ: «فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: «يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ»»، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ﴿وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ٣٩﴾ [مريم] [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التفسير» (٨/ ٤٢٨) باب: ﴿وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ﴾ [مريم: ٣٩]، ومسلمٌ في «الجنَّة وصفة نعيمها» (١٧/ ١٨٤) بابُ جهنَّمَ ـ أعاذنا الله منها ـ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه].
ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ مجيء القرآن في هذه الصورة إنما المقصودُ منه الإخبارُ عن قراءة القارئ التي هي عملُه، وذلك هو ثوابُ قارئِ القرآن، وليس المرادُ أنَّ كلامَ اللهِ نَفْسَه هو الذي يتصوَّرُ في صورةِ شابٍّ أو صورةِ غمامتين؛ قال الحَكَميُّ ـ رحمه الله ـ في [«معارج القَبول» (٢/ ٨٤٦)]: «لا مانعَ مِنْ كون الآتي هو العملَ نَفْسَه كما هو ظاهرُ الحديث؛ فأمَّا أَنْ يقال: إنَّ الآتيَ هو كلامُ اللهِ نفسُه فحاشا وكلَّا ومَعاذَ الله؛ لأنَّ كلامه تعالى صفتُه ليس بمخلوقٍ، والذي يُوضَعُ في الميزان هو فعلُ العبدِ وعملُه، ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافَّات]»، هذا مِنْ جهةٍ.
وتدلُّ الأحاديث السابقة ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ على قدرة الله تعالى على قلب الأعراض والمعاني إلى أجسامٍ ومحسوساتٍ تُشاهَدُ وتَقْبَلُ الوزنَ؛ وقد أفصح ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ عن ذلك في [«فتح الباري» (١٣/ ٥٣٩)] بقوله: «والحقُّ عند أهل السُّنَّة: أنَّ الأعمال ـ حينئذٍ ـ تُجسَّدُ أو تُجْعَلُ في أجسامٍ فتصيرُ أعمالُ الطائعين في صورةٍ حسنةٍ، وأعمالُ المسيئين في صورةٍ قبيحةٍ، ثمَّ تُوزَن».
لذلك كان قولُ المعتزلة غيرَ مُعتبَرٍ لا يُلتفَتُ إليه؛ وأختم الجوابَ عنهم بقولِ ابنِ أبي العزِّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح الطحاويَّة» (٤٧٥)]: «ولو لم يكن مِنَ الحكمة في وزن الأعمال إلَّا ظهورُ عدله ـ سبحانه ـ لجميع عباده؛ فإنه لا أحَدَ أحبُّ إليه العذرُ مِنَ الله؛ مِنْ أجلِ ذلك أرسل الرُّسُلَ مبشِّرين ومُنْذِرين؛ فكيف ووراء ذلك مِنَ الحِكَمِ ما لا اطِّلاعَ لنا عليه؟!».
وإذا ثَبَت أنَّ الميزان حقيقةٌ لا مجازٌ، فقَدِ اختلف العلماءُ في لفظ الجمع المذكور في الآيات القرآنيَّة السابقة: هل المُرادُ: أنَّ لكُلِّ شخصٍ عاملٍ موازينَ يُوزَنُ بكُلٍّ منها صنفٌ مِنْ أعماله فيكون الجمعُ حقيقةً، وهو ظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وإلى هذا القول ذَهَب بعضُ أهل العلم؛ أم ليس هناك إلَّا ميزانٌ واحدٌ، والجمعُ باعتبارِ تعدُّد الأشخاص والأعمال، وبهذا قال الجمهورُ؛ [انظر: «تفسير القرطبي» (١١/ ٢٩٣)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٥٣٧)، وانظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيميَّة (٦/ ٥٧٥)]؛ ورجَّح الشنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ مذهبَ الأقَلِّين حملًا على الحقيقة وهي ظاهرُ القرآن، وهو أنَّ للعامل الواحدِ موازينَ يُوزَنُ بكُلِّ واحدٍ منها صنفٌ مِنْ أعماله، حيث قال ـ رحمه الله ـ في [«أضواء البيان» (٤/ ٥٨٥)]: «والقاعدة المقرَّرةُ في الأصول: أنَّ ظاهِرَ القرآنِ لا يجوز العدولُ عنه إلَّا بدليلٍ يجب الرجوعُ إليه؛ وقال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في تفسيرِ هذه الآيةِ الكريمة: الأكثرُ على أنه إنما هو ميزانٌ واحدٌ، وإنما جُمِع باعتبارِ تعدُّدِ الأعمال الموزونةِ فيه» [انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٨٠)].
قلت: وافق ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ مذهبَ الجمهورِ في [«فتح الباري» (١٣/ ٥٣٨)] فقال: «والذي يترجَّح أنه ميزانٌ واحدٌ، ولا يُشْكل بكثرةِ مَنْ يُوزَنُ عملُه؛ لأنَّ أحوال القيامة لا تُكيَّفُ بأحوال الدنيا»؛ ويشهد له دليلٌ مِنَ السُّنَّة في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِنْ حديثِ سلمان رضي الله عنه: «يُوضَعُ المِيزَانُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ لَوَسِعَتْ، فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ: «يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟» فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: «لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي»، فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ: «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ»، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدَّ المُوسَى فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ: «مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا؟» فَيَقُولُ: «مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي»، فَيَقُولُ: «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ»» [أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٨٦). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦١٩)].
وإلى هذا الترجيحِ ذَهَب ـ أيضًا ـ ابنُ العثيمين ـ رحمه الله ـ حيث يقول في [«شرح العقيدة الواسطيَّة» (٢/ ١٣٩)]: «ولكنَّ الذي يظهر ـ واللهُ أعلمُ ـ أنَّ الميزان واحدٌ، وأنه جُمِع باعتبار الموزون؛ بدليلِ قوله تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ﴾ [الأعراف: ٨؛ المؤمنون: ١٠٢]؛ لكِنْ يتوقَّف الإنسانُ: هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأُمَمِ أو لكُلِّ أمَّةٍ ميزانٌ؟ لأنَّ الأُمَمَ ـ كما دلَّتْ عليه النصوصُ ـ تختلف باعتبارِ أجرِها».
هذا، وقد دلَّتِ الآثارُ الصحيحة على أنَّ الميزان حقيقيٌّ لا مجرَّدُ العدل، وله كِفَّتان حسِّيَّتان مُشاهَدتان تميلان بالأعمال، وهو مُجْمَعٌ عليه عند أهل السُّنَّة؛ وأنَّ الوزن يجري على ظاهره، وهو أنَّ الثقيل الراجح مِنَ الكِفَّتين هو الذي ينزل؛ ويدلُّ عليه حديثُ البطاقة الذي سيأتي [في الموضعين: الأوَّل والثاني]؛ فإنَّ السِّجِلَّات تطيش وتثقل البطاقة؛ فظَهَر أنَّ الرجحان يكون بالنزول؛ قال السفَّارينيُّ ـ رحمه الله ـ في [«لوامع الأنوار البهيَّة» (٢/ ١٨٨)]: «ظواهرُ الآثار وأقوال العلماء: أنَّ كيفيَّة الوزن في الآخرة ـ خفَّةً وثِقَلًا ـ مثلُ كيفِيَّتِه في الدنيا، ما ثَقُلَ نَزَل إلى أسفلَ ثمَّ يُرْفَعُ إلى عِلِّيِّينَ، وما خفَّ طاشَ إلى أعلى ثمَّ نَزَل إلى سِجِّينٍ، وبه صرَّح جموعٌ منهم القرطبيُّ».
وأمَّا الموزون فقَدِ اختلفَتْ فيه آراءُ أهل العلم على ثلاثةِ وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّ الموزون هو العمل نفسُه، بحيث تُحالُ مِنْ أعراضٍ إلى أجسامٍ فتُوزَنُ، ويدلُّ عليه:
• قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» [تقدَّم تخريجه].
• وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ..» [أخرجه مسلمٌ في «الطهارة» (٣/ ٩٩ ـ ١٠٠) بابُ فضلِ الوضوء، مِنْ حديثِ أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه].
• وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ» [أخرجه أبو داود في «الأدب» (٥/ ١٥٠) باب [في] حُسْن الخُلُق، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلة» (٤/ ٣٦٢) بابُ ما جاء في حُسْن الخُلُق، مِنْ حديثِ أبي الدرداء رضي الله عنه. قال الترمذيُّ: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» برقم: (٨٧٦)].
كما يشهد له ـ أيضًا ـ ما تقدَّم ذِكْرُه مِنْ مجيءِ القرآن ـ يومَ القيامة ـ في صورةِ شابٍّ شاحبِ اللون، وأنَّ البقرةَ وآلَ عمران تأتيان كأنهما غمامتان، [تقدَّم تخريجه].
فهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ الموزون هو فعلُ العبد وعملُه، وهو ما رجَّحه ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في [«الفتح» (١٣/ ٥٣٩)] بقوله: «والصحيح أنَّ الأعمال هي التي تُوزَن».
الثاني: أنَّ الموزون هو صحائف الأعمال: ويدلُّ عليه حديثُ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟» فَيَقُولُ: «لَا يَا رَبِّ»، فَيَقُولُ: «أَفَلَكَ عُذْرٌ؟» فَيَقُولُ: «لَا يَا رَبِّ»، فَيَقُولُ: «بَلَى إِنَّ لَكَ ـ عِنْدَنَا ـ حَسَنَةً؛ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ»، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَيَقُولُ: «احْضُرْ وَزْنَكَ»، فَيَقُولُ: «يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟!» فَقَالَ: «إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ»»، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ؛ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ؛ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ» [أخرجه الترمذيُّ في «الإيمان» (٥/ ٢٤) بابُ ما جاء فيمَنْ يموت وهو يشهد أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، والحاكم في «المستدرَك» (١/ ٦)، ورواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢١٣)، وابنُ ماجه (٢/ ١٤٣٧) بلفظٍ متقاربٍ. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٥٢) رقم: (١٣٥)].
وظاهرُ الحديث: أنَّ الذي يُوزَنُ صحائفُ الأعمال، وهو ما رجَّحه القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في [«التذكرة» (٣٧٧)] والسفَّارينيُّ ـ رحمه الله ـ في [«لوامع الأنوار البهيَّة» (٢/ ١٨٧)] وقال: «والحقُّ ما قدَّمْناه: أنَّ الموزون صُحُفُ الأعمال، وصحَّحه ابنُ عبد البرِّ والقرطبيُّ وغيرُهما».
والحديثُ يدلُّ ـ أيضًا ـ أنَّ الميزان له كِفَّتان حسِّيَّتان مُشاهَدتان، وأنه يميل بإحدى الكِفَّتَيْن رجحانًا بالنزول؛ «أمَّا كيفيَّةُ تلك الموازينِ فهو بمنزلةِ كيفيَّةِ سائرِ ما أخبرنا به مِنَ الغيب» [«مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٤/ ٣٠٢)].
الثالث: أنَّ الموزون هو العامل نفسُه: ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ ـ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ لَا يَزِنُ ـ عِنْدَ اللهِ ـ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»، وَقَالَ: «اقْرَءُوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا١٠٥﴾ [الكهف]» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التفسير» (٨/ ٤٢٦) باب: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ﴾ [الكهف: ١٠٥]، ومسلمٌ في «صفة القيامة والجنَّة والنار» (١٧/ ١٢٩)].
وما روى أحمد عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ القَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مِمَّ تَضْحَكُونَ؟» قَالُوا: «يَا نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ» [أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٤٢٠) وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٤٣). وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٦/ ٣٩) رقم: (٣٩٩١)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ١/ ٥٨٢) برقم: (٣١٩٢)].
هذا، والمتأمِّلُ في الأدلَّة الشرعيَّة المتقدِّمة التي استدلَّ بها العلماءُ على مذهبهم يُدْرِك ـ مِنْ جهةٍ ـ أنَّ كُلًّا مِنَ: العمل والعامل وصحائفِ العملِ تُوزَنُ في ميزان الله تعالى، وأنه لا سبيلَ إلى معرفةِ ما وراء ذلك مِنْ هذه الكيفيات؛ فاللهُ أعلمُ بها، [انظر: «شرح الطحاويَّة» لابن أبي العزِّ (٤٧٥)].
والظاهر أنَّ النصوص الشرعيَّة المتقدِّمة لا منافاةَ بينها ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لإمكانيَّةِ الجمع بين الأدلَّة التي ظاهرُها التعارضُ: إمَّا بالجمع باعتبار الأشخاص؛ إذ يمكن أَنْ يقال: إنَّ مِنَ الناس مَنْ يُوزَنُ عملُه، ومنهم مَنْ يُوزَن هو بنفسه في حدِّ ذاته، ومنهم مَنْ تُوزَنُ صحائفُ عملِه.
وإمَّا أن يكون الجمعُ باعتبار الأحوال، وهو ما ذَهَب إليه ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في [«تفسيره» (٢/ ٢٠٢)] بقوله: «وقد يمكن الجمعُ بين هذه الآثار بأَنْ يكون ذلك كُلُّه صحيحًا: فتارةً تُوزَنُ الأعمالُ، وتارةً تُوزَنُ مَحالُّهَا، وتارةً يُوزَنُ فاعلُها».
وإمَّا أَنْ يكون الجمعُ بضمِّ العمل والعامل وصحائفِ العمل كُلِّها في الميزان، أي: بجمعِ ما تَفرَّق ذِكْرُه في سائر أحاديث الوزن، وهو ما ذَكَره الحَكَميُّ ـ رحمه الله ـ في [«معارج القَبول» (٢/ ٨٤٩)] بقوله: «ويدلُّ لذلك ما رواهُ أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بنِ عمرٍو في قصَّةِ صاحبِ البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «تُوضَعُ المَوَازِينُ ـ يَوْمَ القِيَامَةِ ـ فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ وَيُوضَعُ مَا أُحْصِيَ عَلَيْهِ فَيمايل بِهِ المِيزَانُ»، قال: «فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ»، قال: «فَإِذَا أَدْبَرَ إِذَا صَائِحٌ ـ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: «لَا تَعْجَلُوا؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ»، فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ حَتَّى يَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ» [أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٢١). والحديث صحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (١٢/ ٢٣)، وقوَّاه الأرناؤوط في تخريجه ﻟ: «المسند» (١١/ ٦٣٧)]؛ فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ العبد يُوضَعُ هو وحسناتُه وصحيفتُها في كِفَّةٍ، وسيِّئاتُه مع صحيفتها في الكِفَّة الأخرى؛ وهذا غايةُ الجمع بين ما تَفرَّق ذِكْرُه في سائر أحاديث الوزن».
وفي هذه المسألةِ أقوالٌ أخرى.
وتَرِدُ ـ في هذا الباب أيضًا ـ مسألةُ عمل الكافر: هل يُوزَنُ أم لا؟
فقَدْ ذَهَب فريقٌ مِنْ أهل العلم إلى أنَّ في ظواهر الآيات القرآنيَّة إخبارًا بوزن أعمال الكُفَّار؛ لدخولهم في عموم المعنيِّين بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ٩﴾ [القارعة]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣﴾ [المؤمنون]، وغيرِها مِنَ الآيات الدالَّة على أنَّ عمل الكافر يُوزَنُ مع خِفَّتِه، وذلك لفقدانه الحسناتِ كُلِّيَّةً، ومآلُ ذلك إلى خسران نفسِه وأهله ومالِه؛ فلم يَستفِدْ مِنْ وجوده في الدنيا إلَّا الضررَ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ [الزُّمَر: ١٥]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾ [التوبة: ٥٤].
وذَهَب فريقٌ آخَرُ إلى القول بأنَّ الكافر لا ثوابَ له؛ فليس له حسناتٌ تُوزَنُ في الكِفَّة الأخرى في مُقابَلةِ سيِّئاته، بل لم يكن له إلَّا السيِّئاتُ، ومَنْ لا حسنةَ له فهو في النار؛ لقوله تعالى: ﴿قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥﴾ [الكهف]؛ ذلك لأنَّ فائدة الوزن: مقابَلةُ الحسنات بالسيِّئات، والنظرُ في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسناتِ لهم لانعدامِ شرطِها وهو الإيمانُ؛ لذلك كان جزاؤهم بطلانَ أعمالهم، ولا يُقامُ لهم يومَ القيامة وزنٌ لحقارتهم وخِسَّتهم بكفرهم بآياتِ الله واتِّخاذِهم آياتِ الله ورُسُلَه سخريةً وهُزُوًا، [انظر: «التذكرة» للقرطبي (٣٧٤)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٥٣٨)، «أضواء البيان» للشنقيطي (٤/ ١٩٤)].
والذي يظهر أنَّ سبب الخلاف بين الفريقين مبنيٌّ على مسألةِ: هل الكُفَّارُ مخاطَبون بفروع الشريعة ومُحاسَبون بها ومجزيُّون على الإخلال بها أم لا؟
قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في [«التذكرة» (٣٧٣)]: «ثَبَت أنَّ الكُفَّار يُسألون عمَّا خالفوا فيه الحقَّ مِنْ أصل الدِّين وفروعِه إذ لم يُسألوا عمَّا خالفوا فيه أصلَ دِينهم مِنْ ضروبِ تَعاطيهم ولم يُحاسَبوا به ولم يُعْتدَّ بها في الوزن أيضًا؛ فإذا كانَتْ موزونةً دلَّ على أنهم يُحاسَبون بها وقتَ الحساب؛ وفي القرآن ما يدلُّ على أنهم مخاطَبون بها مسؤولون عنها محاسبون بها مجزيُّون على الإخلال بها؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [فُصِّلت: ٦ ـ ٧]؛ فتَوعَّدهم على منعِهم الزكاةَ، وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢﴾ [المدَّثِّر] الآية؛ فبان بهذا أنَّ المشركين مخاطَبون بالإيمان والبعثِ وإقامِ الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهم مسؤولون عنها مُحاسَبون بها مجزيُّون على الإخلال بها».
والراجح: أنَّ أعمال الكافر تُعَدُّ عليه فتُحْصى فيُوقَفُ عليها ويُخْبَرُ بها فيُقِرُّ بها؛ فلا يُحاسَبُ محاسَبةَ مَنْ تُوزَنُ حسناتُه وسيِّئاتُه، فإِنْ وُزِنَتْ فإنما تُوزَنُ قطعًا للحجَّة وتحقيرًا له وتبكيتًا على فراغه وخُلُوِّه مِنْ كُلِّ خيرٍ، ويُخْزى بها على رؤوس الأشهاد ثمَّ يُعذَّبُ عليها؛ لأنَّ الكافر لا تنفعه حسناتُه فلا يقدر منها على شيءٍ لعدم بقائها، كما أخبر اللهُ تعالى عن أعمال الكُفَّار في قوله: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨﴾ [إبراهيم]، وقولِه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمَۡٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [النور]، وقولِه تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان]، [وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٤/ ٣٠٥)].
فالحاصل: وجوبُ الإيمان بالميزان حقيقةً لا مجازًا لثبوته بالكتاب والسُّنَّة والإجماع ـ كما تقدَّم ـ وأنَّ أعمال العباد تُوزَنُ ـ يومَ القيامة ـ ليُجازَوْا عليها، وأنَّ ميزانَ الأعمال له كِفَّتان حسِّيَّتان مشاهَدتان تميلان بالأعمال، وتَثْقُلُ موازينُ العبدِ برجحانِ كِفَّةِ حسناته مِنَ الإيمان والعمل الصالح، وتَخِفُّ موازينُه برجحانِ كِفَّةِ السيِّئات على الحسنات أو فقدانِ الحسنات وانعدامِها كُلِّيَّةً على قولٍ، وبحسَبِ نتيجةِ الوزن يظهرُ أهلُ السعادة وأهل الشقاوة.
(٣) والظاهر أنَّ القصاص يندرج ضِمْنَ القضاء الإلهيِّ والمحاسَبة؛ ذلك لأنَّ أوَّل قضايا القضاءِ والمحاسَبة فيما يتعلَّق بعبادة الخالق: الصلاةُ، وأوَّلَ قضايا القضاءِ والمحاسَبة في معامَلات الخَلْق: الدماءُ ثمَّ غيرُها مِنَ المظالم، فيَقتصُّ المظلومُ مِنَ الظالم، ولا ذَهَبَ ـ يومَئذٍ ـ ولا فضَّةَ فيَرُدَّ بعضُهم على بعضٍ؛ فيُؤْخَذُ مِنْ حسنات الظالم، فإِنْ لم تكن له حسناتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئات المظلوم فرُدَّتْ على الظالم ـ كما سيأتي في الحديث ـ.
وعليه فالذي يظهر أنَّ المحاسَبة تسبق الوزنَ وتتقدَّم عليه؛ لأنَّ الوزن للجزاء؛ فينبغي أَنْ يكون بعد المحاسَبة؛ وما تَقرَّر ـ عند العلماء ـ أنَّ المحاسَبة لتقدير الأعمال، والوزنَ لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاءُ بحسَبِها، [انظر: «التذكرة» للقرطبي (٣٧٣)، «لوامع الأنوار البهيَّة» للسفَّاريني (٢/ ١٨٤)].
(٤) فقَدْ تقدَّم التنبيه أنه لا يجب شيءٌ على الله تعالى إلَّا ما أوجبه على نفسه تكرُّمًا وتفضُّلًا، وأنَّ العباد لا يُوجِبون عليه شيئًا، لا بحكم الأمر إذ لا آمِرَ فوقه، ولا بحكم العقل لأنَّ العقل كاشفٌ لا مُوجِبٌ، [انظر: التصفيف الرابع والخمسون، الهامش 6].
(٥) ساقطةٌ مِنْ «م.ر».
(٦) «م.ر.ب، م.ر.ش»: ﴿سَوَآءٞ﴾، وهي قراءةُ نافعٍ.
(٧) هو الصحابيُّ الجليل الحافظ أبو هريرة عبدُ الرحمن بنُ صخرٍ الدوسيُّ اليمنيُّ المعروف بكنيته رضي الله عنه، فهو أوَّلُ المُكْثِرين مِنْ رواية الحديث على الإطلاق، وله في كُتُب الحديث: أربعةٌ وسبعون وثلاثُمائةٍ وخمسةُ آلافِ حديثٍ (٥٣٧٤)، حدَّث عنه خلقٌ كثيرٌ مِنَ الصحابة والتابعين، وَلِيَ إمرةَ المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائلُ ومناقبُ، تُوُفِّيَ سنة: (٥٧ﻫ).
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٦٢، ٤/ ٣٢٥)، «التاريخ الصغير» للبخاري (١/ ١٢٥)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٤/ ١٧٦٨)، «أُسْد الغابة» لأبي الحسن بنِ الأثير (٥/ ٣١٥)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٢/ ٥٧٨) و«طبقات القُرَّاء» (١/ ٤٣) كلاهما للذهبي، ومؤلَّفي: «الإعلام» (١٩٨).
(٨) «م.ر.ب»: «المفلَّس».
(٩) «م.ر.أ، م.ر.ب، م.ف»: بزيادةِ: «مَنْ» قبلها.
(١٠) «م.ر.ب، م.ر.ش، م.ف»: «وَقَدْ».
(١١) «م.ف»: «فَإِذَا».
(١٢) هو أبو الحسين مسلمُ بنُ الحجَّاج القُشَيْريُّ النيسابوريُّ، أحَدُ الأئمَّة مِنْ حُفَّاظ الحديث، تقوم شهرتُه ومكانتُه على كتابه: «الجامع الصحيح» الذي يفضِّله المغاربةُ على «صحيح البخاري»؛ لِمَا امتاز به مِنْ جمعِ الطُّرُق وجودةِ السياق والمحافظةِ على أداء الألفاظ مِنْ غير تقطيعٍ ولا روايةٍ بالمعنى؛ هذا، وقد كان مسلمٌ مِنْ أوعية العلم، ثِقَةً جليلَ القَدْر، له مؤلَّفاتٌ أخرى منها: «العِلَل» و«الأسماء والكُنَى» و«الطبقات» و«التاريخ». تُوُفِّيَ سنة: (٢٦١ﻫ).
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ١٨٢)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٣/ ١٠٠)، «اللباب» لأبي الحسن بنِ الأثير (٣/ ٣٨)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذهبي (١٢/ ٥٥٧)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٣)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٣٩٣).
(١٣) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة والآداب» (١٦/ ١٣٥) بابُ تحريم الظلم، والترمذيُّ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٤/ ٦١٣) بابُ ما جاء في شأن الحساب والقصاص، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٣٠٣، ٣٣٤، ٣٧٢)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (٦/ ٩٣) وفي «شُعَب الإيمان» (١/ ٥٢٢)، والبغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٤/ ٣٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا تعارُضَ بين هذا الحديثِ وبين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأنَّ العقاب إنما يقع بسببِ فعلِه وظلمِه، ولم يُعاقَبْ بغيرِ جنايةٍ منه بل بجنايَتِه، فقُوبِلَتِ الحسناتُ بالسيِّئات على حسَبِ ما اقتضاه عدلُ الله تعالى في عبادِه وحِكْمَتُه في خَلْقه، [انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ١٣٦)، «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٠٢)].
(١٤) قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح مسلم» (١٦/ ١٣٥)] ما نصُّه: «معناه: أنَّ هذا ـ حقيقةً ـ المفلسُ؛ وأمَّا مَنْ ليس له مالٌ ومَنْ قلَّ مالُه فالناسُ يُسمُّونه: مُفلِسًا، وليس هو ـ حقيقةً ـ المفلسَ؛ لأنَّ هذا أمرٌ يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيَسارٍ يحصل له بعد ذلك في حياته، وإنما حقيقة المفلس هذا المذكورُ في الحديث؛ فهو الهالكُ الهلاكَ التامَّ والمعدومُ الإعدامَ المقطع؛ فتُؤخَذُ حسناتُه لغُرَمائه، فإذا فرَغَتْ حسناتُه أُخِذَ مِنْ سيِّئاتهم فوُضِعَ عليه ثمَّ أُلْقِيَ في النار؛ فتمَّتْ خسارَتُه وهلاكُه وإفلاسُه».
وقال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في [«فتح الباري» (١١/ ٣٩٧)]: «وقد استُشْكِل إعطاءُ الثوابِ وهو لا يتناهى في مُقابَلةِ العقاب وهو مُتناهٍ، وأُجيبَ بأنه محمولٌ على أنَّ الذي يُعطاهُ صاحبُ الحقِّ مِنْ أصل الثواب ما يُوازي العقوبةَ عن السيِّئة، وأمَّا ما زاد على ذلك ـ بفضل الله ـ فإنه يبقى لصاحِبِه؛ قال البيهقيُّ: سيِّئاتُ المؤمن ـ على أصولِ أهل السُّنَّة ـ مُتناهِيَةُ الجزاء، وحسناتُه غيرُ متناهِيَةِ الجزاء؛ لأنَّ مِنْ ثوابها الخلودَ في الجنَّة؛ فوجهُ الحديثِ ـ عندي واللهُ أعلمُ ـ: أنه يُعطى خُصَماءُ المؤمنِ المسيءِ مِنْ أجر حسناته ما يُوازي عقوبةَ سيِّئاته؛ فإِنْ فَنِيَتْ حسناتُه أُخِذَ مِنْ خطايا خصومه فطُرِحَتْ عليه، ثمَّ يُعذَّبُ إِنْ لم يُعْفَ عنه؛ فإذا انتهَتْ عقوبةُ تلك الخطايا أُدْخِلَ الجنَّةَ بما كُتِبَ له مِنَ الخلود فيها بإيمانه، ولا يُعْطى خُصَماؤُه ما زاد مِنْ أجر حسناته على ما قابل عقوبةَ سيِّئاته ـ يعني: مِنَ المضاعفة ـ لأنَّ ذلك مِنْ فضل الله يختصُّ به مَنْ وافى يومَ القيامة مؤمنًا، واللهُ أعلمُ».
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة- قرئت 2242 مرة
 أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)