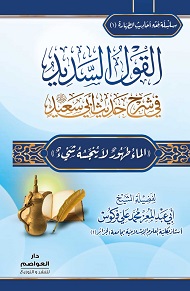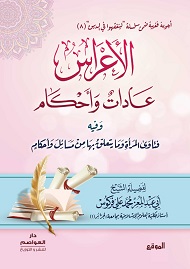الكلمة الشهرية رقم: ٤٠
في ضوابط الاستفادة من كتب المبتدعة
السؤال:
ما هي ضوابطُ الاستفادة مِنْ كُتُبِ أهلِ البِدَع؟ وهل يمكن الإحالةُ عليها في البحوث والمقالات؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يتوقَّف النظرُ في مسألةِ الاستفادةِ مِنْ كُتُبِ أهل البِدَعِ ومؤلَّفاتهم على صِدْقِ المُبتدِع أو عدَمِه بقَدْرِ ما يُنْظَر فيها إلى نوعِ العلم الذي يُلْقيهِ أو يسطِّرُه في كتابه، ومَدَى تأثُّرِ الناس به وببدعته، ومِنْ زاويةِ هذه الرؤيةِ يُفرَّق بين مَنْ يمتلك آلةَ التمييز بين الحقِّ والباطل وبين فاقِدِ أهليَّةِ التمييز.
فإِنْ كان نوعُ العلم الذي تَضمَّنه مُؤلَّفُهم يحتوي على فسادٍ محضٍ مِنْ زيغٍ وضلالٍ وخُرافةٍ في الاعتقاد، وتحكيمٍ للهوى، وعدولٍ عن النصوص الشرعيَّة، وانحرافٍ عن الأصول المعتمَدة: ككُتُبِ أهل الكلام والتنجيم، سواءٌ صَدَرَ مِنْ رافضيٍّ أو خارجيٍّ أو مُرْجِئٍ أو قَدَرِيٍّ أو قُبوريٍّ؛ فإنَّ نصوص الأئمَّةِ في كُتُبِ السِّيَرِ والاعتصامِ بالسُّنَّة حافلةٌ بمُنابَذةِ المُبْتَدِعة والتخلِّي عن الاستفادةِ مِنْ مؤلَّفاتهم وكُتُبِهم؛ خشيةَ الافتتان بآرائهم المُخالِفةِ للسُّنَّة والتأثُّرِ بفسادِ أفكارهم والانزلاقِ في بدعتهم وضلالهم، وقد حَذَّروا مِنَ النظرِ في كُتُبِ أهلِ الأهواء، وحثُّوا على إبعادها وإتلافها؛ تعزيرًا لأهل البِدَع، وتفاديًا لمَفْسَدةِ التأثُّر بها على دِينِهم، ويدلُّ عليه قصَّةُ عُمَرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه الذي أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بكتابٍ أصابَهُ مِنْ بعضِ أهلِ الكتاب، فقَرَأَه على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فغَضِبَ وقال: «أَمُتَهَوِّكُونَ(١) فِيهَا يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي»(٢).
وضِمْنَ هذا المعنى يقول ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وكُلُّ هذه الكُتُبِ المتضمِّنةِ لمُخالَفةِ السُّنَّةِ غيرُ مأذونٍ فيها، بل مأذونٌ في مَحْقِها وإتلافها، وما على الأمَّةِ أَضَرُّ منها، وقد حرَّق الصحابةُ جميعَ المَصاحِفِ المُخالِفةِ لمُصْحَفِ عثمان لمَّا خافوا على الأُمَّةِ مِنَ الاختلاف؛ فكيف لو رأَوْا هذه الكُتُبَ التي أوقعَتِ الخلافَ والتفرُّقَ بين الأمَّة؟!»(٣)، ويقول أبو القاسمِ الأصبهانيُّ ـ رحمه الله ـ: «ثمَّ مِنَ السُّنَّة: تَرْكُ الرأيِ والقياسِ في الدِّين، وتركُ الجدال والخصومات، وتركُ مُفاتَحةِ القَدَريَّة وأصحابِ الكلام، وتركُ النظرِ في كُتُبِ الكلام وكُتُبِ النجوم؛ فهذه السُّنَّةُ التي اجتمعَتْ عليها الأئمَّةُ»(٤).
أمَّا إذا كان نوعُ العلمِ في كُتُبِهم ومصنَّفاتهم مُمتزِجًا بين الحقِّ والباطل مِنْ كُتُبِ الأصول: فإِنْ كان طالِبُ العلمِ فاقدًا أهليَّةَ النظر، لا يقتدر على التمييز بين الممزوج، ولا يعرف حدودَ الحقِّ مِنَ الباطل؛ فحكمُه تركُ النظرِ ـ أيضًا ـ في هذه المصنَّفات والكُتُب؛ خشيةَ الوقوعِ في تلبيساتهم وتضليلاتهم.
وأمَّا إِنْ كان طالِبُ العلمِ الناظرُ فيها متشبِّعًا بالعلم الشرعيِّ الصحيح، ويملك آلةَ التمييزِ بين الحقِّ والباطل والهدى والضلال، واحتاج إلى الاطِّلاع عليها: إمَّا لدراستها وتحقيقِ صوابها مِنْ خطئها، وإمَّا للردِّ على ما تتضمَّنه مِنِ انحرافٍ وزيغٍ وخُرافةٍ؛ فله أَنْ يُقْبِلَ عليها، ويَقْبَل الحقَّ مِنْ أيِّ جهةٍ كان؛ فقَدْ كان مِنْ عَدْلِ سَلَفِنا الصالحِ قَبولُ ما عند جميعِ الطوائف مِنَ الحقِّ ولا يتوقَّفون عن قَبوله، ويردُّون ما عند هذه الطوائفِ مِنَ الباطل؛ فالمُوالي منها والمُعادي سواءٌ؛ إذ لا أَثَرَ للمتكلِّم بالحقِّ في قَبوله أو رَفْضِه؛ وفي هذا السياقِ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ هَدَاهُ اللهُ سبحانه إلى الأخذ بالحقِّ حيث كان ومع مَنْ كان ولو كان مع مَنْ يبغضه ويُعاديه، وردِّ الباطل مع مَنْ كان ولو كان مع مَنْ يُحِبُّه ويُواليه؛ فهو ممَّنْ هُدِيَ لِمَا اختُلِفَ فيه مِنَ الحقِّ»(٥).
وعليه، فلا يجوز الإحالةُ على كُتُبِ المُبتدِعةِ ومصنَّفاتهم إِنْ كان ضررُها يُماثِلُ نَفْعَها أو هو أَعْظَمُ منه، بل الواجبُ التحذيرُ منها وهَجْرُها، أمَّا إِنْ كان نَفْعُها أَعْظَمَ مِنْ ضرَرِها فله أَنْ يُحيلَ عليها في البحوث والمقالات، مع بيانِ ما حَوَتْه مِنْ شرٍّ أو فسادٍ إِنْ أمكن، أو التنبيهِ على جوانبِ ضرَرِها ـ ولو في الجملة ـ قَصْدَ الاحتراز منها، على حدِّ قولهم: «اجْنِ الثمارَ، وأَلْقِ الخشبةَ في النار»؛ وفي هذا المعنى مِنْ تحصيلِ النفع ممَّنْ فيه بدعةٌ يقول ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فإذا تَعذَّرَ إقامةُ الواجباتِ مِنَ العلم والجهاد وغيرِ ذلك إلَّا بمَنْ فيه بدعةٌ مَضَرَّتُها دون مَضَرَّةِ تركِ ذلك الواجب؛ كان تحصيلُ مصلحةِ الواجبِ مع مفسدةٍ مرجوحةٍ معه خيرًا مِنَ العكس؛ ولهذا كان الكلامُ في هذه المسائلِ فيه تفصيلٌ»(٦).
هذا، ولا يُقالُ في حقِّ هذه المصنَّفات: «خُذِ الحقَّ منها واتْرُكِ الباطلَ» مطلقًا إلَّا لمَنْ كان محصَّنًا بالعلم الشرعيِّ النافع، قادرًا على مُحاصَرةِ كُتُبِ أهلِ البِدَع المُخالِفين لمنهج أهل الحقِّ، وتطويقِ آرائهم وشُبُهاتهم؛ حفظًا لعقيدة المؤمنين مِنَ الفساد العقديِّ، وحمايةً لقلوبهم مِنَ الشُّبَهِ والتلبيس، وصيانةً لعقولهم منها؛ علمًا أنَّ مشروعيَّةَ تركِ النظر في كُتُبِ المُخالِفين لمنهجِ أهلِ الحقِّ إنما تَندرِجُ تحت قاعدةِ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر، التي تُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ أُسُسِ هذا الدِّينِ وقواعدِه.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٦ مـارس ٢٠٠٩م
(١) قال ابنُ الأثير في «النهاية» (٥/ ٢٨٢): «التهوُّك كالتهوُّر، وهو الوقوع في الأمر بغير رويَّةٍ، والمتهوِّكُ: الذي يقع في كُلِّ أمرٍ، وقِيلَ: هو التحيُّرُ».
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥١٥٦) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٣٤) وفي «ظلال الجنَّة» (١/ ٢٧) وقال: «إسنادُه ثِقَاتٌ غير مُجَالِدٍ ـ وهو ابنُ سعيدٍ ـ فإنه ضعيفٌ، ولكنَّ الحديثَ حَسَنٌ له طُرُقٌ أَشَرْتُ إليها في «المشكاة» (١٧٧)، ثمَّ خَرَّجْتُ بَعْضَها في «الإرواء» (١٥٨٩)».
(٣) «الطُّرُق الحُكميَّة» لابن القيِّم (٢٣٤).
(٤) «الحجَّة في بيان المَحَجَّة» للأصبهاني (١/ ٢٥٢).
(٥) «الصواعق المُرْسَلة» لابن القيِّم (٢/ ٥١٦).
(٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢١٢).
- قرئت 43725 مرة
- Français
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)