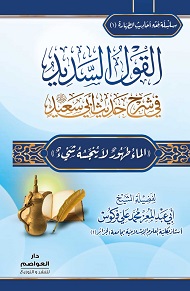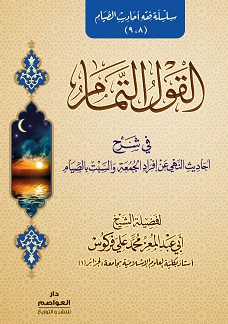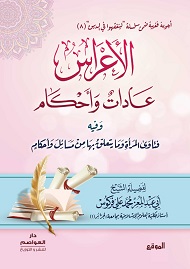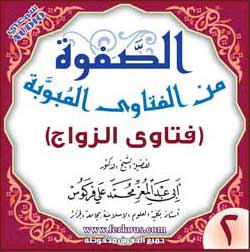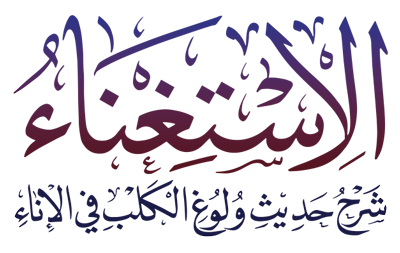
ـ الحلقة الأولى ـ
أولًا: نصُّ الحديثين
١/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(١).
٢/ وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»(٢).
٣/ وعنه ـ أيضًا ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»(٣).
٤/ وعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ»(٤).
ثانيًا: ترجمةُ راويي الحديثين:
ترجمةُ أبي هُريرة رضي الله عنه:
هو الصحابيُّ الجليل الحافظ المُكْثِرُ أبو هريرة رضي الله عنه، المعروفُ بكنيته، اخْتُلِفَ في اسْمِه على نحوِ ثلاثين قولًا، وأَشْهَرُها: عبد الرحمن بنُ صخرٍ الدَّوْسيُّ، مِن دَوْسِ بنِ عُدثانَ بنِ عبد الله بنِ زهران، مِنَ اليمن، أَسْلَمَ عامَ خَيْبَرَ سنةَ سبعٍ مِنَ الهجرة، وقَدِمَ المدينةَ مُهاجِرًا وسَكَنَ الصُّفَّة، وكان قد شَهِدَ خَيْبَرَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ثمَّ لَزِمَه ووَاظَبَ عليه رغبةً في العلم، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه مُحدِّثًا عن نَفْسِه: «لقد رأيتُني أُصْرَعُ بين منبرِ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وبين حُجْرةِ عائشة، فيقال: إنَّه مجنونٌ، ما بي جُنونٌ، وما بي إلَّا الجوعُ».
وقد كان رضي الله عنه أَكْثَرَ الصحابةِ روايةً وأوَّلَهم على الإطلاق(٥)، وله في كُتُبِ الحديث أربعةٌ وسبعون وثلاثُمائةٍ وخمسةُ آلافِ حديثٍ (٥٣٧٤)(٦)، وله فضائلُ ومَناقِبُ.
وقد استعمله عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على البحرين ثمَّ عَزَلَه، ثمَّ أرادَهُ على العمل فامتنع، وسَكَنَ المدينةَ ووَلِيَ إمرتَها ونابَ عن مروان في إمرتها، وبها كانَتْ وفاتُه سنةَ سبعٍ وخمسين مِنَ الهجرة (٥٧ﻫ)، وقِيلَ: مات بالعقيق وحُمِلَ إلى المدينة، وصلَّى عليه الوليدُ بنُ عتبة بنِ أبي سفيان، وكان أميرًا على المدينة لعمِّه مُعاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما(٧).
ترجمةُ عبدِ الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه:
هو أبو سعيدٍ عبدُ الله بنُ مُغَفَّلِ بنِ عبدِ نهم بنِ عفيف المُزَنيُّ رضي الله عنه، صحابيٌّ جليلٌ ومشهورٌ مِن أصحاب الشَّجرة، أي: شَهِد بيعةَ الرِّضْوان(٨)، وقد رُوي عنه أنَّه قال: «إنِّي لَآخِذٌ بغُصنٍ مِن أغصان الشجرة أُظِلُّ به النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وهم يُبَايعونه، فقالوا: «نُبَايعك على الموت» قال: «لَا، وَلَكِنْ لَا تَفِرُّوا»»(٩)، ولعبدِ الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه عِدَّةُ أحاديث(١٠)، حَدَّث عنه الحسنُ البصري، ومُطَرِّفُ بن الشِّخِّير، وابنُ بُريدة، ومعاويةُ بنُ قُرَّة وغيرُهم، وهو رضي الله عنه أحدُ العَشرة الذين بَعثَهم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه يُفقِّهون النَّاسَ، وكان من البَكَّائين الذين وَصَفهم الله بقوله: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٩٢﴾ [التوبة]، سَكَن المدينةَ ثمَّ تحوَّل عَنْها إلى البصرةِ وماتَ بها سنة ٦٠هـ(١١).
ثالثًا: سَنَدُ الحديثين
أخْرَج الحديثَ الأوَّلَ مسلمٌ وأبُو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، إلَّا أنَّ روايةَ التِّرمذيِّ جاءَت بِلفْظ: «يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وبالنَّظر إلى روايات الحديث واختلافها في شأن التتريب فإنَّ الرَّاجحَ منها روايةُ «أُولَاهُنَّ»؛ لأنَّها روايةُ أكثر الحفَّاظ وأعلاهم ضبطًا(١٢)، ويحتمل أنَّ لفظ «أو» شكٌّ من الرَّاوي، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «اللفظ ﺑ «أو» يحتمل أن تكون من الراوي، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع؛ قال ابن دقيق العيد: الأوَّل أقرب؛ لأنَّه لم يقل أحدٌ بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إمَّا بتعيين الأُولى أو التخيير بين الجميع [انتهى]، وليس كما قال، فقد قال الشافعي في «البويطي»: «وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعًا أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، لا يُطهِّره غير ذلك»، وكذا قال في «الأمِّ»... ولكن الأوَّل أقرب من جهةٍ أخرى؛ لأنَّ لفظ رواية الترمذي: «أخراهنَّ» أو قال: «أولاهنَّ»، وهنا ظاهر في أنَّه شكٌّ من الرَّاوي، وكذا قرَّره البيهقيُّ في «الخلافيات» أنَّها للشكِّ»(١٣).
وأمَّا الروايةُ الثانيةُ فقد أخرجها البخاريُّ ومسلمٌ مِن طريق مالك، قال ابنُ عبد البر ـ رحمه الله ـ: «وهكذا يقول مالك في هذا الحديث: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ»، وغيرُه من رواة حديث أبي هريرة هذا ـ بهذا الإسناد وبغيره ـ على تواتر طُرُقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيرِه، كلُّهم يقول: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ» ولا يقولون: «شَرِبَ الكَلْبُ» وهو الذي يعرفه أهل اللغة»(١٤).
وقد تعقَّبه العراقي بقوله: «وسبقه إلى ذلك الحافظان أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وأبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن منده، فقالا: إنَّ مالكًا تفرَّد بقوله «شَرِبَ»، وليس كما ذكروا، فقد تابع مالكًا على قوله «شَرِبَ» مُغيرةُ بنُ عبد الرحمن الحِزامي، وورقاء بن عمر، كما بيَّنه ابنُ دقيق العيد في «الإمام» على بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ: «وَلَغَ» كما رواه غيرُه، ورواه ابن ماجه من رواية رَوْح بن عبادة عن مالك هكذا في بعض نسخ ابن ماجه وفي بعضها «شَرِبَ»، وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الدَّاني في أطراف «الموطإ» أنَّ أبا عليٍّ الحنفيَّ رواه عن مالك بلفظ «وَلَغَ»، والمعروف عن مالك «شَرِبَ» كما اتفق عليه رواة «الموطإ»»(١٥).
هذا، «ولم يقع في رواية مالكٍ التتريبُ، ولم يثبت في شيءٍ من الروايات عن أبي هريرة إلَّا عن ابن سيرين، على أنَّ بعض الصحابة لم يذكره»(١٦).
• وأمَّا الرواية الثالثة فقد أخرجها مسلم والنسائي من طريق علي بن مُسْهِر بزيادة «فَلْيُرِقْهُ»، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عليَّ ابنَ مُسْهِرٍ على زيادة «فَلْيُرِقْهُ» وقال حمزة الكناني: إنَّها غير محفوظةٍ، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحُفَّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة، وقال ابن منده: لا تُعرف عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بوجه من الوجوه إلَّا عن عليِّ بنِ مسهر بهذا الإسناد. قلت [ابن حجر]: قد وَرَد الأَمْرُ بالإراقة ـ أيضًا ـ من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابنُ عديّ، لكِنْ في رفعه نظر، والصحيح أنَّه موقوفٌ، وكذا ذَكَر الإراقةَ حمَّادُ بنُ زيدٍ عن أيُّوبَ عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسنادُه صحيحٌ أخرجه الدَّارقطني وغيرُه»(١٧).
هذا، والملاحَظ أنَّ رواية «فَلْيُرِقْهُ» لم تتعرَّض لذِكر التُّراب، والروايات التي ذُكر فيها التُّرابُ لم يُذكر فيها الأمرُ بالإراقة، ولا تعارُضَ إن جُمعَتْ هذه الرواياتُ على وجه التوافق.
• وأمَّا حديث عبد الله بن مُغفَّل رضي الله عنه فقد رواه مسلم وأبو داود والنَّسَائي وابنُ ماجه وغيرهم، فتُعارضه رواية أبي هريرة: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وهي أَوْلَى منه لوُرود هذه الزيادة عنه من طريقين ـ كما سيأتي بيانه ـ ولا يُعارضها ما رواه أبو داود بلفظ: «السَّابِعَة بِالتُّرَابِ»(١٨)؛ لأنَّه شاذٌّ ـ كما بَيَّنه الألباني رحمه الله ـ(١٩).
هذا، وقد أخرج الدارقطني في «سننه» من حديث عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا ـ في الكلب يَلَغُ في الإناء ـ قال: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»(٢٠)، قال الدارقطني: «تفرَّد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيرُه يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا» وهو الصَّوابُ»(٢١).
رابعًا: مفرداتُ الحديثين وغريبُهما
• طُهُور: بضمِّ الطاء مصدر من طَهُر بمعنى التَّطهُّر إذا أُريدَ به المصدر وهو الفعل، وبفتح الطاء إذا أريدَ به ما يُتطهَّر به وهو الماء، مثله: الوُضوء والوَضوء، والسُّحور والسَّحور.
والمراد به هنا المصدر ـ أي: بالضمِّ ـ وبه قال جمهور أهل اللُّغة على ما صَرَّح به النوويُّ خلافًا للخليل بن أحمد والأصمعي وجماعةٍ أنَّه بالفتح، وأمَّا سيبويه فيرى أنَّ وقوعَه بالفتح يكون على الماء والمصدرِ معًا، فيصحُّ ـ عنده ـ أَنْ يُضبط لفظُ الحديث بفتح الطاء وضمِّها ويكون المراد بهما التطهُّر(٢٢).
• وَلَغَ: هو من باب وَهَبَ ووَقَعَ ووَعَد ووَرثَ، مضارعه: يَلَغ بفتح عين الكلمة وكسرها، يقال: ولَغ الكلب في الإناء يَلَغ ولوغًا، إذا شَرِب بطرَف لسانه، أو أَدخلَ لسانَه فيه فحرَّكه في الماء أو في غيره من كلِّ مائع، سواء شرب أم لم يشرب، فإن كان غيرَ مائعٍ فيقال: لعقه، فإن كان فارغًا يقال: لحسه(٢٣)، قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: «الولوغ للسِّباع والكلاب كالشُّرب لبني آدم، وقد يُستعمل الشُّرب في السباع، ولا يُستعمل الولوغ في الآدمي»(٢٤).
• فَلْيُرِقْهُ: مِن أراق الماء أي: صَبَّه، ويقال ـ أيضًا ـ: هَرَاقَه، وهي لغة يمانية، ثمَّ فَشَتْ في مُضَرَ، والمستقبل: أُهْريقُ، والمصدر: الإراقة، والهراقة(٢٥)، وقوله: «فَلْيُرِقْهُ» فعلٌ مضارعٌ مقرون ﺑ «لام الأمر» الذي يفيد وجوبَ صبِّ الماء وإلقائه من ولوغ الكلب فيه ـ كما سيأتي في الفوائد والأحكام ـ.
• ليَغْسِلْهُ: وهو ـ أيضًا ـ فعلٌ مضارعٌ مقرون ﺑ «لام الأمر» يفيد وجوبَ غَسْل الإناء من ولوغ الكلب فيه.
و«لام الأمر» ـ في الفعلين السابقين ـ هو حرفُ جزمٍ طلبيٌّ للمضارع مبنيٌّ على الكسر كما هو حالُ «لِيَغْسِلْهُ»، ونحوُه قوله تعالى:﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [الطلاق: ٦]، ولكن الأكثر على تسكينها بعد الواو والفاء ـ كما تقدَّم في «فَلْيُرِقْهُ» ـ ونحوُه قوله تعالى:﴿فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي﴾ [البقرة: ١٨٦].
• عَفِّرُوهُ: مِن عَفَرَهُ ـ مخفَّف الفاء ـ يعفِرُه عَفْرًا تعفِيرًا، والتَّعفير هو التَّمريغ في العَفَر وهو التراب، أي: فرِّغوه في العَفَر في المرَّة الثامنة دَلْكًا وغسلًا، والتضعيف فيه للمبالغة(٢٦).
ـ يُتبَع ـ
(١) أخرجه مسلم في «الطهارة» (٣/ ١٨٣) باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود في «الطهارة» (١/ ٥٧) باب الوضوء بسُؤْر الكلب، والترمذي في «الطهارة» (١/ ١٥١) باب ما جاء في سُؤْر الكلب، والنسائي في «المياه» (١/ ١٧٧) باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه بهذا اللفظ البخاري في «الوضوء» (١/ ٢٧٤) باب الماء يُغسل به شعرُ الإنسان، ومسلم في «الطهارة» (٣/ ١٨٢) من طريق مالك؛ انظر: «الموطأ» كتاب «الطهارة» (١/ ٥٥) باب جامع الوضوء.
(٣) أخرجه مسلم في «الطهارة» (٣/ ١٨٢) باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي في «المياه» (١/ ١٧٦) باب سُؤْر الكلب.
(٤) أخرجه مسلم في «الطهارة» (٣/ ١٨٣) باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود في «الطهارة» (١/ ٥٩) باب الوضوء بسُؤْر الكلب، والنسائي في «المياه» (١/ ١٧٧) باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، وابن ماجه في «الطهارة» (١/ ١٣٠) باب غَسْل الإناء من ولوغ الكلب، وتمامُه: أنَّ عبد الله بنَ مُغَفَّل قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بِقَتْلِ الكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ...» الحديث.
(٥) وسببُ ذلك لزومُه مجالسَ الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ومُواظَبتُه عليها، ودعاؤه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم له، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «وَاللهُ المَوعِدُ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مَجْلِسًا فَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي»، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى قَضَى حَدِيثَه ثُمَّ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ» [أخرجه أحمد (١٢/ ٢٤٠)]. أمَّا عن كُنيتِه رضي الله عنه فقَدْ أخرج الترمذيُّ (٥/ ٦٨٦) عن عبد الله بنِ رافعٍ قال: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: «لِمَ كُنِّيتَ: أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: «أَمَا تَفْرَقُ مِنِّي؟» قُلْتُ: «بَلَى ـ وَاللهِ ـ إِنِّي لَأَهَابُكَ»، قَالَ: «كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي، فَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا؛ فَكَنَّوْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ».
(٦) انظر: «الباعث الحثيث» لأحمد شاكر شرح «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (١٨٧).
(٧) انظر ترجمته وأحاديثه في: «مسند أحمد» (٢/ ٢٢٨، ٥/ ١١٤)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٦٢، ٤/ ٣٢٥)، «المَعارِف» لابن قتيبة (٢٧٧)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٤/ ١٧٦٨)، «مستدرك الحاكم» (٣/ ٥٠٦)، «جامع الأصول» لأبي السعادات بنِ الأثير (٩/ ٩٥)، «الكامل» (٣/ ٥٢٦) و«أُسْد الغابة» (٥/ ٣١٥) كلاهما لأبي الحسن بنِ الأثير، «سِيَر أعلام النُّبلاء» (٢/ ٥٧٨) و«طبقات القُرَّاء» (١/ ٤٣) و«الكاشف» (٣/ ٣٨٥) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٤٢) كُلُّها للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ١٠٣)، «مَجْمَع الزوائد» للهيثمي (٩/ ٣٦١)، «وفيات ابنِ قنفذ» (٢١)، «الإصابة» (٤/ ٢٠٢) و«تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٦٢) كلاهما لابن حجر، «طبقات الحُفَّاظ» للسيوطي (١٧)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٦٣)، «الفكر السامي» للحجوي (١/ ٢/ ٢٤٧)، ومؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (١٩٨).
(٨) بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة وقعت في شهر ذي القعدة في السَّنة السادسة من الهجرة في منطقة الحديبية، وسُمِّيت ببئرٍ عند مسجد الشجرة التي بايع فيها الصحابةُ رضي الله عنهم رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بسبب ما أُشِيعَ أنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه قتلته قريش لَمَّا بعثه النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم للمفاوضة، وتقع ـ حاليًا ـ على بعد ٢٢ كيلًا غربي مكة، وتُعْرَف ـ اليوم ـ بالشميسي.
انظر خبرها في: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٠٨)، «معجم ما استعجم» للبكري (١/ ٤٣٠)، «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢/ ٢٠٠)، «البداية والنهاية» (٤/ ١٦٤) و«الفصول في سيرة الرسول» (١٥٩) كلاهما لابن كثير، «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي (١/ ٣٨٦).
(٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٥٤)، وقد ضعَّفه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «مسند أحمد» (٥/ ٥٤).
(١٠) انظر أحاديثه: في «مسند أحمد» (٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤ ـ ٥٧).
(١١) انظر ترجمته في: «المعارف» لابن قتيبة (٢٩٧)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٩٦)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٦٤)، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٨٣) و«دول الإسلام» (١/ ٤٥) كلاهما للذهبي، «تهذيب التهذيب» (٦/ ٤٢) و«الإصابة» (٢/ ٣٧٢) كلاهما لابن حجر، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٦٥).
(١٢) سيأتي تفصيله قريبًا.
(١٣) «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٤٠) [بتصرف].
(١٤) «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٤).
(١٥) «طرح التثريب» للعراقي (٢/ ١٢٠)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٣٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٤).
(١٦) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٥)، وانظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (١/ ١١٠).
(١٧) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٥).
(١٨) أخرجه أبو داود في «الطهارة» (١/ ٥٩) باب الوضوء بِسُؤْرِ الكلب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٩) قال الألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٣١): «صحيح لكن قوله «السَّابِعَة» شاذٌّ، والأرجح: «الأُولَى بِالتُّرَابِ»»، وانظر: «إرواء الغليل» (١/ ٦٢).
(٢٠) أخرجه الدارقطني في «الطهارة» (١/ ٦٦) باب ولوغ الكلب في الإناء، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٧٤) كما رواه الدارقطني موقوفا على أبي هريرة (١/ ٦٦) أنَّه قال: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا» ثمَّ قال: «لم يروه هكذا غيرُ عبد الملك عن عطاء، والصحيح «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»»؛ انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٣١).
(٢١) «سنن الدارقطني» (١/ ٦٦).
(٢٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٤٧)، «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٩٩)، «سبل السلام» للصنعاني (١/ ٥١).
(٢٣) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٤)، «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢٢٦)، «رياض الأفهام» للفاكهاني (١/ ٩٩)، «العدة في شرح العمدة» للصنعاني (١/ ١٠٤)، «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٢)، «توضيح الأحكام» للبسام (١/ ١٢٨).
(٢٤) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٣٤).
(٢٥) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (٦/ ٥٠٠)، «لسان العرب» لابن منظور (٥/ ٣٩٣)، «المعجم الوسيط» (١/ ٣٨٦).
(٢٦) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٩/ ٢٨٣)، «عون المعبود» لأبي الطيب العظيم آبادي (١/ ١٣٩)، «تيسير العلام» للبسام (١/ ٢١)، «ذخيرة العقبى» للإثيوبي (٥/ ٣٤٧).
- قرئت 15529 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)