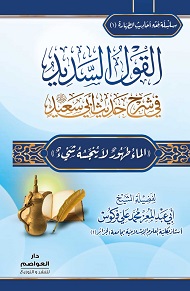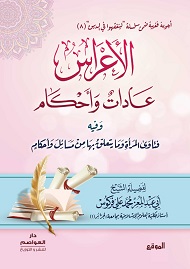الكلمة الشهرية رقم: ١١٥
ومضاتٌ توضيحيةٌ
على العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
لابن باديس ـ رحمه الله ـ
ـ تنبيهات واستدراكات ـ
ـ الحلقة الخامسة ـ
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمواصلةً لهذه السلسلة التوضيحية مِنَ التنبيهات والاستدراكات أقول ـ وبالله التوفيقُ ـ:
• رابع عشر: قول المصنِّف ـ رحمه الله ـ في فصل ٣٢: «الإيمان لا يُبْطِله نقصُ الأعمال» (ص ٦٤):
«مَنْ ضَيَّعَ الْأَعْمَالَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا﴾ [الحُجُرات: ٩]، وَلِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟» قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ».
تنبيه واستدراك:
المصنِّف رحمه الله ـ مِنْ خلالِ استدلاله بالآية والحديث ـ أراد بتضييع الأعمال: تَرْكَ المأموراتِ وركوبَ المَعاصي والمحظوراتِ كالقتل والزِّنا وشُرْبِ الخمر، ما لم يَصِلْ إلى حدِّ الكفر أو الشركِ الأكبر؛ فإنه لا يخرج مُضيِّعُ الأعمالِ مِنْ دائرة الإيمان، بل يبقى معه مُطْلَقُ الإيمانِ لا الإيمانُ المُطْلَق، وأهلُ السُّنَّة مُتَّفِقون على أنه لا يكفر أهلُ القِبْلة بمُطْلَقِ المَعاصي والكبائر، قال ابنُ أبي العزِّ الحنفيُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ أهل السنَّة مُتَّفِقون كُلُّهم على أنَّ مُرتكِبَ الكبيرةِ لا يكفر كفرًا ينقل عن المِلَّة بالكُلِّيَّة كما قالَتِ الخوارجُ؛ إذ لو كَفَر كفرًا ينقل عن المِلَّة لَكان مُرْتَدًّا يُقْتَل على كُلِّ حالٍ، ولا يُقْبَلُ عفوُ وليِّ القِصاص، ولا تجري الحدودُ في الزِّنا والسرقةِ وشُرْبِ الخمر، وهذا القولُ معلومٌ بطلانُه وفسادُه بالضرورة مِنْ دِين الإسلام، ومُتَّفِقون على أنه لا يخرج مِنَ الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يَستحِقُّ الخلودَ في النار مع الكافرين كما قالَتِ المعتزلة؛ فإنَّ قولهم باطلٌ أيضًا؛ إذ قد جَعَل اللهُ مرتكبَ الكبيرةِ مِنَ المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] إلى أَنْ قال: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فلم يُخْرِجِ القاتلَ مِنَ الذين آمنوا وجَعَله أخًا لوليِّ القِصاص، والمرادُ: أخوَّةُ الدين بلا ريبٍ، وقال تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا﴾ [الحُجُرات: ٩] إلى أَنْ قال: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡ﴾ [الحُجُرات: ١٠]، ونصوصُ الكتابِ والسنَّةِ والإجماع تدلُّ على أنَّ الزانيَ والسارق والقاذف لا يُقْتَل بل يُقامُ عليه الحدُّ؛ فدلَّ على أنه ليس بمُرْتَدٍّ»(١).
ويُحتمل أنَّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ أراد بالإضاعة: تضييعَ ثواب الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ولِمَا صحَّ مِنْ حديثِ ثوبان رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا»، قَالَ ثَوْبَانُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا؛ أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ»، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا»(٢)، ولحديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الفَاجِرِ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ»(٣).
غير أنَّ لفظ المصنِّف ـ عندي ـ لا يُساعِد مِثْلَ هذا المُضْمَر، بل يعكِّر عليه جملةٌ مِنَ التعليلات والاعتراضات تتمثَّل فيما يلي:
أوَّلًا: مِنَ المعلوم أنَّ الأصل في اللفظ أَنْ يكون مُستقِلًّا بذاته لا يتوقَّف معناهُ على تقديرٍ ولا إضمارٍ، وإذا دارَ اللفظُ بين أَنْ يكون مُستقِلًّا مُكتفِيًا بذاته أو مُضْمَرًا يتوقَّف معناهُ على تقديرٍ فإنه يُحْمَل على استقلاله وهو عدمُ التقدير لقلَّةِ اضطرابه كما تَقرَّر ذلك أصوليًّا(٤)؛ وعليه فيكونُ معنَى كلامِ المصنِّف ـ في الفقرة الأولى ـ شاملًا للأعمال فعلًا وتركًا، وتقديرُه بضياعِ ثواب الأعمال مُخالِفٌ للأصل المقرَّر.
ثانيًا: إِنْ سُلِّم ـ جدلًا ـ تقديرُ اللفظ ﺑ «ثواب الأعمال» فإنَّ الثواب أثرٌ عن العمل ونتيجةٌ له مِنْ حيث الجزاءُ؛ فكان الثوابُ فرعًا مولَّدًا مِنْ أصلٍ، فلا يمكن ـ والحالُ هذه ـ تقديرُ الثوابِ أثرًا فرعيًّا والعدولُ عن العمل مؤثِّرًا أصليًّا، فكيف يُصارُ إلى الفرعِ ويُتْرَك الأصلُ؟! هذا مِنْ زاويةٍ.
ثالثًا: ومِنْ زاويةٍ ثانيةٍ: فالعملُ ـ باعتباره مؤثِّرًا ـ أعمُّ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ في ركوب المَعاصي والمَحارم ـ مِنْ جهةِ وجوبِ تركِها ـ دون أَنْ يَشْمَلَ تضييعَ الطاعات ـ مِنْ جهةِ وجوبِ فعلِها ـ.
والمصنِّفُ ـ رحمه الله ـ عبَّر بلفظٍ عامٍّ شاملٍ لكُلِّ عملٍ بقوله: «مَنْ ضيَّع الأعمالَ..»، ولا شكَّ أنه يَشْمَلُ ـ بالدرجة الأولى ـ تضييعَ الفعلِ قبل شموله للترك والكفِّ الذي هو فعلٌ، ولا يخفى ـ أيضًا ـ أنَّ «جِنْسَ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»، وأنَّ «جِنْسَ تَرْكِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»، وأنَّ المثوبة على أداء الواجبات أعظمُ مِنَ المثوبة على تركِ المحرَّمات، وأنَّ العقوبة على تركِ الواجبات أعظمُ مِنَ العقوبة على فعلِ المحرَّمات على ما بيَّنه العلماءُ أتمَّ بيانٍ(٥). وعليه، فكيف يَعْدِل المصنِّفُ ـ رحمه الله ـ عن الأهمِّ إلى المُهِمِّ؟!
رابعًا: ومِنْ زاويةٍ ثالثةٍ: فإنَّ تفسيرَ إضاعةِ الأعمال بأنها هي: الأوامرُ والنواهي بدون إضمارٍ على وجه الاستقلال أَوْلى مِنْ تقديرها بالثواب؛ لأنه هو الظاهر المُتبادِر إلى الذهن مِنْ حيث كونُه مُستقِلًّا بنفسه يتعلَّق بأفعال المكلَّف الدنيوية؛ لذلك قال المصنِّف ـ رحمه الله ـ: «.. لم يخرج مِنْ دائرة الإيمان»، بخلاف الاستظهار بالأحاديث النبوية، فجاءَتْ مِنْ حيث الجزاء الأخرويُّ، ولا يتعلَّق به نصُّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ.
خامسًا: ومِنْ زاويةٍ أخيرةٍ: فإنَّ حَمْلَ الأعمالِ على تضييع الأوامر والنواهي هو حملٌ على الحقيقة لأنها تستغني عن القرينة، بينما حملُه على تضييعِ ثوابِ الأعمال فهو حملٌ على المجاز لاحتياجه إلى قرينةٍ صارفةٍ عن الحقيقة، وإذا تعارضَتِ الحقيقةُ مع المجاز قُدِّمَتِ الحقيقةُ لأصالتها.
وهذا المعنى الحقيقيُّ يتوافق مع معنى الإضاعة في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم]؛ فالآيةُ دلَّتْ على تركِ المأمور ـ مِنْ جهةٍ ـ لأنهم إِنْ أضاعوا الصلاةَ فهُمْ لِمَا سواها مِنَ الواجبات أضيعُ، كما تدلُّ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ على ارتكاب المنهيِّ عنه؛ لأنهم أقبلوا على شهوات الدنيا ومَلاذِّها ورَضُوا بالحياة الدنيا واطمأنُّوا بها.
وإلى هذا المعنى ذَهَب ابنُ جريرٍ الطبريُّ وابنُ كثيرٍ رحمهما الله(٦)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «والظاهر أنَّ مَنْ أخَّر الصلاةَ عن وقتها، أو تَرَك فرضًا مِنْ فروضها، أو شرطًا مِنْ شروطها، أو ركنًا مِنْ أركانها فقَدْ أضاعها، ويدخل تحت الإضاعة: مَنْ تَرَكها بالمرَّة أو جَحَدها دخولًا أوَّليًّا»(٧)؛ قلت: فهذا يدلُّ على حقيقة المعنى دون مجازه بحَمْلِه على الثواب.
وعليه، فإنَّ مُرادَ المصنِّف ـ رحمه الله ـ مِنْ تضييع الأعمال هو مُطْلَقُ الترك، سواءٌ مِنْ جهةِ تركِ المأمور أو ركوبِ المحرَّم والمحذور، ما لم يَصِلْ إلى حدِّ الكفر أو الشرك الأكبر؛ فإنه لا يخرج مِنْ دائرة الإيمان، بل يبقى معه مُطْلَقُ الإيمان لا الإيمانُ المطلق؛ لأنَّ هذا المعنى هو الظاهرُ المُتبادِرُ إلى الذهن، ولأنَّ ظواهرَ أخرى تُؤيِّدُه ـ كما قدَّمْتُ ـ مِنَ العموم السابق والأصلِ المُستقِلِّ والمؤثِّر، وأنَّ العمل ـ الذي هو الأصلُ ـ أَوْلى مِنَ الأثر الفرعيِّ، فضلًا عن أنَّ حَمْلَه على المُحتمَل المرجوح ـ وهو الثواب ـ مجازٌ مخالفٌ للحقيقة وهي أَوْلى منه مِنْ جهةٍ، ولأنه ـ مِنْ جِهةٍ أُخْرى ـ لم يَرِدْ ـ في حدود علمي عن أحَدٍ مِنَ العلماء ـ حملُه على تقدير الثواب.
هذا، وقد استدلَّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ على أنَّ فاعِلَ كبيرةِ القتل لا يُخْرِجه ذلك مِنَ الإيمان بالآية والحديث ـ كما سيأتي ـ أمَّا إِنْ أراد جنسَ الأعمالِ فإنَّ لفظةَ «إضاعة» مُجْمَلةٌ، فقَدْ يُرادُ بها تركُ الأعمال كُلِّيَّةً، وهو ما يُعبَّر عنه ﺑ «الترك المطلق»، وقد يُرادُ بها عدمُ المحافظة عليها، وذلك بترك القيام بها على وجه التمام والكمال، وهو ما يُعبَّر عنه ﺑ «مطلق الترك».
والفرق بينهما: أنَّ «الترك المطلق»: هو ما دخلَتْ عليه اللامُ التي تُفيدُ العمومَ والشمول ثمَّ وُصِف بالإطلاق، بمعنَى أنه لم يتقيَّد بقيدٍ يُوجِبُ تخصيصَه مِنْ شرطٍ أو صفةٍ أو غيرهما؛ فهو عامٌّ مُتناوِلٌ لكُلِّ فردٍ مِنْ أفراده؛ فكان معنى الترك المطلق هو التركَ بالجملة للصلاة وسائرِ الأعمال.
أمَّا «مطلق الترك» فالإضافةُ فيه ليسَتْ للعموم بل للتمييز؛ فهو قَدْرٌ مُشترَكٌ مطلقٌ لا عامٌّ؛ فيصدق بفردٍ مِنْ أفراده؛ فكان معنى الترك: عدَمَ المحافظةِ على عملٍ أو أعمالٍ، وعدَمَ القيامِ بها على وجه التمام والكمال.
ويبيِّن هذا الفرقَ بين الإطلاقين قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في شأن الصلاة ـ مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ: إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»(٨)، وفي حديثِ أبي قتادة رضي الله عنه عند ابنِ ماجه: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي»(٩).
فهذا الحديث صريحٌ في الفرق بين الترك المطلق وبين مطلق الترك، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إنما أدخل تحت المشيئة مَنْ لم يُحافِظْ عليها، لا مَنْ تَرَك، ونفسُ المحافظة يقتضي أنهم صلَّوْا ولم يحافظوا عليها..»(١٠)، وقال ـ أيضًا ـ: «.. فإنَّ كثيرًا مِنَ الناس ـ بل أكثرَهم ـ في كثيرٍ مِنَ الأمصار لا يكونون مُحافِظين على الصلوات الخمس ولا هم تارِكُوها بالجملة، بل يُصلُّون أحيانًا ويَدَعون أحيانًا؛ فهؤلاء فيهم إيمانٌ ونفاقٌ، وتجري عليهم أحكامُ الإسلام الظاهرة»(١١).
هذا، والمصنِّف ـ رحمه الله ـ كان دقيقًا في اختيارِ لفظةِ: «الإضاعة» بدلًا مِنَ «الترك»؛ لِمَا فيها مِنْ معنَى مطلقِ الترك، حيث إنَّ عدم المحافظة على الأعمال بعدم القيام بها على وجه الكمال والتمام أو بفعلها تارةً وتركِها أخرى مع الإقرار بوجوبها وفرضيتها فإنَّ هذا لا يُعَدُّ تاركًا لها، وإنما غيرَ محافظٍ عليها، أمَّا مَنْ ضيَّع شيئًا مِنْ شعائر الإسلام وفرائضِه الظاهرة أو تَرَكه ـ جحودًا لوجوبها ومُنْكِرًا لفرضيَّتِها ـ فهو كافرٌ بالنصِّ والإجماع(١٢).
هذا، وحريٌّ بالتنبيه ـ أيضًا ـ: أنَّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ عَزَا الحديثَ لمسلمٍ دون البخاريِّ، والصحيحُ أنه مِنْ رواية البخاريِّ أيضًا؛ فقَدْ أخرجه في «الإيمان» (١/ ٨٤ ـ ٨٥) باب: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا﴾ [الحُجُرات: ٩]، وفي «الدِّيَات» (١٢/ ١٩٢) بابُ قولِ الله تعالى: ﴿وَمَنۡ أَحۡيَاهَا﴾ [المائدة: ٣٢]، وفي «الفِتَن» (١٣/ ٣١) باب: إذا الْتَقى المسلمان بسيفَيْهما، وأخرجه مسلمٌ في «الفِتَن وأشراط الساعة» (١٨/ ١٠ ـ ١١) باب: إذا تَواجَه المسلمان بسيفَيْهما، مِنْ حديثِ الحسن عن الأحنف بنِ قيسٍ عن أبي بكرة رضي الله عنه.
ولا يفوتني أَنْ أنبِّه إلى أنَّ مسلمًا روى الحديثَ في كتابه ـ ثلاثَ مرَّاتٍ ـ بألفاظٍ مختلفةٍ:
ـ أخرجه ـ في الأولى ـ بلفظ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟» قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».
ـ واقتصر ـ في الثانية ـ على ذِكْرِ صدرِ الحديث بهذا اللفظ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، ولم يعرِّج على بقيَّته.
ـ وأخرجه ـ في الثالثة ـ مِنْ غيرِ طريق الحسن عن الأحنف، وإنما عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ عن أبي بكرة رضي الله عنه (١٨/ ١٢) مُقتصِرًا على صدره ـ أيضًا ـ لكِنْ بلفظ مغايرٍ: «إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا».
هذا، ولفظ الحديث الذي جاء به المصنِّف ـ رحمه الله ـ في نصِّه بتمامه، إنما هو في «صحيح البخاريِّ» في الموضعين الأوَّلين المذكورين أعلاهُ، وليس في صحيح مسلمٍ ـ كما ترى ـ.
• خامس عشر: وقول المصنِّف ـ رحمه الله ـ في فصل ٣٤: «بيان معنى الإحسان» (ص ٦٦):
«الْإِحْسَانُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ: الْإِتْيَانُ بِمَا هُوَ حَسَنٌ، وَالْإِحْسَانُ ـ فِي الشَّرْعِ ـ: هُوَ الْإِتْيَانُ بِالْحَسَنَاتِ، وَالْحَسَنَاتُ هِيَ: فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفِعْلُ أَوْ تَرْكُ الْمُبَاحَاتِ لِأَنَّهَا مُبَاحَاتٌ، مَعَ التَّصْدِيقِ بِذَلِكَ للهِ تَعَالَى وَالْإِخْلَاصِ لَهُ فِيهِ، وَمَعَ اسْتِحْضَارِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١١٢﴾ [البقرة]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٩٠﴾ [يوسف]، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَسَّرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانَ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(١٣)».
تنبيه واستدراك:
المصنِّف ـ رحمه الله ـ عند تناوُله لتعريف الإحسان ذَكَر له ثلاثةَ مَعانٍ مُجتمِعةٍ، ومِنْ بينها معنى «التصديقِ بذلك لله تعالى والإخلاصِ له فيه»، فمِنْ هذه الزاويةِ تظهر سَعَةُ الإحسان وعموميَّتُه عن الإيمان مِنْ جهةِ نَفْسِه وخصوصيَّتُه مِنْ جهةِ أهله، وهو ما تَرْجَم معناه ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ بقوله: «وأمَّا الإحسان فهو أعمُّ مِنْ جهةِ نَفْسِه، وأخصُّ مِنْ جهةِ أصحابه مِنَ الإيمان، والإيمانُ أعمُّ مِنْ جهةِ نَفْسِه وأخصُّ مِنْ جهةِ أصحابه مِنَ الإسلام؛ فالإحسانُ يدخل فيه الإيمانُ، والإيمانُ يدخل فيه الإسلامُ، والمُحْسِنون أخصُّ مِنَ المؤمنين، والمؤمنون أخصُّ مِنَ المسلمين»(١٤).
قلت: ومِنْ زاويةٍ أخرى: فقَدْ أوضح المصنِّف ـ رحمه الله ـ في تعريفه الشرعيِّ أنَّ الإحسان يجمع بين عبادةِ إتيان الحسنات، والإيمانِ وكمالِ الإخلاص، مع استحضار القلب بمراقبة الله تعالى؛ وهذه المعاني الثلاثةُ مُطابِقةٌ لأحَدِ نوعَيِ الإحسان، وهو: إحسانٌ في عبادة الخالق ـ سبحانه ـ بالفعل الحسن الذي يُحِبُّه مِنَ «الإخلاصِ فيها والخشوع وفراغِ البال حالَ التلبُّس بها ومراقبةِ المعبود»(١٥)، وقد فسَّره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك حين سأله جبريلُ عليه السلام فقال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١٦)، ومَنْ بَلَغ هذه المرتبةَ مِنْ عبادة الله فقَدْ عَبَده عبادةَ طلبٍ ورغبةٍ، وخوفٍ ورهبةٍ؛ لأنه يخاف مَنْ يراه.
غير أنَّ المصنِّف ـ رحمه الله ـ لم يُبْرِزِ النوعَ الثانيَ للإحسان ـ صراحةً ـ وإِنْ تضمَّنَتْ عبارتُه الإشارةَ إليه في ثنايَا تعريفِه، وهو إحسانٌ في حقوق الخَلْق الذي يتبلور فيه معنى الإنعام على الناس، ببذل أنواع المنافع ومختلف المصالح لأيِّ مخلوقٍ يكون، وقِيلَ في تفسير الإحسان في حقِّ الخَلْق: إنه بذلُ النَّدَى، وكفُّ الأذى، وطلاقةُ الوجه، ويدخل في معنَى بذلِ الندى: كُلُّ معروفٍ وإحسانٍ في معاملة الخَلْق، سواءٌ كانت معاملةً ماليةً: كالبيع والإجارة والمضاربة وغيرها، أو غيرَ ماليةٍ: كالأحوال الشخصية مِنْ زواجٍ وطلاقٍ وكفالةٍ وغيرها ممَّا يتحلَّى فيها المرءُ بخُلُقِ الإحسان(١٧)، وقد أفصح السعديُّ ـ رحمه الله ـ عن نوعَيْن مِنَ الإحسان حيث قال: «الإحسان نوعان: إحسانٌ في عبادة الخالق بأَنْ يعبد اللهَ كأنه يراه، فإِنْ لم يكن يراه فإنَّ الله يراه، وهو الجِدُّ في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميلِ لها، وإحسانٌ في حقوق الخَلْق، وهو: بذلُ المنافع مِنْ أيِّ نوعٍ كان لأيِّ مخلوقٍ يكون»(١٨).
ـ يُتْبَع ـ
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جانفي ٢٠١٧م
(١) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٣٦٠).
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الزهد» (٢/ ١٤١٨) بابُ ذِكْرِ الذنوب، مِنْ حديثِ ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٨) رقم: (٥٠٥) و«صحيح الجامع الصغير» (٥/ ٣) رقم: (٤٩٠٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (٢/ ١١٤) بابُ بيانِ غِلَظِ تحريمِ إسبالِ الإزار والمَنِّ بالعطيَّة وتنفيقِ السلعة بالحَلِف، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه.
(٤) انظر المَصادرَ الأصولية التي تُقرِّرُ هذا الأصلَ: «المحصول» للفخر الرازي (٢/ ٢/ ٥٧٤)، «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٠، ٢٦٧)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (١١٢)، «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٥٢٨)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (١/ ٢٩٥)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٧٨).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٨٥)، و«عدَّة الصابرين» لابن القيِّم (٤٤).
(٦) انظر: «تفسير ابن جرير» (١٦/ ٩٩)، «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٢٧).
(٧) «فتح القدير» للشوكاني (٣/ ٣٣٩).
(٨) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» في «صلاة الليل» (١/ ١٤٥) باب الأمر بالوتر، وأحمد في «مسنده» (٥/ ٣١٥، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٢)، وأبو داود في «الصلاة» (١/ ٢٩٥) بابٌ في المحافظة على وقت الصلوات، وفي (٢/ ١٢٩) بابٌ فيمَنْ لم يُوتِرْ، والنسائيُّ في «الصلاة» (١/ ٢٣٠) باب المحافظة على الصلوات الخمس، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة» (١/ ٤٤٩) بابُ ما جاء في فرضِ الصلوات الخمسِ والمحافظةِ عليها، مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه. والحديث صحَّحه النوويُّ في «المجموع» (٣/ ١٧)، والعراقيُّ في «طرح التثريب» (٢/ ١٤٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (٣/ ١١٤).
(٩) أخرجه ابنُ ماجه في «إقامة الصلاة» (١/ ٤٥٠) بابُ ما جاء في فرضِ الصلوات الخمسِ والمحافظةِ عليها. وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ١٧٣٧).
(١٠) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٦١٥).
(١١) المصدر السابق (٧/ ٦١٧).
(١٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٤٠)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٤).
(١٣) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (١/ ١٥٠ ـ ١٦٠) بابُ بيانِ الإيمان والإسلام والإحسان، وأبو داود في «السنَّة» (٥/ ٦٩) بابٌ في القدر، والترمذيُّ في «الإيمان» (٥/ ٦) بابُ ما جاء في وصفِ جبريلَ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الإيمانَ والإسلام، والنسائيُّ في «الإيمان» (٨/ ٩٧) بابُ نعتِ الإسلام، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» (١/ ٢٤) بابٌ في الإيمان، مِنْ حديثِ ابنِ عمر عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاريُّ في «الإيمان» (١/ ١١٤) بابُ سؤالِ جبريلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلمِ الساعة، وفي «التفسير» (٨/ ٥١٣) باب: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، ومسلمٌ في «الإيمان» (١/ ١٦١ ـ ١٦٥) بابُ بيانِ الإيمان والإسلام والإحسان، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ١٠).
(١٥) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٢٠)، وانظر: «جامع العلوم والحِكَم» لابن رجب (٣٤).
(١٦) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ١٣).
(١٧) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).
(١٨) «بهجة قلوب الأبرار» للسعدي (٢٣٤) بتصرُّف.
- قرئت 66613 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)