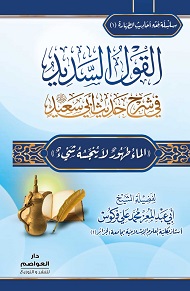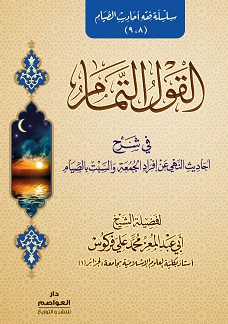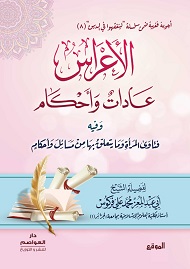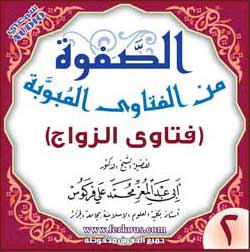الكلمة الشهرية رقم: ١٥١

[الحلقةُ الرابعةَ عَشْرَةَ]
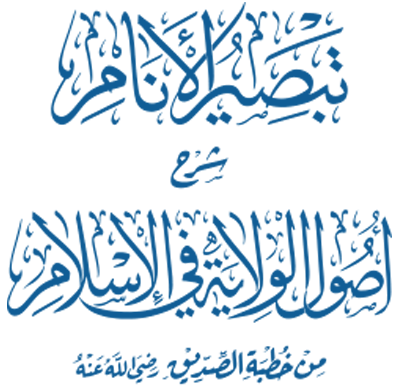
[ ٣ ]
[الجزءُ الثَّالث]
قال الشَّيخُ عبدُ الحميدِ بنُ باديسَ ـ رحمه الله ـ:
«الأصلُ الثَّانِي
[الأكفأ أحق بالخلافة]
الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ هُوَ أَكْفَؤُهَا فِيهِ لَا خَيْرُهَا فِي سُلُوكِهِ(١)؛ فَإِذَا كَانَ شَخْصَانِ اشْتَرَكَا فِي الخَيْرِيَّةِ وَالكَفَاءَةِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ فِي الخَيْرِيَّةِ والآخَرُ أَرْجَحَ فِي الكَفَاءَةِ لِذَلِكَ الأَمْرِ قُدِّمَ الأَرْجَحُ فِي الكَفَاءَةِ عَلَى الأَرْجَحِ فِي الخَيْرِيَّةِ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ الكَفَاءَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأُمُورِ وَالمَوَاطِنِ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ أَكْفَأَ فِي أَمْرٍ وَفِي مَوْطِنٍ؛ لِاتِّصَافِهِ بِمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الأَمْرَ وَيُفِيدُ فِي ذَلِكَ المَوْطِنِ(٢)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ فِيهِ دُونَ سِوَاهُ؛ وَعَلَى هَذَا الأَصْلِ وَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(٣) غَزَاةَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ(٤) وَأَمَدَّهُ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ(٥) وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ(٦) فَكَانُوا تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَكُلُّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ عَقَدَ لِوَاءَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ(٧) عَلَى جَيْشٍ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ(٨).
وَهَذَا الأَصْلُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ»(٩)».
ـ يُتبَع ـ
(١) المعلوم أنَّ أعظمَ الإمامةِ مَنصِبًا وأخطرَها وِلايةً هي الإمامَةُ الكُبرَى، فالإمامُ الأعظمُ أَحَقُّ بإمامَة الصَّلاةِ وأَوْلَى بِها مِن غَيرهِ باتِّفاقِ المسلمين، لذلك كان الأَصلُ فيها وُجوبَ طلبِ الأفضَلِ ـ لأنَّه الأصلحُ لها ـ وعَقْدِها عليه دون المَفْضُول متى لم يَكُنْ عارضٌ يمنعُ مِن إمامةِ الأفضلِ، ويدلُّ عليه إجماع الصَّدرِ الأَوَّلِ، فمِن ذلك: قولُ عمرَ رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ قَدْ جَمَعَ أَمْرَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ»؛ [أخرجه ابن كثيرٍ في «البداية والنهاية» (٥/ ٢٤٨) وقال: هَذَا إسنادٌ صحيح]، وقولُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ رضي الله عنه: «لَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ»؛ [أخرجه البخاري في «الأحكام» (١٣/ ١٩٣) باب: كيف يُبايِعُ الإمامُ النَّاسَ؟ مِن حَديث المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ الزُّهريِّ رضي الله عنهما].
غَيرَ أَنَّه يجُوزُ ـ خُرُوجًا عن هذا الأَصلِ ـ عَقدُ الإمامَةِ الكُبْرَى للمَفضولِ، وتَقدِيمُه على الأَفضَلِ إنْ خِيفَ مِن تَرتُّبِ عَقدِ الإمامَةِ للفَاضِلِ الفِتْنَةُ أو الهَرْجُ وتركُ الطَّاعَةِ وتعطيلُ الحُقوقِ والأَحكامِ، ويدلُّ عَليه أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه جَعلَ الإمامَةَ إلى أَهلِ الشُّورَى وهُم سِتَّةٌ، وَهُوَ وسَائرُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم بَل الأُمَّةُ يَعلمُونَ بِأنَّ في السِّتَّة فاضِلًا ومَفضولًا، وقد أَجازَ عَقدَ الإمامَةِ لكلِّ وَاحدٍ منهم إذا أدَّى إلى صَلاحِهم وجَمْعِ كَلمتِهم مِن غَيرِ إنكارِ أَحدٍ علَيهِ، «ولأَنَّ الإمامَ إنَّمَا نُصِبَ لدَفعِ العَدوِّ وحمايةِ البَيضَةِ وسدِّ الخَلَلِ، فإِذَا خِيفَ بإِمامَةِ أفضلِهِمْ الهَرْجُ والفَسادُ والتَّغالُبُ كان ذلكَ عُذرًا في العُدولِ عنِ الفاضِلِ إلى المفضُولِ، ولأنَّه لا خِلافَ أنَّه يجُوزُ تَقدِيمُ المَفضولِ عَلى الفاضِلِ في إِمامَةِ الصَّلاةِ فكذلك في الإمامَةِ العُظمَى»؛ [«الانتصار في الرَّدِّ على المعتزلة» للعمراني (٣/ ٨٢١)، وانظر: «تمهيد الأوائل» للباقلَّاني (٤٧١)].
وبِناءً عليه، فإنَّ مَدارَ اختِيارِ الإمامِ الأعظمِ إنَّما يَكمُنُ في الأصلحِ المُتمتِّعِ بالكَفَاءَةِ والقُدرةِ لِتأهيلِهِ لهذا المَنْصِبِ السَّامي، وشُروطُ استِحقاقِه له تَلتَقِي جُملتُهَا في لُزُومِ تَوَافرِ صِفَتَيِ: القُوَّةِ والأمانةِ، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ [في «السِّياسة الشَّرعية» (١٢)] مُوضِّحًا ذلك بما نصُّهُ: «وينبغي أن يُعْرَفَ الأصلحُ في كلِّ مَنصِبٍ فإنَّ الوِلايَةَ لها رُكنانِ: القُوَّةُ والأمانةُ، كما قال تعالى ﴿إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦﴾ [القصص]، وقال صاحبُ مِصرَ ليُوسُفَ عليه السَّلام: ﴿إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِينٞ ٥٤﴾ [يوسف]، وقال تعالى في صِفةِ جِبريلَ: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ٢٠ مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ٢١﴾ [التكوير].
والقُوَّةُ في كلِّ وِلايةٍ بِحَسَبِها، فالقُوَّةُ في إمارةِ الحربِ ترجعُ إلى شَجاعَةِ القَلبِ وإلى الخِبرَةِ بالحروبِ والمُخادعةِ فيها، فإنَّ الحربَ خُدعةٌ، وإلى القُدرةِ على أنواعِ القتالِ: مِنْ رَمْيٍ وطَعنٍ وضَربٍ ورُكوبٍ وَكَرٍّ وَفَرٍّ ونحوِ ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا»؛ [أخرجه أبو داود في «الجهاد» (٣/ ٢٨) باب في الرمي، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: «وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا»، قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٤/ ٧٧٤): «فيه اضطراب وجهالة، وقد بيَّنتُ ذلك في «ضعيف أبي داود» (٤٣٢)»، وأخرج حديثَ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى» مسلم في «الإمارة» (١٣/ ٦٥) بابُ فضلِ الرمي والحثِّ عليه، وذمِّ مَنْ عَلِمه ثم نَسِيَه، مِنْ حديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ رضي الله عنه]، وفي روايةٍ: «فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا» رواه مسلم؛ [بل أخرج هذه الرواية البزار (٩٠٩٥)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٥٤٣)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٢٩٤)].
والقُوَّةُ في الحُكْمِ بينَ النَّاسِ ترجعُ إلى العِلمِ بالعَدْلِ الذي دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة، وإلى القُدرةِ على تنفيذِ الأحكامِ.
والأمانةُ ترجعُ إلى: خَشيةِ اللهِ، وألَّا يَشتريَ بِآياتِهِ ثَمَنًا قَليلًا، وتركِ خَشيةِ النَّاسِ، وهذه الخصالُ الثَّلاثُ الَّتي أَخذَهَا اللهُ على كلِّ مَنْ حَكَمَ على النَّاسِ في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بَِٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائدة]».
وقال السِّعدي ـ رحمه الله ـ [في «تفسيره» (١٠٧)] عن القوَّةِ في العِلمِ والجسمِ في معرضِ شرحِ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ما نصُّه: «أيْ: فضَّلَه عليكم بالعِلمِ والجِسمِ، أي: بقوةِ الرَّأيِ والجسمِ الَّلذين بهما تتمُّ أمورُ المُلكِ، لأنَّه إذا تَمَّ رأيُه وقَوِيَ على تنفيذِ ما يقتضيه الرَّأيُ المصيبُ، حصَلَ بذلك الكمالُ، ومتى فاتَه واحدٌ من الأمرَينِ اختلَّ عليه الأمرُ، فلو كان قَوِيَّ البدنِ مع ضَعفِ الرَّأيِ، حصَلَ في المُلكِ خَرقٌ وقَهرٌ ومخالفةٌ للمشروعِ، قوةٌ على غيرِ حكمةٍ، ولو كان عالمًا بالأمورِ وليس له قوةٌ على تنفيذِها لم يُفِدهُ الرَّأيُ الَّذي لا ينفِّذه شيئًا».
فمقاصدُ الإمامةِ ـ إذن ـ إنَّما تتحقَّقُ بالرَّجلِ الأصلحِ الكُفْءِ الأمينِ القَوِيِّ القدِيرِ عَلى القِيامِ بأعباءِ هذا المَنصِبِ الخطيرِ والنُّهوضِ بِواجِباتِ الدِّينِ على الوجه المُرضِي للهِ تعالى، المُحقِّقِ للمصلحةِ العامَّةِ وبناءِ مجتَمع الأُمَّةِ مُتماسِكًا على النَّهجِ الإسلامي القَويمِ.
هذا، ومِن أَهمِّ شُروطِ الإمامَةِ الكُبرَى ـ أيضًا ـ الَّتِي يَنبَغي أَنْ تتوفَّر في الإمامِ الأعظم ما يأتي:
• أَنْ يكون عدلًا نَزيهًا مُستَقيمًا على دِينه، وعَلى جَانبٍ كبيرٍ مِنَ الأَخلاقِ الحَسنَةِ والآدابِ السَّاميةِ؛ فَلا يَصلحُ للإمامَةِ مَن كان فَاسقًا مَخْرومَ المُرُوءَةِ.
• وأَن يَكون بَصيرًا بأُمورِ السِّياسةِ وشُؤُونِ الحُكمِ، جَريئًا على إِقامة حُدودِ اللهِ صارمًا في تَنفِيذِ أحكامِها، لا تَأخُذُهُ في الله لومَةُ لَائمٍ، ذَا إِدراكٍ ودِرايةٍ بطُرُقِ الحفاظِ على وحدةِ الأُمَّةِ وتَماسُكِهَا، حرِيصًا على تحقيقِ مصالِحِهَا الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ، وشُجاعًا في كفِّ ظالِمِها وعقوبتِه، والأخذِ لِمَظلومِها، مع دوام تفقُّد أحوالِ رَعيَّتِهِ وسَدِّ حاجاتهم، وتعاهُدِ وُلَاةِ الأطرافِ وعُمَّال النواحي وحُمَاةِ البلادِ وقادةِ الجند مراقبةً ومحاسبةً.
• أن يكون جامعًا للعِلم بالأحكام الشَّرعيَّة بمنزلةِ مَن يصلُحُ للقضاءِ، لإجماع الأُمَّة على أنَّ للإمامِ أَنْ يُباشِرَ الأحكامَ بنفسه وهو مُكلَّفٌ بتنفيذِها، كما أنَّه هو الذي يُوَلِّي القُضاةَ والحُكَّامَ ويُعيِّنُ مهامَّهم ويُنهِيها، ويَنظُرُ في أحكامِهم إقرارًا ونَقْضًا، ولا يخفى أنَّه لا يمكنُهُ ذلك مع الجهلِ بالأحكامِ ومَدارِكِهَا الشَّرعيَّةِ.
فهذه جملةٌ مِن أهمِّ الصِّفاتِ المشتَرَطةِ للإمامَةِ العُظمى، فإِنْ لم يَكنِ الإمامُ بهذه الصِّفاتِ قَصُرَ عمَّا لأجله نُصبَتِ الإمامةُ، وأَضرَّ بِفَشلِهِ وضَعفِهِ بمَنصِبِهِ الَّذي لا يصلُحُ له، بل يَتعدَّى الضَّررُ بسبب جَهلِهِ وتَقصيرِهِ إلى سائِرِ الأُمَّةِ، فتتولَّدُ عنه الشَّدائدُ والأزماتُ، وتحدثُ الفَوْضَى والاضطراباتُ، فتجرُّ هذه المخاوفُ الأُمَّةَ إلى الضَّعفِ والتَّقَهْقُرِ والنُّزولِ إلى الحضيضِ، وتكون ـ وَقْتَئِذٍ ـ مطمعَ أعداءِ الإسلامِ ومحلَّ تسلُّطِهم.
(٢) فالمُرادُ بالخَيريَّةِ المُشتَرَكةِ في مَنصبِ الإمامةِ إنَّما هي باعتبارِ ما يَجتمِعُ فيه المُتَشاركانِ مِن عمومِ الطَّاعاتِ الواجبةِ والمندوبةِ، ومِنْ حُسنِ الأخلاقِ والسِّيرةِ، وطِيبِ السَّريرةِ، وَمَا إلى ذلكَ مِنْ فَضائلِ السَّجايَا وصفاتِ المُرُوءَةِ وشَواهدِ الفَضْلِ وَالأخلاقِ، ولا يَخْفَى أنَّ عُمومَ الكفاءاتِ: مِنَ الكفاءةِ الدِّينيَّةِ والخُلُقيَّةِ والعِلميَّةِ والعَمَليَّة والمَاليَّةِ والنَّسَبيةِ (قُرَشية) وغيرها كُلِّها مشمولةٌ بالخَيرِيَّةِ، فَبَيْنَ الكفاءةِ والخَيرِيَّةِ ـ إذن ـ خُصوصٌ وعُمومٌ مُطلقٌ، فقولُ المُصنِّفِ ـ رحمه الله ـ: «فَإِذَا كَانَ شَخْصَانِ اشْتَرَكَا فِي الخَيْرِيَّةِ وَالكَفَاءَةِ..» فهو مِنْ بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ تنبيهًا على مَزيدِ صلاحٍ أو شَرَفٍ أو مَزِيَّةٍ في المَفضولِ لا توجدُ في الفاضلِ، فَإِنْ نَاسَبَتْ مَزيَّتُهُ الأَكْفَئيَّةُ مَوطنًا يصلحُ فيه ويَفقِدُها الفاضلُ كان صاحبُ المَزيَّةِ أَحْرَى منهُ في استحقاقِ ذلك الأمرِ، مثالُه في مَوطِنِ الجِهادِ يُقدَّم الكُفْءُ الأصلحُ صاحِبُ القُوَّةِ والبَصيرةِ بشُؤُونِ الحَرْبِ العالِمُ بتدابيرِ الجُيوشِ والسَّرايَا وسدِّ الثُّغورِ وحمايةِ البَيْضَةِ وما يتَّصل بذلك الأمرِ على مَن كفاءتُهُ فيهِ ضَعيفةٌ أو أَهليَّتُهُ نَاقصَةٌ، وكذلك في مَوطِنِ القَضاءِ والحُدودِ وَالمُعامَلاتِ المَاليَّةِ وما يَتعلَّقُ بهِ مِنْ مَسائلَ وأحكامٍ، فإنَّ العالِمَ بالأحكام الشَّرعيَّة وطريقِ معرفةِ المُحِقِّ مِنَ المُبطِلِ فيها أَكْفَأُ للمَنْصِب وأصلحُ له لقُوَّته وقُدرتِهِ عليه فيُقدَّمُ على مَن لم يكُنْ أهلًا أو كان دون مُستَوَى تلكَ المَسْئوليَّةِ، وفي كِلَا المِثالَينِ تُشتَرَطُ الأمانَةُ على نحوِ ما تقدَّم وهكذا، عِلمًا أنَّ مُجرَّدَ زيادةِ فضلٍ أو مَزِيَّةٍ لا يَستلزِمُ ثُبوتَ الأَفضلِيَّةِ المُطلَقَةِ.
قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ [في «السِّياسة الشرعية» (١٥)]: «فالواجبُ في كلِّ وِلايةٍ الأصلحُ بِحَسبها، فإذا تعيَّن رجلانِ أحدهما أعظمُ أمانةً والآخر أعظمُ قُوَّةً قُدِّمَ أنفعُهما لتِلكَ الوِلايةِ وأقلُّهما ضَرَرًا فيها، فيُقَدَّم في إمارةِ الحروب الرَّجلُ القَوِيُّ الشُّجاعُ وإن كان فيه فُجُورٌ فيها على الرَّجُلِ الضَّعيفِ العاجِزِ وإن كان أمِينًا، كما سُئِلَ الإمام أحمد: عن الرَّجُلَينِ يكونان أَميرَين في الغَزْوِ وأحدُهما قوِيٌّ فاجِرٌ والآخَرُ صالحٌ ضعيفٌ مع أيِّهِما يُغزَى؟ فقال: أمَّا الفاجِرُ القَوِيُّ فقُوَّتُهُ للمسلِمينَ وفُجُورُهُ على نَفسِهِ، وأمَّا الصَّالح الضَّعيف فصلاحُهُ لنَفسِهِ وضَعفُهُ على المُسلمينَ فيُغزَى مع القَوِيِّ الفَاجِرِ، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» (٦/ ١٧٩) باب: إنَّ الله يُؤيِّد الدِّينَ بالرَّجل الفاجر، ومسلم في «الإيمان» (٢/ ١٢٢) باب غِلَظِ تحريم قتل الإنسانِ نفسَه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، وَرُوِيَ: «بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ»؛ [أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٤٥٤)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٨٦٦)]، فإذا لم يكن فاجرًا كان أَولَى بإمارة الحَربِ ممَّن هو أصلحُ منه في الدِّين إذا لم يَسدَّ مَسدَّهُ».
(٣) هو الصَّحابيُّ أبو عبدِ اللهِ عمرُو بنُ العاص بنِ وائلٍ القُرَشيُّ السهميُّ رضي الله عنه، أسلم في هدنة الحُدَيْبِيَة، واستعمله النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على عُمَانَ فقُبِض النبيُّ وهو عليها، وكان أحَدَ أُمَراءِ الأجناد في فتوح الشَّامِ، وافتتح مِصرَ في عهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، وعَمِل له ولعثمانَ رضي الله عنه على مِصرَ، ثمَّ عليها زمنَ معاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما، له جملةٌ مِنَ الأحاديث، تُوُفِّيَ سنة: (٤٣ﻫ)؛ [انظر ترجمته وأحاديثه في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٥٤، ٧/ ٤٩٣)، «مسند أحمد» (٤/ ١٩٦، ٢٠٢)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٠٣)، «المعارف» لابن قُتَيْبة (٢٨٥)، «المستدرك» للحاكم (٣/ ٤٥٢)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١٦٣)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٣/ ١١٨٤)، «جامع الأصول» لأبي السعادات بنِ الأثير (٩/ ١٠٣)، «الكامل» (٣/ ٢٧٣) و«أُسْد الغابة» (٤/ ١١٥) كلاهما لأبي الحسن بنِ الأثير، «الحُلَّة السِّيَراء» لابن الأبَّار (١/ ١٣)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٣/ ٥٤) و«الكاشف» (٢/ ٣٣٣) كلاهما للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٢٣٦)، «وفيات ابنِ قنفذ» (١٨)، «تهذيب التهذيب» (٨/ ٥٦) و«الإصابة» (٣/ ٢) و«تقريب التهذيب» (٢/ ٧٢) كُلُّها لابن حجر، «الرياض المستطابة» للعامري (٢١٥)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٥٣)، «شجرة النور» لمخلوف (٢/ ٨٦)].
(٤) السَّلاسِل أو السُّلاسِل: اسْمٌ لِمَاءٍ بأرضِ جُذامٍ سُمِّيَتْ به الغزوةُ؛ [انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (٣/ ٧٤٥)، «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٣٨٩)، «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ٢٣٣)، «مراصد الاطِّلاع» للبغدادي (٢/ ٧٢٤)، وانظر: «غزوةَ ذاتِ السلاسل» في: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٦٢٣)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٣١)، «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٣/ ٣٨٦)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٢٧٣)، «مختصر السيرة النبوية» لابن عبد الوهَّاب (٣٣٠)].
(٥) هو الصحابيُّ أبو حفصٍ عمرُ بنُ الخطَّاب بنِ نُفَيْلِ بنِ عبد العُزَّى القُرَشيُّ العَدَويُّ، الفاروق رضي الله عنه، الخليفة الثاني لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، كَنَّاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أبا حفصٍ، وله فضلٌ على الأمَّة سياسةً وفتحًا وعدلًا واستقامةً، وهو الصادق المُلْهَم، له مُوافَقاتٌ مع ربِّه في بضعةَ عَشَرَ موضعًا، وهو أوَّلُ قاضٍ بعد وفاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولَّاهُ أبو بكرٍ رضي الله عنه، وله مناقبُ وفضائلُ كثيرةٌ، وَلِيَ الخلافةَ عشرَ سنين ونصفًا، تُوُفِّيَ ـ مقتولًا ـ سنة: (٢٣ﻫ) وهو ابنُ ثلاث وستين سنةً، ودُفِن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وأبي بكرٍ في بيتِ عائشة رضي الله عنهم؛ [انظر ترجمته وأحاديثه في مؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٥٩)].
(٦) هو الصحابيُّ أبو عُبَيدَةَ عامرُ بْنُ عبدِ اللهِ بنِ الجرَّاحِ بنِ هِلالٍ القُرَشِيُّ الفِهْرِيُّ رضي الله عنه، أحدُ كبارِ الصَّحابةِ وفضلائهِم، وأحَدُ السَّابقينَ الأَوَّلينَ، شَهِدَ بدرًا مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وما بعدها مِنَ المَشاهِدِ كُلِّهَا، وهو أحدُ العَشرَةِ المُبشَّرينَ بالجَنَّةِ، وسَمَّاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أمينَ الأُمَّةِ، له مناقبُ كثيرةٌ وأحاديثُ معدودةٌ، تُوُفِّيَ بالأردنِّ في طاعون عَمَوَاس سنةَ (١٨ﻫ)؛ [انظر ترجمته وأحاديثه في مؤلَّفي: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (١٨١)].
(٧) هو الصحابيُّ أبو محمَّدٍ أسامةُ بنُ زيد بنِ حارثة بنِ شراحيل القُضَاعيُّ الكلبيُّ نسبًا الهاشميُّ ولاءً، المدنيُّ، حِبُّ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وابنُ حِبِّه رضي الله عنهما، وأمُّه بَرَكةُ أمُّ أيمنَ الحبشيَّةُ رضي الله عنهما مولاةُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وحاضِنَتُه، ولَّاهُ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بعد مَقْتَلِ أبيه رضي الله عنه، فمات رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قبل أَنْ يتوجَّه فأَنفذَه أبو بكرٍ رضي الله عنه، ولأسامةَ فضائلُ كثيرةٌ وأحاديثُ شهيرةٌ، اعتزل الفِتَنَ بعد مَقتلِ عثمانَ رضي الله عنه إلى أَنْ مات سنة: (٥٤ﻫ)؛ [انظر ترجمته وأحاديثه في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٦١)، «مسند أحمد» (٥/ ١٩٩)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٠)، «المعارف» لابن قُتَيْبة (١٤٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٨٣)، «المستدرك» للحاكم (٣/ ٥٩٦)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (١/ ٧٥)، «شرح السنَّة» للبغوي (١٤/ ١٤٢)، «جامع الأصول» لأبي السعادات بنِ الأثير (٩/ ٣٧)، «أُسْد الغابة» (١/ ٦٤) و«الكامل» (٣/ ٥٠٠) كلاهما لأبي الحسن بنِ الأثير، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» (٢/ ٤٩٦) و«الكاشف» (١/ ١٠٤) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٣٩) كُلُّها للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٦٧)، «مجمع الزوائد» للهيثمي (٩/ ٢٨٦)، «وفيات ابنِ قنفذ» (٢٠)، «الإصابة» (١/ ٣١) و«تهذيب التهذيب» (١/ ٢٠٨) كلاهما لابن حجر، «الرياض المستطابة» للعامري (٣٠)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٥٩)].
(٨) تنبيه: قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ [في «منهاج السُّنَّة» (٥/ ٣٣٨)]: «لم يَنقُلْ أحدٌ مِن أهل العِلم أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أرسل أبَا بكرٍ أو عثمانَ في جيش أُسامَة، وإنَّمَا رُوِيَ ذلك في عمرَ، وكيف يُرسِل أبا بكرٍ في جيش أُسامةَ، وقد استخلفه يُصلِّي بالمسلمين مُدَّةَ مرضه» ثمَّ قال بعده: «فَلمَّا جلس أبو بكرٍ للخلافةِ أَنْفَذَهُ مع ذلك الجيشِ، غيرَ أنَّه استأذَنَهُ في أن يأذن لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في الإقامةِ؛ لأنَّه ذو رأيٍ ناصحٌ للإسلامِ، فأَذِنَ له، وسار أُسامَةُ لوجهه الذي أَمَر رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم».
ونقل ابنُ حَجَرٍ رحمه الله ـ أيضًا ـ [في «فتح الباري» (٨/ ١٥٢)] إنكارَ ابنِ تيميةَ ـ رحمه الله ـ بما نصُّه: «وقد أنكر ابنُ تيميَّةَ في كتابِ «الرَّد على ابن المطَهَّر» أَنْ يكون أبو بكرٍ وعُمرُ كانا في بَعْثِ أُسامةَ، ومُستَنَدُ ما ذَكره ما أَخرجَه الوَاقِديُّ بأسانيدِه في «المغازي»، وذكره ابن سَعْدٍ أواخرَ الترجمة النَّبويَّة بِغير إسناد، وذَكَره ابنُ إسحاقَ في «السِّيرةِ» المَشهورةِ ولفظُهُ: «بدأ برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَجَعُهُ يومَ الأربعاءِ فأصبح يومَ الخميسِ فعَقَدَ لأُسامةَ فقال: «اغْزُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَسِرْ إِلَى مَوْضِعِ مَقْتَلِ أَبِيكَ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ هَذَا الجَيْشَ» فذكر القِصَّةَ وفيها: «لم يبقَ أحدٌ مِنَ المُهاجرينَ الأَوَّلينَ إلَّا انتُدِبَ في تلك الغَزوةِ منهم: أبو بكرٍ وعُمَر، ولَمَّا جهَّزه أبو بكرٍ بعد أن استُخلِفَ سأله أبو بكرٍ أن يأذن لعُمَرَ بالإقامةِ فأَذِنَ» ذَكَر ذلك كلَّه ابنُ الجَوزِيِّ في «المنتظم» جازمًا به».
(٩) جَعلَ المُصنِّف ـ رحمه الله ـ تَوليَةَ الكُفءِ مُقدَّمًا على الخَيِّرِ مأخوذًا مِن قول أبي بكرٍ رضي الله عنه: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ»، والحقيقةُ أنَّه لا يُسْعِفُهُ معنى العبارةِ السَّالفةِ لتأصيلِ ما ذَكَره؛ لعَدَمِ تطابُقِهِ مع شروحِ العُلماءِ السَّابقينَ لها، إذ لم يَرِدْ عنهم ـ في حدود علمي ـ أنَّهم شرحوها بمراد المصنِّف ـ رحمه الله ـ، علمًا أنَّ عبارة: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ» تحتمِلُ عِدَّةَ معانٍ، أشهرُها وأصحُّها: أنَّها واردةٌ مِنْ باب الهضم والتواضعِ؛ لأنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان عديمَ النَّظيرِ في الصَّحابةِ، والصَّحابةُ رضي الله عنهم مُجمِعون على أنَّه أفضلُهُم وخيرُهم على الإطلاق؛ [انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٢٤٨)]، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ يَرجِعُ إلى فضلِهِ رضي الله عنه وتواضعِهِ وكراهِيَتِه تزكيةَ نفسِهِ، وهذه صِفةُ الخائفينِ للهِ الذينَ لا يُعجَبون بعملٍ ولا يَستكثِرون مُهَجَ أنفسِهِم وأموالَهُم، قال أبو نُعيمٍ الأصفهانيُّ ـ رحمه الله ـ [في «الإمامة والرَّدُّ على الرافضة» (٢٦٨)] ما نصُّه: «إنَّما حَمَله على هذا الكلامِ التَّوَاضعُ والإزراءُ على نفسِهِ وإزالةُ العُجبِ عنها، وليس منهم أحدٌ إِلَّا وقد قال مثلَه وَأعظمَ منه في حالِ الإزراءِ على النَّفسِ والخوفِ عليها، وذلك سَجِيَّةُ أهلِ الخَوْف والتُّقى لَا يَركَنون إلى شيءٍ مِنْ أعمالِهِم وأحوالِهِم، بل يُلزِمون أنفسَهم الذِّلَّةَ والتَّواضعَ، ومثلُ ذلك قَوْلُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري في «الخصومات» (٥/ ٧٠) بابُ ما يُذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، ومسلم في «الفضائل» (١٥/ ١٣٢) بابٌ مِنْ فضائل موسى صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، مِنْ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ»]، «وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»؛ [أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» (٦/ ٤٥٠) باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٣٩﴾ [الصافَّات]، مِن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]، وَكَقَوْلِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُفَ؛ لَو لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لَأَسْرَعْتُ»؛ [هذا الحديث والذي بعده حديث واحدٌ مُتَّفَق عليه، أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» (٦/ ٤١٠) باب: ﴿وَنَبِّئۡهُمۡ عَن ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٥١﴾ [الحِجر]، ومسلم في «الفضائل» (١٥/ ١٢٢) بابٌ مِنْ فضائل إبراهيم الخليل صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، وَكَقَوْلِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»؛ [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق].
كلُّ ذَلِك إِنَّمَا قَالَه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ليقتديَ بِهِ المُؤْمِنُونَ، وَلَا يَرفعون [كذا، والصَّواب: يرفعوا] مِنْ أنفسِهِم، بل يَلزمون التَّوَاضُعَ والإزراءَ».
هذا، ومِن معاني عبارةِ: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ»: «أنَّه أرادَ: لستُ بخيركم قَبِيلةً ولا عشيرةً؛ لأنَّ بني هاشمٍ وبني عبدِ المُطَّلبِ أعلى منه في ذِرْوةِ النَّسب، لِيَدُلَّهم بذلك أنَّ الأمر [الإمامة] لا يُستَحقُّ بعُلُوِّ النَّسَب»؛ [«الانتصار في الرَّدِّ على المعتزلة» للعمراني (٣/ ٨٥٨)، وانظر: «تمهيد الأوائل» للباقلَّاني (٤٩٤)].
ويحتمل أن يكون معناها ـ أيضًا ـ أنَّه يجوز عليَّ مِنَ السَّهو والغَلَط ووساوس الصُّدور وخواطرِ النُّفوسِ ما يجوز مِنَ السَّهو عليكم، وذلك ليُرشِدَهم ويُنبِّهَهُم على فسادِ قولِ مَنْ زعم أنَّ أمر الإمامةِ لا يَستحِقُّه إلَّا الوافر المعصوم؛ [انظر: «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلَّاني (٤٩٤)].
فهذه جُملةٌ مِن شروح العبارة السَّابقة، وتقدَّم المعنى الرَّاجح منها، وليس فيها ما يؤيِّد كلامَ المصنِّف ـ رحمه الله ـ في تأصيله، فما هو منه إلَّا نوعُ اجتهادٍ يُؤجَر عليه ـ إنْ شاء الله ـ.
- قرئت 37344 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)