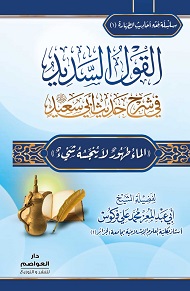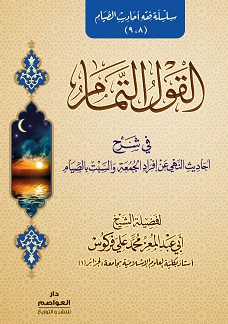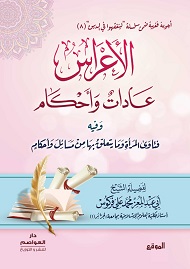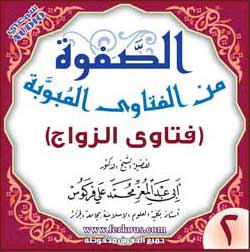الكلمة الشهرية رقم: ١٥٢

[الحلقةُ الخامسةَ عَشْرَةَ]
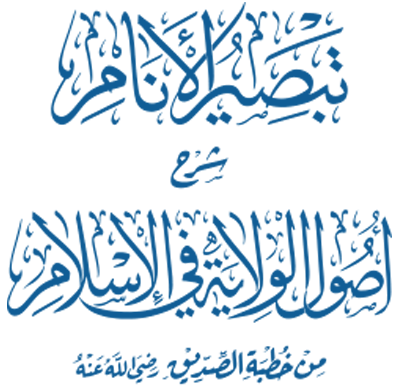
[ ٤ ]
[الجزءُ الرَّابعُ]
قالَ الشَّيخُ عبدُ الحَميدِ بنُ بَاديسَ ـ رحمهُ اللهُ ـ:
«الأصلُ الثَّالث
[نيل الخيرية بالسلوك والأعمال]
لَا يَكُونُ أَحَدٌ ـ بِمُجَرَّدِ وِلَايَتِهِ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ ـ خَيْرًا مِنَ الأُمَّةِ، وَإِنَّمَا تُنَالُ الخَيْرِيَّةُ بِالسُّلُوكِ وَالأَعْمَالِ(١)؛ فَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ خَيْرَهُمْ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمْ، بَلْ ذَلِكَ لِأَعْمَالِهِ وَمَوَاقِفِهِ(٢).
وَهَذَا الأَصْلُ مَأْخُوذٌ ـ أَيْضًا ـ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ»، حَيْثُ نَفَى الخَيْرَ عِنْدَ ثُبُوتِ الوِلَايَةِ(٣).
الأصلُ الرَّابع
[مراقبة الأمة لولي الأمر]
حَقُّ الأُمَّةِ فِي مُرَاقَبَةِ أُولِي الأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا مَصْدَرُ سُلْطَتِهِمْ وَصَاحِبَةُ النَّظَرِ فِي وِلَايَتِهِمْ وَعَزْلِهِمْ(٤)».
ـ يُتبَع ـ
(١) قول المُصنِّف ـ رحمه الله ـ: «وَإِنَّمَا تُنَالُ الخَيْرِيَّةُ بِالسُّلُوكِ وَالأَعْمَالِ» فهي خَيرِيَّةٌ مُرتبطةٌ بسِيرَةِ المَرءِ الذَّاتيَّةِ وهي مُتوقِّفةٌ على أصلين مُهمَّينِ:
الأوَّلُ: الخُلُقُ الحَسَنُ الَّذِي له أهمِّيَّتُهُ البالغةُ في التَّأثيرِ في سُلوكِهِ وما يَصدُر عنه، فهو ـ على التَّحقيقِ ـ شطرُ الدِّينِ، وثَمَرةُ مُجاهدةِ المُتَّقينَ، وقد دَعَا الإسلامُ إلى التَّحلِّي بالأخلاقِ الحَسنَةِ مِنَ العِلمِ والإِخلاصِ والصِّدقِ، والعَدْلِ والاعتدالِ، والأمانةِ والوفاءِ بالعهدِ، والثَّباتِ على الحقِّ، والدَّوامِ على الطَّاعَةِ، والقُوَّةِ والعزيمَةِ والحَزْمِ، واليَقَظةِ والتَّوادِّ والتَّراحُمِ والرُّجُوعِ إلى الحَقِّ، ومُحاسَبَةِ النَّفسِ ونحوِ ذلك، هذا مِنْ جهةِ التَّحَلِّي.
كما دعَا الإسلامُ ـ من جهة أُخرى ـ إلى التَّخلِّي عنِ الأخلاقِ الرَّذيلةِ ممَّا يُضادُّ ما تَقدَّمَ مِنَ الأخلاقِ الحَسَنَةِ أو يُناقِضُهَا كالظُّلمِ والرِّياءِ والكَذِبِ والخِيانَةِ والتَّكبُّرِ والعُجْبِ والإسرافِ والتَّبذيرِ والقَوْلِ بلا عِلْمٍ ونحوِ ذلك، عِلمًا أنَّه لا يكفي العِلمُ وحدَهُ بِدونِ عملٍ في اكتسابِ الخُلُق الحَسَنِ، بل لا بدَّ مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ والأفعالِ النَّافعةِ مِن جميعِ أنواعِ العباداتِ والطَّاعاتِ المفروضةِ والمندوبةِ الَّتي تُؤدِّي إلى التَّحلِّي بالأخلاقِ الزَّكيَّةِ وتقويمِها وطَردِ الخبيثَةِ منها، فهو مَأمورٌ بِمُباشَرتِها لتحقيقِ زكاةِ النَّفسِ وتَهيئتِها لاكتسابِ الأَخلاقِ الفاضلةِ، وتَخْليصِها مِن قَبائحِ الصِّفاتِ ورذائلِ المعاني المُستقِرَّةِ في النَّفسِ، عَملًا بقوله تعالى: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩﴾ [الشمس]، فَصَلَاحُ أعمالِ الإنسانِ مَقرُونٌ بصلاحِ أَخلاقِهِ «فيَحفظُ صَلَاحَ أخلاقِهِ كَمَا يَحفظُ صَلَاحَ جسدِهِ، وَلَا يَغفُلُ عَن مُراعاتِها ثِقَةً بِصلاحِها، فَإِنَّ الهوَى مَرَاصِدُ، والمُهمِلُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسادِ»؛ [«تسهيلُ النَّظرِ وتَعجِيلُ الظَّفرِ في أَخلاقِ المَلِكِ وسِياسَة المُلك» للمَاوَرْدي (٣٣)].
الثاني: مُوافَقةُ العمل للقول، فالآمرُ بالمعروفِ والخيرِ يَنبغِي أَنْ يكونَ أَوَّلَ النَّاسِ مُبادرةً إِليهِ، كما ينبغي على النَّاهِي عن المُنكَر والشَّرِّ أَنْ يَكونَ أوَّلَ النَّاسِ تركًا له وأبْعدَهم عنه، فَمُوافقةُ القولِ للعَمَلِ أَدْعَى لِقَبولِ قولِ قائلِه والإقبالِ عليه؛ لأنَّ النَّفسَ مَجبولةٌ عَلى عَدمِ الانتِفاعِ بِكلامِ مَنْ لا يَعملُ بِعلمِهِ، ولا يُوَافِقُ فِعلُه قَولَهُ، وقد حذَّر اللهُ مِن هذه الصِّفةِ المَمْقُوتةِ في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣﴾ [الصَّف]، وقولِه تعالى: ﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤﴾ [البقرة]، ولهذا قال شُعيبٌ عليه السلام لقومِهِ: ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُ﴾ [هود: ٨٨]، وضِمن هذا المعنى: قال المَاوَرْدِي ـ رحمه الله ـ [في «تسهيل النَّظر» (١٣٥، ١٣٦)]: «لا يَحسُنُ بِالمَلِكِ أَنْ يَأْمُرَ بالمعروفِ إِلَّا بَدَأَ بفعله، وَلَا يَنهَى عَن مُنكرٍ إِلَّا بَدَأَ بتركِه، ولا يَلُمْ أحدًا فيما لا يلومُ عليه نَفسَه، ولا يستقبح منه ما لا يَستقبِحُهُ مِن نفسِه، وَلَا يَأْمُرْهُم بالبرِّ بما لَا يأمرُ به نَفسه، فإنَّ النَّاسَ على شاكلةِ مُلُوكِهِم يَجرونَ، وبأخلاقِهِم يَسْتَنُّونَ؛ لأنَّهم أعلامٌ متبوعةٌ ومناهجُ مشروعةٌ.. وجديرٌ بِمَن أَمرَ بصلاحٍ أَنْ يكون أَحقَّ بِفعلهِ، وبمَنْ نهى عن فسادٍ أَنْ يكونَ أحقَّ بتركِه؛ ولَئِنْ كان عُلوُّ القَدْرِ لَا يزيدُهُ تَحفُّظًا لم يَنقص» [بتصرُّف].
(٢) لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَضائلُ ومناقبُ عديدةٌ سبقَ ذِكرُ بَعضِهَا؛ [انظر: الجزء الأوَّل، والجزء الثاني]، كمَا له جُملَةٌ مِنَ المَواقِفِ الشُّجاعةِ والثَّابِتَةِ في زَمنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَبَعدَ وفاتِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، يُمكنُ إِيرادُ بعضِهَا باختصارٍ شَديدٍ على الوَجهِ الآتي:
• ففي زمن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يظهرُ مَوقِفُ أبي بكرٍ رضي الله عنه صَريحًا في الدِّفاعِ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَنُصرَتِهِ سَواءٌ في تَصدِيقِهِ والحِرصِ على حِمايَتِهِ، أَو في بَذْلِ مالِه للإنفاقِ في سَبِيلِ اللهِ، وقَد تَجلَّى إنفاقُ مَالِه في عِتقِ الرِّقَابِ، أو في اصطحابِه مالَه جَميعًا يَومَ الهِجرةِ لإنفَاقِهِ على رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، رغم أنه تَرَك والدَيْه وزوجَه وأولادَه بمكَّة، أَو في تَصدُّقِهِ بجَميعِ مالِهِ في غَزْوةِ تَبُوك.
• أمَّا عَقِبَ وفاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فيَظهرُ مَوقفُهُ في إنفاذِ جَيشِ أُسامةَ بنِ زَيدٍ رضي الله عنهما رَغْمَ ما حَصَلَ مِن شِدَّةِ الأحوالِ والأهوال واعتراضِ باقي الصَّحابة رضي الله عنهم، كما يتجلَّى موقفُهُ رضي الله عنه ـ أيضًا ـ في قتال مُسيلِمَةَ الكذَّابِ وأهلِ الرِّدَّةِ ومَانِعِي الزَّكاةِ، وفي جمعِ القرآنِ، وما إلى ذلك مِنَ المَواقفِ المحمودةِ ممَّا تَنَاولَتْهُ المصَادرُ التَّاريخيَّةُ؛ [انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢/ ٣٣٤)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ٣٠٤)، «تاريخ الخلفاء» للسُّيوطي (٣١، ٥٨، ٦٧)، «تاريخ الأمم الإسلامية» للخضري بك (١/ ١٨٦)].
(٣) أمَّا استِدلالُ المصنِّفِ ـ رحمه الله ـ بقولِ أبي بَكرٍ رضي الله عنه: «وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ» على نَفيِ الخَيرِ عِند ثُبُوتِ الوِلَايةِ فَقد تقدَّم أنَّه بعيدٌ وغيرُ سَديدٍ، وليس في العبارة ما يؤيِّد كلام المصنِّف ـ رحمه الله ـ في تأصيله؛ [انظر: الموضع الأوَّل، الموضع الثاني، الموضع الثالث]، وإنَّما أشهرُ مَعانيها وأصحُّها أنَّها خَرجَتْ مِن بابِ الهَضمِ والتَّواضُع والإزرَاءِ عَلى النَّفسِ والخوفِ عليها وإزَالَةِ العُجْبِ عَنها، وهو سَجِيَّةُ أهلِ الخَوفِ والتَّقوى مِن الأنبياءِ والصَّالحينَ.
(٤) ويجدر ـ في هذا المَقام ـ التَّنبيه على: أنَّ مُصطلَحَ (الرَّقابة) لم يُستعمَلْ ـ عند المتقدِّمين ـ في الفقه الإسلاميِّ عمومًا، ولا في النُّظُم السياسيَّة الإسلاميَّة خصوصًا، وإنَّما استعمَلَتْ ـ في هذا المعنى ـ مُصطلَحاتٍ أخرى أوسعَ منه ومُستلزِمةً له، مثل: (النُّصح، أو الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، أو الحِسبة)، وغيرها.
فالنُّصوصُ الشَّرعيَّة في الأمر بالمعروف والنَّهيِ عن المُنكَرِ والنَّصيحةِ جاءت ظاهرةً في دلالتها وصراحتِها على أنَّ للأُمَّةِ سلطةً في مُراقَبةِ الحُكَّامِ وتقويمِهم، وأوَّلُ مَنْ عَمِل بها وطبَّقها الخليفةُ الرَّاشدُ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه ـ كما تقدَّم في نصِّ خُطبتهِ ـ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ [في «شرح مسلم» (٢/ ٢٣)]: «قال العلماء: لا يختصُّ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المُنكَرِ بأصحاب الولايات، بل ذلك جائزٌ لآحاد المسلمين؛ قال إمام الحرَمَيْن: والدليلُ عليه إجماعُ المسلمين، فإنَّ غيرَ الوُلَاة في الصدر الأوَّلِ والعصرِ الذي يَلِيه كانوا يأمرون الوُلَاةَ بالمعروف وينهَوْنَهم عن المُنكَر، مع تقرير المسلمين إيَّاهم وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُل بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ مِنْ غيرِ وِلايةٍ».
وإِذا تَقرَّرَ ـ بناءً عَلى طرِيقِ الاخْتِيارِ والبَيعَةِ في انعِقادِ الإمامَةِ الكُبرَى ـ أنَّ حَقَّ التَّوليةِ والعَزلِ ثَابتٌ لأَهلِ الحَلِّ والعَقْدِ، وأنَّ عليهم مسؤوليَّةً في اختياره أمامَ الله والرَّعيَّة، وأنَّه ينبغي عليهم أَنْ يختاروا أصلحَ مَنْ يعلمونَه لهم، فضلًا عن كونِه يَصلحُ للأمرِ، فإنَّ عليهم الحرصَ على بقائه على ذلك باستدامة النَّظر في أحكامه وأفعاله التي يسوس بها الأُمَّة، لأنَّ أمرَ المؤمنين شُورَى بينهم، ولِيَتسنَّى لهم تقويمُ سلوكِه: فإِنْ أصابَ أعانوه، وإِنْ زاغَ قوَّموه وسدَّدوه، وإِنْ أخطأَ في اجتهادٍ صوَّبوه، وإِنْ سها نبَّهوه، وإِنْ رأى رأيًا ووجدوا غيرَه أجدى منه أشاروا عليه به.
هذا، وليست الرَّقابةُ حقًّا للأُمَّة تُمارسُه بنفسِها أو بمَن تختارُهم هي، وإنَّما هي واجبٌ ومسؤوليةٌ ملقاةٌ على عاتقِ أهلِ الحلِّ والعقدِ وأهلِ الشُّورى وغيرِهم مِنَ العلماءِ، حتى يكونَ الحاكِمُ أو وَلِيُّ الأَمرِ مَسؤُولًا عَن جَميعِ تَصرُّفاتِهِ أَمامَ الرَّعِيَّةِ فِيما كان مُكلَّفًا فِيه، فَضلًا عن عِبْءِ أمانتِهِ وثِقَلِ مسئُولِيَّته الكُبرَى التي تنتظرُهُ أمامَ اللهِ تعالى يَومَ الآخِرةِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨﴾ [النساء]، وقَال تَعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧﴾ [الأنفال]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجَه البُخارِي في «الجمعة» (٢/ ٣٨٠) باب الجمعة في القرى والمُدن، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٢/ ٢١٣) باب فضيلةِ الإمامِ العَادلِ وعُقوبَةِ الجَائِرِ، والحثِّ على الرِّفْقِ بالرَّعِيَّةِ، والنَّهيِ عَن إدْخالِ المَشقَّةِ عَليهِم، مِن حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» (١٣/ ١٢٧) بابُ مَن استُرْعِيَ رعيةً فلم ينصح، ومسلم في «الإمارة» (١٢/ ٢١٤) باب فضيلةِ الإمامِ العَادلِ، مِن حديث مَعقِلِ بنِ يَسار رضي الله عنه].
فَإِنْ أدَّى الإمامُ الأعظمُ أمانةَ الوِلايةِ العَامَّةِ على الوَجهِ المَرْضِيِّ شرعًا، فأقامَ العَدلَ وَنفَّذَ شَريعةَ اللهِ في عِبادِهِ وصانَ الحُدودَ وحَفِظَ الحقوقَ، وسارَ بالأُمَّةِ ـ في العموم ـ بالحقِّ والاعتِدالِ فإنَّهُ تَلزمُ طَاعتُه ولو حَصَلَ مِنهُ شيءٌ مِنَ الجَوْرِ أو الفِسقِ أو ظُلمٌ بِغَصْبِ الأموالِ وتَضيِيعِ الحقوقِ والاعتِداءِ عَلى النُّفُوسِ المُحرَّمةِ، ولا يُطاعُ ـ سواءٌ جار أو عدَلَ ـ إلَّا في المعروف دون المعصية، ولا يَنعَزِلُ الإمامُ الأَعظمُ بالفِسقِ والظُّلمِ وتعطيلِ الحقوقِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ، ولا يُخْلَعُ ولا يَجوزُ الخروجُ عليه، بَل يجبُ الإنكارُ عَليه باللِّينِ، ووَعظُهُ وتَخوِيفُهُ بالله ووعيدِه، والدُّعاءُ له بالصَّلاحِ والإصلاحِ والتَّوفِيقِ لبَسطِ العَدلِ في الرَّعِيَّةِ، للأَخبارِ الكثيرةِ المُتَظاهِرةِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وأَصحَابِهِ في وجُوبِ طاعَةِ الأئِمَّةِ في المعرُوفِ وإِن جارُوا؛ قال أبو الحسنِ الأشعريُّ رحمه الله ـ وهو يُعدِّدُ ما أَجْمَعَ عليه السَّلفُ مِنَ الأصول ـ: [في «رسالته إلى أهل الثَّغر» (٢٩٦)]: «وأجمعوا على السَّمْعِ والطَّاعةِ لأئمَّةِ المُسلمين، وعلى أنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شيئًا مِنْ أمورهم عن رِضًى أو غَلَبةٍ وامتدَّتْ طاعتُهُ مِنْ بَرٍّ وفاجرٍ لا يَلْزَمُ الخروجُ عليهم بالسَّيف، جارَ أو عَدَلَ».
وقال الصَّابونيُّ ـ رحمه الله ـ [في «عقيدة السَّلف» (٩٢)]: «ويرى أصحابُ الحديثِ: الجمعةَ والعِيدَينِ وغيرَهما مِنَ الصَّلوات خَلْفَ كُلِّ إمامٍ مسلمٍ بَرًّا كان أو فاجرًا، ويَرَوْنَ جهادَ الكَفَرَةِ معهم وإِنْ كانوا جَوَرَةً فَجَرَةً، ويَرَوْنَ الدُّعاءَ لهم بالإصلاح والتَّوفيقِ والصَّلاحِ وبَسْطِ العَدل في الرَّعيَّة، ولا يَرَوْنَ الخروجَ عليهم وإِنْ رَأَوْا منهم العُدولَ عن العدل إلى الجَوْرِ والحَيفِ، ويَرَوْنَ قتالَ الفِئَةِ الباغيةِ حتَّى ترجعَ إلى طاعةِ الإمامِ العَدْلِ».
وقال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ [في «شرحه على مسلم» (١٢/ ٢٢٩)]: «لا تُنازِعوا وُلَاةَ الأمورِ في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلَّا أَنْ تَرَوْا منهم مُنْكَرًا مُحقَّقًا تعلمونه مِنْ قواعدِ الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأَنْكِروهُ عليهم وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتالُهم فحرامٌ بإجماعِ المسلمين وإِنْ كانوا فَسَقَةً ظالمين، وقد تَظاهَرَتِ الأحاديثُ بمَعْنَى ما ذَكَرْتُه، وأَجْمَعَ أهلُ السُّنَّةِ أنَّه لا يَنْعَزِلُ السُّلطانُ بالفِسقِ»؛ [وللمَزيدِ يمكن مُراجَعةُ المَصادِرِ التالية: «مقالات الإسلاميِّين» (١/ ٣٤٨) و«الإبانة» (٦١) كلاهما للأشعري، «الشَّريعة» للآجُرِّي (٣٨ ـ ٤١)، «اعتقاد أئمَّة الحديث» للإسماعيلي (٧٥)، «الشَّرح والإبانة» لابن بطَّة (٢٧٦)، «تمهيد الأوائل» للباقلاني (٤٧٨)، «الاعتقاد» للبيهقي (٢٤٢)، «منهاج السُّنَّة» (٢/ ٧٦) و«مجموع الفتاوى» (٤/ ٤٤٤) كلاهما لابن تيمية، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٢/ ٥٤٠)، والكلمة رقم: (116) الموسومة ﺑ: «تقرير مذهب السلف محقَّقًا في عدم جواز عزلِ الإمام أو انعزاله بالفسق مُطلَقًا» مطبوعة مع «تسليط الأضواء» (ص ٨٨)].
وأمَّا إذا قام الإمامُ بما يُوجِبُ على الأُمَّة خَلْعَه مِن: كُفرٍ بعد إِيمانٍ، إذْ لَا وِلايةَ للكافرِ على المُسلمِ قولًا واحدًا عند العلماءِ، أو تَركِ إقامَةِ الصَّلاةِ والدُّعاءِ إِليهَا، وتَوفَّرَت لها القدرةُ والاستطاعةُ على تنحيتِهِ مِن مَنصبِهِ وتبديلِه بمسلمٍ كُفْءٍ للإمامة يُقيمُ الدِّينَ ويحفظ الشَّريعة مع أَمْنِ الوقوعِ في الأضرارِ والمَفاسِدِ وَجَبَ عليها إزالتُه وخَلعُهُ إجماعًا؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ٥٩]، والكافرُ لا يُعَدُّ مِنَ المسلمين، وقال تعالى: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١﴾ [النساء]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ»؛ [أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٢/ ٢٤٥) بابُ خِيَارِ الأئمَّةِ وشِرَارِهم، مِنْ حديثِ عوف بنِ مالكٍ رضي الله عنه]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الفِتَن» (١٣/ ٥) بابُ قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٢/ ٢٢٨) بابُ وجوبِ طاعة الأُمَراء في غيرِ معصيةٍ وتحريمِها في المعصية، مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا، مَا صَلَّوْا»؛ [أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٢/ ٢٤٢) باب وجوبِ الإنكارِ على الأمراءِ فيما يخالف الشَّرعَ، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها]، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ [في «فتح الباري» (١٣/ ١٢٣)]: «ومُلخَّصُه أنَّه يَنْعَزِلُ بالكُفرِ إجماعًا؛ فيجبُ على كُلِّ مسلمٍ القِيامُ في ذلك: فمَنْ قَوِيَ على ذلك فله الثَّوابُ، ومَنْ داهَنَ فعليه الإثمُ»؛ ونَقَل النَّوويُّ [في «شرح مسلم» (١٢/ ٢٢٩)] عن القاضي عياضٍ ـ رحمه الله ـ أنَّه قال: «أجمع العلماء على أنَّ الإمامةَ لا تنعقدُ لكافرٍ، وعلى أنَّه لو طَرَأ عليه الكفرُ انعزل.. فلو طَرَأ عليه كفرٌ وتغييرٌ للشَّرع.. خَرَج عن حكم الولاية وسقطَتْ طاعتُه، ووَجَب على المُسلمين القيامُ عليه وخلعُه ونَصْبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك، فإِنْ لم يقع ذلك إلَّا لطائفةٍ وَجَب عليهم القيامُ بخلع الكافر» [بتصرُّفٍ]؛ [راجع ـ أيضًا ـ: «تمهيد الأوائل» للبَاقِلَّاني (٤٧٨)، «المَواقِف» للإيجي (٣/ ٥٩٥)، «مَنصِبُ الإمَامَةِ الكُبْرى» للمُؤلِّفِ (٢٤)].
هذا والمُصنِّف ـ رحمه الله ـ استدلَّ على هذا الأصل بقول أبي بكرٍ رضي الله عنه: «إِذَا رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي» ورأى ـ رحمه الله ـ تأخيرَ ذكرِه إلى الأصلِ الخامِسِ، تجنُّبًا للتَّكرار، وسيأتي بيانُه ـ إن شاء الله ـ في ذلك الموضع.
- قرئت 33460 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)