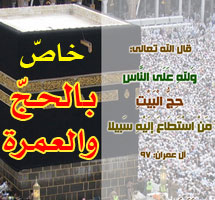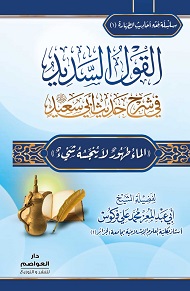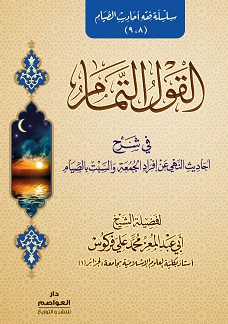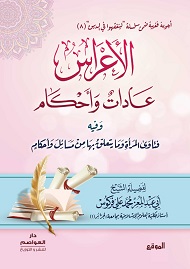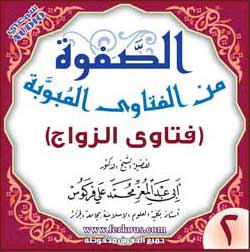الكلمة الشهرية رقم: ٤
في أخلاق الداعية وأولويات دعوته
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
الكلمة الشهرية رقم: ٤
في أخلاق الداعية وأولويات دعوته
السؤال:
¨ ما هي مَنْزِلة الأخلاق في الدعوة إلى الله تعالى؟
¨ ما هي أهمُّ أخلاق الداعي إلى الله تعالى التي يجب التحلِّي بها حتَّى يؤدِّيَ مَهَمَّته ورسالتَه الرِّياديَّة؟
¨ هل مِنْ نصيحةٍ توجِّهونها لإمامِ وخطيبِ المستقبل حتَّى يكون ناجحًا وموفَّقًا في رسالته الدعويَّة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الإسلام نَوَّه بالخُلُق الحَسَن، ودَعَا إلى غَرْسه وتنمِيَتِه في نفوس المسلمين، وأكَّده في غيرِ ما موضعٍ حيث جَعَلَ اللهُ تعالى الأخلاقَ الفاضلة سببَ تحصيلِ الجنَّةِ الموعودِ بها ونيلِها في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤﴾ [آل عمران]، كما أَوْجَبَ التخلُّقَ بالخُلُق الحَسَن، وجَعَلَ له أثرًا طيِّبًا ينعكس على المُعامَلات بالإيجاب، كما قال تعالى: ﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤﴾ [فُصِّلت]، كما اعتبر الشرعُ الخُلُقَ الحَسَنَ مِنْ أَفْضَلِ الأعمال وجَعَلَ البِرَّ فيه، وأَثْنَى على نبيِّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم]، وبَعَثَه اللهُ تعالى لإكمالِ هذه الأخلاقِ كما في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»(١)، وبيَّن صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّ: «البِرَّ حُسْنُ الخُلُقِ»(٢)، وقال: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا»(٣)، وقال: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»(٤).
هذا، ولَمَّا أثنى اللهُ تعالى على نبيِّه بحُسْنِ الخُلُق وبَعَثَه لإتمامِ مَكارِمِ الأخلاق، وكان النبيُّ المَثَلَ الأعلى للدُّعاة في حياتهم الخاصَّة والعامَّة؛ كان ينبغي على الداعيةِ التأسِّي به صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وتجريدُ المُتابَعةِ له صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، قال تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: ٢١]، واتِّخاذُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قدوةً وأُسوةً هو مطلوبٌ على عمومِ وأعيانِ المسلمين، ليس لهم في ذلك وُسْعٌ ولا خِيَرَةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ فأَمْرُه في حقِّ الدُّعاة أَوْكَدُ؛ لأنَّ رسالتهم الدعوةُ إلى هَدْيِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ومنهجِه وطريقته، بعد اقتفاء أثَرِه وتَرسُّمِ خُطاهُ والاستضاءةِ بالهدي النبويِّ؛ إذ هو سبيلُ النجاةِ مِنْ كُلِّ شرٍّ والفوزِ بكُلِّ خيرٍ، وقد جَعَله اللهُ تعالى المبلِّغَ والسراج والهاديَ كما قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾ [الأحزاب]، ولا يخفى أنَّ الناس يترقَّبون أفعالَ الدُّعاةِ وسيرتَهم، ويَرَوْن فيها تطبيقًا عمليًّا حيًّا لِمَا يَدْعون إليه بما عَلِموه وعَمِلوا به بالبيان والقدوة، فإِنْ لم يسلكوا هذا المنهجَ ـ وهو منهجُ الرشدِ والهدايةِ، والمستضاءُ به في ظُلُمات الجهل والغواية ـ فقَدْ ضلُّوا وأَضَلُّوا؛ قال تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران].
هذا، ومِنْ أَوْلى مهمَّات الداعي إلى الله تعالى التأسِّي بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في تزكية نَفْسه إلى درجة الانقياد والخضوعِ المطلق لله عزَّ وجلَّ في كُلِّ مطلوبٍ ومأمورٍ، بأداءِ العبادات المفروضة والمُستحَبَّة، سواءٌ كانَتْ بدنيَّةً أو ماليَّةً، وختمِ القرآن تلاوةً وتدبُّرًا وتأمُّلًا وتفكُّرًا على الأَقَلِّ مرَّةً كُلَّ شهرٍ، والإكثارِ مِنَ الاستغفار وذِكْرِ الله ليكون جزءًا مِنْ حياة الداعي ليَتَّصِفَ بالمُسارِعين بالخيرات وأهلِ التقوى والصلاحِ الموصوفين بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ﴾ [آل عمران: ١٩١]، فضلًا عن الإتيان ببقيَّة الأعمال الصالحة التي تزكو النفسُ بها وتَتهذَّبُ غرائزُها وتصفو مَدارِكُها: كَبِرِّ الوالدَيْن، وصِلَةِ الرَّحِم، وخدمةِ المُستضعَفين والمساكين، وتفقُّدِ حاجات المُعْوَزين مع التواضع لهم، وغيرِها مِنْ أنواع الطاعات؛ ذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يَتحنَّثُ في الغار اللياليَ ذواتِ العدد(٥)، يخلو بربِّه ويُناجِيه، وكان بعد مَبْعَثِه أَتْقَى الناسِ وأزكاهم نَفْسًا وأَحْسَنَهم أخلاقًا وأتقاهم سريرةً وأَعْبَدَهم لله تعالى.
ثمَّ يلي في الأولويَّة مُتابَعةُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في منهجه الأخلاقيِّ والتأسِّي به فيه، وقد قدَّمْنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان على خُلُقٍ عظيمٍ بشهادةِ ربِّ العالَمين، حيث تجلَّتْ فيه سائرُ نعوت الجمال والجلال والكمال، مِنَ الإخلاص والأمانة والبِرِّ والحكمة والحِلْم والرحمة والرفق والتواضع والصدق والإيثار والوفاء وغيرها، كما أنَّ في شريعته مِنَ الشِّدَّة والعِزَّة والجهادِ على أعداء الله وإقامةِ الحدود على الظالمين ما لا يخفى، قال تعالى: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة]، وقُرِئَتْ: ﴿مِّنۡ أَنفَسِكُمۡ﴾، بفتح (الفاء)، ويكون مُرادُه: مِنْ أَفْضَلِكم خُلُقًا، وأَشْرَفِكم نَسَبًا، وأَكْثَرِكم طاعةً لله تعالى؛ قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «ففي شريعته صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِنَ اللين والعفو والصفح ومَكارِمِ الأخلاقِ أَعْظَمُ ممَّا في الإنجيل، وفيها مِنَ الشدَّة والجهاد وإقامة الحدود على الكُفَّار والمُنافِقِين أَعْظَمُ ممَّا في التوراة، وهذا هو غايةُ الكمال؛ ولهذا قال بعضُهم: بُعِث موسى بالجلال، وبُعِث عيسى بالجمال، وبُعِث محمَّدٌ بالكمال»(٦)؛ وقال: «وقد ذَكَرَ نَعْتَ المُحِبِّين في قوله: ﴿فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ﴾ [المائدة: ٥٤]؛ فنَعَتَ المُحِبِّين المحبوبين بوصف الكمال الذي نَعَتَ اللهُ به رسولَه الجامعَ بين معنى الجلال والجمال المفرَّقِ في الملَّتين قبلنا، وهو: الشدَّةُ والعزَّةُ على أعداء الله، والذلَّةُ والرحمةُ لأولياء الله ورسوله»(٧).
ومِنَ الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلِّي بها مُتابَعةُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في الحياء الذي له الأثرُ البالغ على مَسَارِ الدعوة إلى الله تعالى لِمَا يُؤدِّي إليه هذا الخُلُقُ الرفيع مِنْ سلامة الطبع مِنَ الأمراض النفسيَّة المُفْسِدة، ومِنَ الأحقاد والضغائن المُهْلِكة؛ فقَدْ كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم «أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ»(٨).
ومِنْ أخلاق الداعية إلى الله الانضباطُ بالخُلُق الذي وَصَف اللهُ تعالى جانبًا منه بقوله: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [آل عمران]، وفي الحديث: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»(٩).
ومِنَ الأخلاق اهتمامُ الداعي إلى الله بالهدي الظاهريِّ شكلًا وهيئةً بحيث يَتناسَقُ الشكلُ على وجهِ الجلال والشرف، مع نظافة الثياب والبدن؛ فقَدْ أَخْرَجَ البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: «مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وَلَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ ـ أَوْ عَرْفًا قَطُّ ـ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ ـ أَوْ عَرْفِ ـ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»(١٠).
ومِنْ أصول الأخلاقِ إيثارُ الحِلْم وتركُ الغضبِ المذمومِ الذي يكون حميَّةً أو انتصارًا للنفس وغيرِها مِمَّا لا يكون في ذات الله، وقد وَصَفَ اللهُ تعالى الكاظمين الغيظَ بأَحْسَنِ وصفٍ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤﴾ [آل عمران]؛ ذلك لأنَّ مَنِ استطاع قَهْرَ نَفْسِه وغَلَبَتَها كانَتْ دعوةُ غيرِه أَسْهَلَ وأَيْسَرَ، قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»(١١).
هذا كُلُّه فيما يَمَسُّ حياتَه الخاصَّة، أمَّا حُرُماتُ الله تعالى فلا ينبغي أَنْ يَتهاوَنَ فيها أو يَتساهَلَ(١٢)، كما في حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بِهَا»(١٣).
هذا، ومَنْ تَحلَّى بمثلِ هذه الأخلاقِ السامية التي تُمثِّلُ عمادَ الدعوةِ في جانِبِها العمليِّ المفسِّرِ للجانب البيانيِّ؛ أَصْلَحَ اللهُ به الناسَ وعَمَّ خيرُه وانحسر شرُّه.
ولا يخفى أنَّ الدعوة الراشدة لا تكون مُثْمِرةً إلَّا إذا تَوافَقَتْ مع الهدي النبويِّ؛ ذلك لأنَّ أسلوبه ومنهجه في الدعوةِ أَكْمَلُ أسلوبٍ وأَتَمُّ منهجٍ؛ فقَدْ قال تعالى: ﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف].
والأسلوب النبويُّ في الدعوة كان مؤسَّسًا على توحيد الله عزَّ وجلَّ، ومُحارَبةِ مَظاهِرِ الشرك وأشكالِ الخُرافةِ وأنماطِ البِدَع، لتمكينِ العقيدة السليمة والصحيحة مِنَ الانتشار على نحوِ ما فَهِمَها السلفُ الصالح، تحقيقًا لعبوديَّةِ الله وَحْدَه لا شريكَ له؛ لذلك كان موضوعُ العقيدة تعليمًا وتصحيحًا وترسيخًا مِنْ أَوْلى الأولويَّات وأَسْمَى المهمَّات التي يجب على الداعي إعطاؤها العنايةَ الكافية التي تَستحِقُّها؛ كما ينبغي في أسلوبُ الدعوةِ ونَهْجِها أَنْ يرسم الداعي إلى الله الطريقَ القويم لكُلِّ مُخطِئٍ أو مُنحرِفٍ على وجهِ الشمول لتعمَّ فائدتُه ونَفْعُه، وهو جليٌّ في نصائحه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وخطاباته ودعوته كما في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟!...»(١٤)، وقولِه: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ؟!»(١٥)، وكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إذا بَلَغَهُ عن الرَّجُلِ الشيءُ لم يقل: ما بالُ فلانٍ يقول، ولكِنْ يقول: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا»(١٦)؛ إذ هذا الأسلوبُ أَبْعَدُ عن الانفعال والأنَفَة والاعتزازِ بالرأي عند عدَمِ جَدْواهُ، وهو إلى استصلاحِ الحالِ أَقْرَبُ.
ومِنَ الأسلوب الدعويِّ الذي ينبغي أَنْ يتحلَّى به الداعيةُ إلى الله تعالى: الرِّفْقُ ومجانبةُ العنف والشدَّة والفظاظة؛ فقَدْ قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»(١٧)، وقال ـ أيضًا ـ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»(١٨)، وفي الحديث: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»(١٩)؛ فالرفقُ في الأسلوب مِنْ أَبْرَزِ خصائصِ دعوةِ الحقِّ، قال تعالى: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥].
وينبغي على الداعي إلى الله ـ فضلًا عن الرفق ـ التعاملُ مع ما يَمَسُّ الدِّينَ منهجًا وعقيدةً بحزمٍ وثباتٍ؛ لأنَّ التهاون واللِّين يَترتَّبُ عليه ضياعُ مَعالِمِ الدِّينِ وفسادُ الأخلاق، ويدلُّ على ذلك حزمُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في امتناعه على وَفْدِ ثقيفٍ أَنْ يَدَعَ لهم اللَّاتَ لا يهدمها ثلاثَ سنين، وهَدَمها، كما أَبَى أَنْ يُعْفِيَهم مِنَ الصلاة ومِنَ الصدقة والجهاد(٢٠).
هذا؛ والذي يُطْلَبُ مِنَ الإمام أو الخطيب أَنْ يكون على بصيرةٍ في المجال الدعويِّ مِنْ علمٍ دقيقٍ بالشرع ومَقاصِدِه ومَراميه، مع الرباط الوثيق بالله تعالى والصلة به، قال تعالى: ﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف]؛ فأهلُ البصيرة هم أولو الألباب، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨﴾ [الزُّمَر]، والآيةُ تَصِفُ أهلَ اليقينِ والفطنة وسَعَةِ الإدراكِ والكياسة بحصول العلم لهم بالاستماع، وتحصل لهم الهدايةُ والتوفيقُ باتِّباعِ أَحْسَنِ القول، وهو الإسلامُ بلوازمه مِنْ أمرٍ ونهيٍ، ترغيبًا في الخير الذي هو سبيلُ النجاة، وترهيبًا مِنَ الشرِّ الذي هو سبيلُ الهلاك والدمار والعذاب، وبحصولِ هذه المرتبةِ يُوصِلُ المتبصِّرُ دعوتَه إلى غيره متيقِّنًا بمَراميها النبيلةِ التي مَدارُها على إخراج الناسِ مِنْ عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومِنْ ظُلُمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، تعلو به إلى مَدارِجِ الكمال المنشود.
وعليه؛ فإنَّ البصيرة التي يكون عليها الداعيةُ لا تُطْلَق على العلم وَحْدَه ما لم يُؤازِرْهُ تصديقٌ وعملٌ وتَقْوَى؛ فيتجسَّد عِلْمُه في معرفة الدِّين ومَراتِبِه الثلاث مِنْ إحسانٍ وإيمانٍ وإسلامٍ، ويتفاعل معها عملًا ودعوةً، متخلِّقًا بأخلاق الدُّعَاة، متبصِّرًا بأحوال المدعوِّين وعوائِدِهم وطِباعِهم وأعرافِهم، مُنتهِجًا معهم الأسلوبَ النبويَّ في الدعوة إلى الله ـ على ما تقدَّم ـ مع الإحاطة بالمَقاصِدِ العُليا للدعوة الإسلاميَّة، وإذا كانَتْ دعوتُه مؤسَّسةً على ضوءِ هديِ الكتاب والسُّنَّة حَازَ قَصَبَ السبق، قال تعالى: ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ [فُصِّلت]، ونَالَ رتبةَ المستنيرين بنور الله؛ قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
هذا، وعلى الداعي إلى الله التحلِّي بالصبر، وهو مِنَ الأهمِّيَّة بمكانٍ في مسيرة الدعوة والدُّعَاة خاصَّةً؛ إذ «بالصبر واليقين تُنالُ الإمامةُ في الدِّين» كما قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله تعالى ـ مُستدِلًّا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بَِٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤﴾ [السجدة]، وقد أَخْبَرَ اللهُ سبحانه وتعالى أنَّ أهل الصبر هم أهلُ العزائم، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣﴾ [الشورى]، وصبرُ الدُّعَاةِ على البلاء الذي يُصيبُهم هو مِنْ عزائمِ الأمور؛ لأنه صبرٌ على استكبار الجاحدين وجفوةِ العُصاة وعَنَتِ المَدْعُوِّين، وهو مِنْ علاماتِ أهل الصلاح المتَّقين، وهو يَشْمَلُ الصبرَ على الطاعة وعن المعصية وعلى أَذَى الناس وعلى الأقدار، ولقد واجَهَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كُلَّ أشكال الصدود والفجور، وكُلَّ ألوان الكُنود(٢١) والجُحود؛ فصَبَرَ عليها وصابَرَ ورابَطَ حتَّى أَتَمَّ اللهُ به دعوتَه وانتشرَتْ في الآفاق.
فالصبر ـ إذَنْ ـ له أثرُه البالغُ والحَسَنُ في نجاحِ مَهَمَّةِ الداعي بتوجيهِ الناس إلى الخير والرشد والسؤدد؛ لذا عليه أَنْ يتحمَّل ما يُواجِهُهُ مِنْ كُنودِ الناس وصُدودِهم وما يُحاكُ ضِدَّه في سبيل صَدِّه أو عرقلته ومنعِه سبيلَ الله، أو ما يُنْشَر حوله مِنْ إشاعاتٍ وأكاذيبَ واتِّهاماتٍ، ويُكادُ له مِنْ دسائسَ، قال تعالى: ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاۚ وَلَنَصۡبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيۡتُمُونَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ١٢﴾ [إبراهيم].
وفي الأخير، فالواجب على الدُّعاة في مسيرتهم الدعويَّة أَنْ يبتعدوا عن الجفوة والغِلْظة وسوءِ الأدب والتحوُّل عن الأخلاق والانقلاب عن المبادئ والثوابت، وأَنْ يتنزَّهوا عن الأغراض الدنيئة والاغترار بالدنيا؛ لأنَّ الانشغال والتلهِّيَ بها عن الآخرة أوَّلُ طريقِ الضَّياع، قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩﴾ [المنافقون].
كما عليهم التنَزُّهُ عن المَقاصِدِ الشخصيَّة التي تُصاحِبُ الجُفاةَ الغِلاظ، الذين تحمل دعوتُهم في ثناياها التجهيلَ والتجريح من غير مستند ولا دليل فضلًا عن التشهير والتعيير، بل والتكفير؛ فإنَّ مَرَضَ حُبِّ الظهور والإهانةِ والتشفِّي خُلُقٌ ذميمٌ ورذيلةٌ لا تَتوافَقُ مع الخُلُق الرقيق؛ فقَدْ كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَشَدَّ حياءً مِنَ العذراء في خِدْرها، والاصطباغُ بتلك الرذيلةِ لا يصحُّ صفةً للداعية، ولا يتشرَّفُ بها في سلوكه التطبيقيِّ.
كما أنَّ مِنْ وقائعِ حالِنا أَنْ يتصدَّى للدعوة أفرادٌ بعلمٍ ناقصٍ أو بدونِ علمٍ، بل دون تأهُّلٍ ولا تأهُّبٍ، وبلا زكاةِ نفسٍ وتربيةٍ ولا مُجاهَدةٍ؛ فيَدْعون إلى الإسلام ـ زعموا ـ دعوةً وهُمْ بحاجةٍ إلى دعوةٍ، ومَنْ أُصِيبَ بمثلِ هذه الأمراضِ فهو ظلومٌ جهولٌ يُدْعى إلى الحقِّ ولا يدعو، ويُستصلَحُ ولا يُصْلِح.
هذا، ونسأل اللهَ التوفيقَ والسداد، ومَنْ وُفِّق إلى سلوك الدعوة النبويَّة فقهًا وتأسِّيًا فقَدْ حازَ قسطًا وافرًا مِنْ ميراث النبوَّة، نسأل اللهَ لنا ولكم أَنْ لا يَحْرِمنا منه.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م
(١) أخرجه أحمد (٨٩٥٢)، والبخاريُّ في «الأدب المُفْرَد» رقم: (٢٧٣)، والبزَّار في «مسنده» ـ واللفظُ له ـ (٨٩٤٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١١٢) رقم: (٤٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ في «البِرِّ والصِّلَة والآداب» (٢٥٥٣) مِنْ حديثِ النوَّاس بنِ سَمْعانَ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في مَعالي الأخلاق (٢٠١٨) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٤١٨) رقم: (٧٩١).
(٤) أخرجه أبو داود في «السُّنَّة» بابُ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤٦٨٢)، والترمذيُّ في «الرضاع» بابُ ما جاء في حقِّ المرأةِ على زوجها (١١٦٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حَسَنٌ صحيحٌ، انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٥٧٣) رقم: (٢٨٤).
(٥) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدءُ الوحيِ إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم (٣)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٦٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٦) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (٥/ ٨٦).
(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢/ ٤٥٤).
(٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم (٣٥٦٢)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢٠)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم (٣٥٥٩)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما.
(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم (٣٥٦١)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٣٠)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ الحذر مِنَ الغضب (٦١١٤)، ومسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٦٠٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٢) وفي هذا المعنى بوَّب البخاريُّ (٣/ ٢٣٧) بابَ «ما يجوز مِنَ الغضب والشِّدَّةِ لأمرِ الله».
(١٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المناقب» بابُ صفةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم (٣٥٦٠) وفي «الحدود» بابُ إقامةِ الحدود والانتقامِ لحُرُمات الله (٦٧٨٦)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٣٢٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشروط» بابُ المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٥) أخرجه البخاريُّ في «صفة الصلاة» بابُ رفعِ البصر إلى السماء في الصلاة (٧٥٠) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(١٦) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في حُسْن العِشْرة (٤٧٨٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٩٧) رقم: (٢٠٦٤).
(١٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ الرفقِ في الأمرِ كُلِّه (٦٠٢٤)، ومسلمٌ في «السلام» (٢١٦٥)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٨) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٩٤) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٩) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٩٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٢٠) انظر: «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٣/ ٥٩٥) وما بعدها.
(٢١) الكُنود: كُفْرُ النعمة، يقال: كَنَدَ يَكْنُدُ كُنودًا فهو كَنودٌ. [انظر: «لسان العرب» (٣/ ٣٨١)].
- قرئت 51269 مرة
- Français
- English
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)