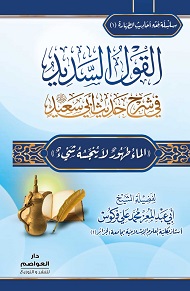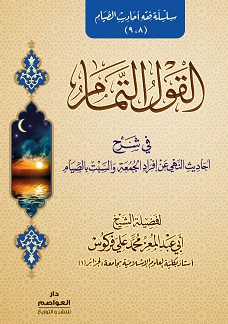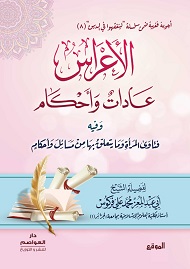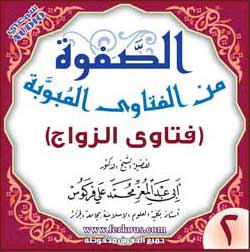- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٥٩٤
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ إنشاء عقد الزواج
في مسئولية الوليِّ في اختيار الكفء لمولِّيته
السؤال:
لقد تقدَّمَ لخِطبةِ أختي رجلٌ مِنَ الذين يحملون عقيدةَ التكفير العامِّ والخروج، فرفضتُ هذا الأمرَ مُطلَقًا، ولكنَّ الأختَ راضيةٌ ومُقْتَنِعةٌ قناعةً تامَّةً به، بحُجَّةِ أنه تاب مِنْ هذه العقيدةِ، ولعلَّ اللهَ يَهدِيه، والوالدةُ كذلك وافقَتْ، وحتَّى العمَّاتُ طَلَبْنَ مِنَ الوالد الموافَقةَ، مع العلم أنَّهنَّ لا يَعْرِفْنَه؛ فاحتارَ الوالدُ في هذا الأمرِ مع أنَّه غيرُ راضٍ، ولكنَّهُ لم يَجِدْ إلى الرفض سبيلًا؛ وهذا الرجلُ لا يَزال يُخالِط بعضَ مَنْ كان معهم في نفس العقيدة، ولا يُجالِسُ أهلَ السُّنَّة ولا يقترب منهم، فنرجو منكم بيانَ ما يلي:
ـ هل يجوز لها ـ إِنْ كانت سُنِّيَّةً سلفيَّةً ـ أَنْ تتزوَّج ممَّنْ هذا حالُه؟
ـ هل للوالد الحقُّ في منعِها مِنْ هذا الزوج؟
ـ كيف يكون تعامُلُنا معه لو تمَّ هذا الزواجُ، مع أنِّي قلتُ لها: إنِّي أعرفُه، ولن أَدخُلَ بيتَه، وتبقَيْن أختي، فلم تُعِرْ لهذا الكلامِ اهتمامًا ولا وزنًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالوَلِيُّ مسئولٌ عن اختيارِ الكُفْءِ لمُوَلِّيَتِه، والكفاءةُ الدِّينيَّةُ مطلوبةٌ شرعًا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ﴾ [الحُجُرات: ١٣]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»(١)، وفي الحديثِ توجيهُ الخطابِ للأولياء كي يُزوِّجوا مُوَلِّيَاتِهِمْ مِنْ ذوي الدِّين والأمانةِ والأخلاقِ، فإِنْ لم يفعلوا كانتِ الفتنةُ والفسادُ الذي لا آخِرَ له، فالمرأةُ يُحتاطُ في حقِّها فيُختارُ لها صاحِبُ الدِّين وحُسْنِ الخُلُق؛ لأنها رقيقةٌ بالنكاح لا مُخَلِّصَ لها، وقد نُقِل عن بعض السَّلف أنَّ «النِّكَاحَ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ»(٢)؛ لأنَّ صاحِبَ الدِّينِ والخُلُقِ إِنْ عاشَرَها عاشَرَها بمعروفٍ وإِنْ سرَّحها سرَّحها بإحسانٍ، ومَنْ زوَّج مُولِّيَتَه مِنْ ظالِمٍ أو فاسقٍ أو مُبتدِعٍ أو شاربِ خمرٍ فقَدْ جَنَى على دِينها بسوءِ الاختيارِ؛ ذلك لأنَّ شرط الكفاءةِ للمرأة الصالحةِ استقامةُ الرَّجل؛ وليس معنَى ذلك أَنْ يُهْمَلَ رأيُ المرأةِ أو يُتعسَّفَ في استشارتها، بل عليه أَنْ يُطْلِعَ كريمَتَه على حالِ الرجل مِنَ الصلاح وعدمِه، ويجوز له ـ إِنْ تَحقَّق مِنْ توبةِ الفاسق بامتحانه ـ أَنْ يزوِّجَها له؛ لأنَّ صفةَ الفِسْق ترتفع عنه بالتوبة النصوح عمَّا اعتقده أو ارتكبه، بشرطِ أَنْ يكون صادقًا في توبته؛ لأنَّ «التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»(٣) على ما جاء في الحديث، و«النَّدَمُ تَوْبَةٌ»(٤)؛ أمَّا المُصِرُّ على ما اعتقده واقترفه فلا يُعانُ على الزواج مِنَ الصالحة، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «إذا كان مُصِرًّا على الفِسق فإنَّه لا ينبغي للوليِّ تزويجُها له، كما قال بعضُ السلف: «مَنْ زوَّج كريمتَه مِنْ فاجرٍ فقَدْ قَطَعَ رَحِمَها»، لكِنْ إِنْ عَلِمَ أنه تاب فتُزَوَّجُ به إذا كان كُفؤًا لها وهي راضيةٌ به»(٥).
أمَّا إذا زوَّجها أبوها مِنْ فاسقٍ أو فاجرٍ أو مُبْتَدِعٍ ورَضِيَتْ به على صِفته وإصراره على المعصية فشأنُهم شأنُ المسلم العاصي الذي يُهْمِل بعضَ الواجبات ويفعل بَعْضَ المحرَّمات التي لا تَصِلُ إلى حدِّ الكفر الأكبر؛ فقَدْ ثَبَتَ أنَّ رجلًا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يشرب الخمرَ، فأُتِي به إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَلَعَنَهُ رجلٌ وقال: «مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ!»، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ ـ مَا عَلِمْتُ ـ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ»(٦).
وعليه، فهؤلاء يستحقُّون الولاءَ مِنْ جهةِ الإيمان والطاعةِ، ويستحقُّون البراءَ مِنْ جهةِ الذنب والمعصية، ولا يَلْزَم مِنَ البراء منهم ـ مِنْ جهةِ المعصية ـ الإساءةُ لهم بالأقوال والأفعال، ولا يمنعه بُغْضُ المعصية وعدَمُ الرضا بها مِنْ أداءِ الحقوق لهم وحُسْنِ المخالَقة معهم ولو كانوا مشركين أو أهلَ الكتاب، قال تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة]، وقال سبحانه في مُعاشَرة الزوجة الكتابيَّة وغيرِ الكتابيَّة: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقال في الأبوين المُشرِكَيْنِ: ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا﴾ [لقمان: ١٥]، وإذا كان هذا في شأنِ أهل الكفر والشرك فإنَّ أهل المعاصي مِنْ أهل الإيمان أحقُّ بالبرِّ والصِّلةِ والإحسان؛ لعُمومِ قوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ٣٦]؛ فبُغْضُ المعصيةِ وعَدَمُ الرضا بالذَّنْب لا ينافي ـ بالضرورة ـ حُسْنَ المعامَلة والمخالَقة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٥ شعبان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٦م
(١) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء: إذا جاءكم مَنْ ترضَوْن دِينَه فزوِّجوه (١٠٨٤)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب الأَكْفاء (١٩٦٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه؛ وأخرجه الترمذيُّ (١٠٨٥) مِنْ حديثِ أبي حاتمٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٨٦٨) وفي «صحيح الجامع» (٢٧٠).
(٢) قال البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧/ ١٣٢): «ويُذكَر عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما أنها قالت: «إنما النكاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أحَدُكم أين يُرِقُّ عتيقتَه». ورُوِي ذلك مرفوعًا، والموقوفُ أصحُّ، واللهُ سبحانه أَعْلَمُ». وقال العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (٣/ ٤٨٨): «رواه أبو عمر التوقانيُّ في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على عائشةَ وأسماءَ ابنتي أبي بكرٍ رضي الله عنهم».
(٣) أخرجه ابنُ ماجه في «الزهد» بابُ ذِكرِ التوبة (٤٢٥٠) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٣/ ٤٧١): «سنده حسنٌ»، وحَسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٠٠٨).
(٤) أخرجه ابنُ ماجه في «الزهد» بابُ ذِكْرِ التوبة (٤٢٥٢) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٣/ ٤٧١)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٥/ ١٩٤)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٠٢).
(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٢/ ٦١).
(٦) أخرجه البخاريُّ في «الحدود» بابُ ما يُكرَهُ مِنْ لعنِ شارب الخمر وأنه ليس بخارجٍ مِنَ الملَّة (٦٧٨٠) مِنْ حديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه.
- قرئت 22241 مرة
- Français
- English
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)