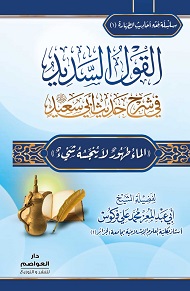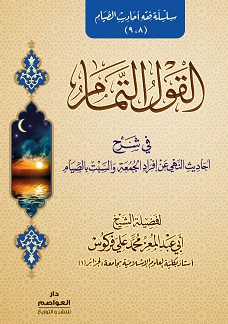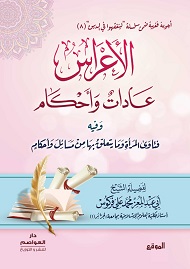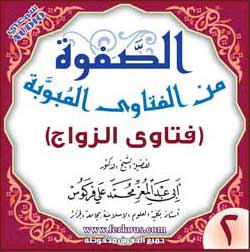الكلمة الشهرية رقم: ٧٣
الدعائم الإيمانية للداعية
«الحلقة الأولى»
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ مَهَمَّة الداعي إلى الله تتطلَّب ـ عمليًّا ـ تجسيدَ دعائمَ إيمانيَّةٍ قويَّةِ البنيان متينةِ الإحكام، قَصْدَ القيام بوظيفته الدعويَّة على الوجه الأكمل والمَرْضيِّ، وهي ـ في الأصل ـ امتدادٌ لوظيفة الرسل والأنبياء، وهذه الدعائم الإيمانيَّة هو بحاجةٍ ماسَّةٍ إليها، وخاصَّةً في الآونة الراهنة، ويمكن حَصْرُها في ثلاثِ دعائمَ إيمانيَّةٍ محوريَّةٍ، تتمثَّل في: فهمِ المنهج الدعويِّ وما يصحبه مِنْ ركيزتين أساسيَّتين أوَّلًا، وفي صدقِ الإيمان الراسخ وما يترتَّب عليه مِنْ ثمراتٍ ولوازمَ ثانيًا، وفي الاعتماد القلبيِّ الموصولِ بالله ثالثًا. وسنتعرَّض لهذه الدعائمِ الثلاث فيما يلي:
الدِّعامة الأولى: فهم المنهج الدعوي.
وأعني بفهم المنهج الدعويِّ: الفهمَ الدقيق للطريق الذي ينتهجه الداعيةُ إلى الله تعالى في سلوكه العمليِّ ودعوته، وهو فهمٌ دقيقٌ قائمٌ على علمٍ بطريق الآخرة، بمعرفةِ أحكامِ الشريعة ومَعانيها ومَراميها ومَقاصِدِها، والوقوفِ عندها تدبُّرًا وتفكُّرًا وإمعانًا وعملًا، ومعرفةِ الخالق الذي يدعو إليه وطريقِ الوصول إليه، وما يحصل عليه المُطيعُ مِنْ وعدٍ وكرامةٍ، ومعرفةِ ما يدعو إليه الشيطانُ وحزبُه والسُّبُلِ المُوصِلةِ إليه، وما يحصل عليه مُطيعُ الشيطانِ مِنْ وعيدٍ وإهانةٍ، وهذه المعرفةُ تُمَكِّن الداعيةَ إلى الله تعالى مِنَ التمييز بين الحقِّ والباطل فيما اخْتَلفَ الناسُ فيه؛ فيرى بها الحقَّ حقًّا والهدى هدًى والباطلَ باطلًا والضلالَ ضلالًا، ويجعل اللهُ سبحانه وتعالى بهذه المعرفةِ نورًا في قلب الداعية وقوَّةً وانشراحًا وتعلُّقًا أَكْثَرَ بالآخرة وعزوفًا أَشَدَّ عن الدنيا(١).
ولا يتحقَّق للداعية إلى الله تعالى التمييزُ بين الحقِّ والباطل لِيَخْلُصَ إلى عقيدةٍ صحيحةٍ يعتمد عليها إلَّا إذا سار وَفْقَ منهجٍ سليمٍ، قائمٍ على صحيح المنقول الثابتِ بالكتاب والسُّنَّة، والآثارِ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مِنْ أئمَّةِ الهدى ومَصابيحِ الدُّجَى الذين سَلَكوا طريقَهم، كما قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(٢)؛ فكان هذا الصراطُ القويم ـ المتمثِّلُ في طلبِ العلم بالمَطالِبِ الإلهيَّة عن طريق الاستدلال بالآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة، والاسترشادِ بفهمِ الصحابة والتابعين ومَنِ الْتزم بمنهجهم مِنَ العلماء ـ مِنْ أعظمِ خصائصِ أهل السُّنَّة والجماعة التي يتميَّزون بها عن أهل الأهواء والفُرْقة، ومِنْ مميِّزاتهم الكبرى في منهاجهم الاستدلاليِّ: عدَمُ مُعارَضتِهم الوحيَ بعقلٍ أو رأيٍ أو قياسٍ، وتقديمُهم النقلَ على العقل، مع أنَّ العقل الصريحَ لا يُعارِضُ النصَّ الصحيحَ بل هو مُوافِقٌ له، ورَفْضُهم التأويلَ الكلاميَّ للنصوص الشرعيَّة بأنواع المجازات، واتِّخاذُهم الكتابَ والسُّنَّة ميزانًا للقبول والرفض، تلك هي أهَمُّ قواعدِ المنهج السلفيِّ وخصائصِه الكبرى التي لم يَتَّصِفْ بها أحَدٌ سواهم؛ ذلك لأنَّ مصدرَ التلقِّي عند مُخالِفيهم مِنْ أهل الأهواء والباطل والبِدَع هو العقلُ الذي أَفْسَدَتْه تُرَّهاتُ الفلاسفة، وخُزَعْبَلاتُ المَناطِقة، وتَمَحُّلاتُ المتكلِّمين؛ فأفرطوا في تحكيم العقل وردِّ النصوص ومُعارَضتِها به، وغيرِ ذلك مِمَّا هو معلومٌ مِنْ مذهب الخلف.
ومِنْ مميِّزات الفهم السليم لهذا المنهجِ الدعويِّ ـ بما تقدَّم مِنِ اعتبارٍ ـ: تحريكُ قلب الداعية وتهييجُه إلى ركوب مَطِيَّته والاستشعارِ بغُرْبةٍ في الدنيا ودُنُوِّ رحيله عنها إلى سفرٍ لا عودةَ له منه، ولا ينفع فيه مِنْ زادٍ إلَّا التقوى؛ قال تعالى: ﴿قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»(٣)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لابنِ عمر رضي الله عنهما: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، [وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ القُبُورِ]»(٤).
وعليه، فإنَّ الفهم السليم يقوم على ركيزتين أساسيَّتين:
¨ الركيزة الأولى: أَنْ يُدْرِك الداعيةُ حقيقةَ وجوده في الحياة والغايةَ منها، وتتجلَّى في تحقيق العبوديَّة لله تعالى وتحصيلِ الغايةِ العُظمى مِنْ خَلْقِ الخَلْق ومِنْ بَعْثِ الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]؛ فيَحْمِلُ الداعيةُ نَفْسَه على الطاعة والدعوةِ إلى الله، وهدايةِ الحيارى إلى أقومِ صراطٍ، وقيادَتِهم إلى الحقِّ، وإخراجِهم مِنَ الظلمات إلى النور، والجهادِ في سبيل الله باليد والمال واللسان والقلم لتكون كلمةُ الله هي العُليا، وعمارةِ الأرض بفعلِ الحسنات والطاعات، وغيرِها مِنَ المَهَامِّ النبيلة التي ينتهض بها الداعيةُ بصحَّةِ القصد وصِدْقِ النيَّة، وغايَتُه في ذلك مَرْضاةُ ربِّه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨﴾ [الحج].
فمَنْصِبُ الداعي إلى الله بين الناسِ ـ بهذا المنظورِ في بُعْدِه الدعويِّ ـ هو الإمامةُ بالحقِّ وهدايةُ الخَلْق، وحملُ الناسِ على إصلاحِ عقيدتهم وعباداتِهم وسلوكهم وأخلاقهم ومُعامَلاتِهم؛ وذلك بالقدوة الصالحة وإرشادِهم إلى أَكْمَلِ حالةٍ، وبأَحْسَنِ وسيلةٍ، ومِنْ أَقْرَبِ طريقٍ؛ «لأنَّ فِعْلَ الخير والاتِّصافَ بالكمال دعوةٌ إليهما بالعمل، وهي أَبْلَغُ مِنَ الدعوة بالقول»(٥).
وفي مُقابِلِ ذلك فإنَّ مِنْ أسوإ المساعي طَلَبَ الإمامةِ لأجل الترؤُّس على الناس والتقدُّمِ عليهم؛ فإنَّ السعي في تحصيله مذمومٌ لأنه مسعى المتكبِّرين لا مِنْ عَمَلِ المتَّقين، بَلْهَ مَنْ يهتبل فُرَصَ الحياةِ ليتمتَّع بمَلَاذِّ الجسد ما وَسِعَه، وليس له مِنْ غايةٍ في الحياة إلَّا إشباع الرغبات والشهواتِ والتمتُّع بالمَلَذَّات، ويأكل كما تأكل الأنعامُ؛ فذلك مُنْتهى أَمَلِه وأقصى غايَتِه ومَبْلَغُ عِلْمِه؛ قال تعالى: ﴿فَأَعۡرِضۡ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكۡرِنَا وَلَمۡ يُرِدۡ إِلَّا ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ٢٩ ذَٰلِكَ مَبۡلَغُهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ [النجم: ٢٩ ـ ٣٠]، وعمارتُهم في الأرض بالبغي والفساد، وعَمَلُهم الدعويُّ الإنكارُ والتشكيك وإثارةُ الشُّبُهاتِ لإخراجِ الناس مِنَ النور إلى الظلمات؛ فمَنْصِبُ الداعيةِ فيهم الإمامةُ بالباطل وتضليلُ الخَلْقِ والسعيُ إلى إفسادهم؛ فهؤلاء هم دُعاةُ النار؛ قال تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾ [البقرة]، وقال ـ أيضًا ـ: ﴿وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ٤١﴾ [القَصص].
¨ الركيزة الثانية: أَنْ يعمل الداعيةُ على تَرْكِ تَعَلُّقه بالحياة الدنيا ومَلَذَّاتِها، ويُفرِّغَ قلبَه مِنْ سمومها ويتجافى عنها لأنها دارُ غرورٍ(٦)، وقد حذَّرنا اللهُ ورسولُه مِنْ خطورة التعلُّق بها والوقوعِ في شَرَكِها؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ٥﴾ [فاطر]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٧).
ويحرص الداعيةُ إلى الله ـ في تحقيقِ غايَتِه ـ أَنْ يجعل قَلْبَه متعلِّقًا بالآخرة ويُقْبِلَ عليها بصدقٍ ويُؤْثِرَها على الدنيا لأنها باقيةٌ، والباقي أحَقُّ بالحرص والعملِ مِنَ الفاني؛ قال تعالى: ﴿وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٧﴾ [الأعلى]، وقال تعالى: ﴿مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖ﴾ [النحل: ٩٦]، والباقي الوفيرُ جديرٌ بالتقديم على القليل الزائل؛ قال تعالى: ﴿قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧﴾ [النساء].
وعلى الداعية إلى الله أَنْ يشعر بالغُرْبة في الدنيا ويُحِسَّ بقُرْبِ رحيله عنها حتَّى يقطع التسويفَ وطولَ الأمل؛ فيَقْصُرُ أملُه في الدنيا ويجعلُها مزرعةَ الآخرة ومطيَّةَ النجاة، وهذه الحقيقةُ اتَّفقَتْ وصايا الأنبياءِ وأتباعِهم على التنبيه عليها؛ قال تعالى عن مؤمنِ آلِ فرعون: ﴿يَٰقَوۡمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا مَتَٰعٞ وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلۡقَرَارِ ٣٩﴾ [غافر]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»(٨)، وعلى الداعية أَنْ يتزوَّد مِنْ دُنْياهُ لآخِرته؛ فإنَّ الإحساس بالغُرْبة أَدْعى له إلى المُبادَرةِ بفعل الصالحات والقيامِ بالطاعات والإكثارِ مِنْ فِعْل الخيرات؛ فلا يُهْمِل ولا يُمْهِل اغتنامًا للدنيا للفوز بالآخرة قبل فوات الأوان؛ لأنه لا يدري متى ينتهي أَجَلُه؛ قال ابنُ عمر رضي الله عنهما: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»(٩)؛ فعلى الداعية أَنْ يجتهد في العمل الصالح ويُكْثِرَ مِنْ وجوه الخير، وفي طليعةِ ذلك الدعوةُ إلى الحقِّ وهدايةُ الخَلْق، مع التجافي عن الدنيا والزهدِ فيها والإعراضِ عن مَشاغِلِها؛ فما أحْوَجَ الداعيةَ إلى الله إلى هذا الفهمِ الدقيق لمنهجه في الحياة والدعوة! فهو لُبُّ العلمِ وغايَتُه، وبه يتميَّز المنهجُ الدعويُّ الذي يسلكه مع إخلاص القصد فيه، وبدونه لا يُعَدُّ العالمُ عالمًا ربَّانيًّا وإِنْ حَفِظَ المتونَ وردَّدها بلسانه، واستوعب شروحَها ومَلَأ بها صَدْرَه، واستحكم الأحكامَ بأصولها وسوَّد بها صحائفَ وأوراقًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
ـ يُتبَع ـ
الجزائر في: أوَّل جمادى الثانية ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ أفريل ٢٠١٢م
(١) انظر: «مَدارِج السالكين» لابن القيِّم (١/ ٤٥٢).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب: لا يشهد على شهادةِ جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ (٢٦٥٢)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٥٣٣)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وله شاهدٌ أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣٤٩) مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما بهذا اللفظ، إلَّا أنه قال ثلاثَ مرَّاتٍ: «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، فأَثْبَتَ القرنَ الرابع. [انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٣١٣)].
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «الزهد» (٢٣٧٧)، وأحمد (٣٧٠٩)، مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الصحيحة» (٤٣٩).
(٤) أخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» بابُ قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» (٦٤١٦) دون الجملة الأخيرة، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في قِصَرِ الأمل (٢٣٣٣)، وابنُ ماجه في «الزهد» بابُ مَثَلِ الدنيا (٤١١٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ بالزيادة لشواهدها في «السلسلة الصحيحة» (١١٥٧).
(٥) «مجالس التذكير» لابن باديس (٢٩٨).
(٦) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيِّم (١/ ١٤٩).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الرقاق» (٢٧٤٢) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه.
(٨) سبق تخريجه، انظر: (ص ١).
(٩) أخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» بابُ قول النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» (٦٤١٦) مِنْ قولِ ابنِ عمر رضي الله عنهما؛ وقد مَضَى مرفوعُ الحديث في الهامش رقم: (٢)، (ص ١).
- قرئت 21069 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)