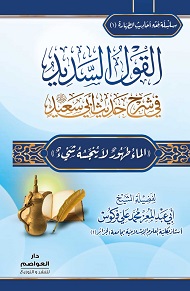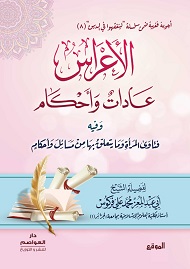- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٣٧٥
الصنف: فتاوى الأصول والقواعد الفقهيَّة ـ القواعد الفقهيَّة
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة
السؤال:
ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء؛ لكِنْ إذا كان الغرضُ مِنَ المقارنةِ هو طَمْأنةَ قلوبِ المؤمنين وتثبيتَهم بإظهارِ الحقِّ وبيانِ زيفِ مَنْ قال مِنْ دُعَاة القوانينِ: إنَّ الشريعةَ مضى زمانُها وفات وقتُها، وهي غيرُ صالحةٍ لكُلِّ زمانٍ ولا مُصلِحةٍ لأحوال النَّاس، إذ لا تُسايِرُ الزَّمانَ ولا تُواكِبُ التَّطوُّرَ، وغيرِها مِنَ المَزاعِم والأباطيل؛ فلا بأسَ ـ حينَئذٍ ـ بالمقارنةِ بينهما وبيانِ وجوه التَّفريقِ بهذا القصدِ المذكور.
هذا، ويُعرَّف القانونُ بأنَّه: «مجموعةُ القواعدِ التي تُنظِّمُ الرَّوابطَ الاجتماعيَّةَ والَّتي تَقسِرُ الدَّولةُ النَّاسَ على اتِّباعِها ولو بالقوَّة عند الاقتضاء»(١)؛ ويُلاحَظ ـ مِنْ خلالِ هذا التَّعريفِ ـ اتِّفاقُ الشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة مع القاعدة القانونيَّة مِنْ حيث اتِّسامُهما بالعمومِ في تنظيم الرَّوابط الاجتماعيَّة واقترانُهما بجزاءٍ؛ إلَّا أنَّ المُرادَ بالقاعدة القانونيَّة: الأحكامُ القانونيَّة الوضعيَّة، وهي بذلك تخالف المعنى الاصطلاحيَّ للشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة، سواءٌ مِنْ حيث مصدرُها، أو مِنْ حيث عمومُها ومرونتُها، أو مِنْ حيث بُعدُها الدِّينيُّ والأخلاقيُّ والجزائيُّ؛ فالقاعدةُ الفقهيَّةُ هي «أصلٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ يجمع في ذاته أحكامًا جزئيَّةً ـ بلا واسطةٍ ـ مِنْ أبوابٍ شتَّى»، ومعنى ذلك: أنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ تجمع شَتاتَ الفروعِ الفقهيَّة المُترامِيَةِ الأطراف، والجزئيَّاتِ المُتناثِرةِ والمُنتشِرة على مُختلفِ نواحي الفصول والأبواب الفقهيَّة في سلكٍ واحدٍ؛ فهي ـ إذن ـ أصولٌ ومبادئُ كُلِّيَّةٌ في نصوصٍ مُوجَزةٍ تتضمَّن أحكامًا تشريعيَّةً عامَّةً في الحوادثِ الَّتي تدخل تحت موضوعِها.
وعليه، فالشَّريعةُ ـ وإِنْ كانت تتَّفِقُ مع القانونِ في أنَّ كِلَيْهما وُضِع لتنظيمِ الجماعةِ ـ ولكنَّ الشَّريعةَ تختلفُ عن القانون في أنَّ قواعدَها دائمةٌ غيرُ قابلةٍ للتَّغيير وللتَّبديلِ، فضلًا عمَّا سبَقَ الإشارةُ إليه مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ:
١ ـ مِنْ حيث المصدر:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ.
أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم.
٢ ـ مِنْ حيث المرونةُ والعمومُ والشُّمول:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها الفقهيَّة ثابتةٌ مُستقِرَّةٌ، تعمل على سدِّ حاجةِ الجماعة وترفع مِنْ مُستواها في كُلِّ عصرٍ، بحيث لا يمكنُ أَنْ تتأخَّر في وقتٍ أو عصرٍ ما عن مستوى الجماعةِ؛ ذلك لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ ونصوصَها تتَّسِمُ بالمُرونةِ والعمومِ بحيث تتَّسِع لتَشمَلَ جميعَ حاجاتِ الجماعةِ نصًّا أو استنباطًا، مهما تطوَّرت الجماعةُ وسَمَتْ، وتعدَّدَتِ الحاجاتُ وطالَتِ الأزمانُ، واتَّسعتِ الأقطارُ والبلدانُ؛ لأنَّها مُستنِدةٌ في وضعِها وتشريعِها إلى العليم القدير.
كما ترمي القاعدةُ الفقهيَّةُ إلى تهذيبِ سلوك الإنسان مع خالِقِه، ومع الأفراد والجماعة، فهي مبنيَّةٌ على الدِّين والأخلاقِ، وهي قاضيةٌ على أفعال العبادِ ـ ظاهرةً وباطنةً كالنِّيات مثلًا ـ.
أمَّا القاعدة القانونيَّة فهي مؤقَّتةٌ لجماعةٍ خاصَّةٍ في عصرٍ معيَّنٍ، وقواعدُها محدودةٌ، فلا تنظِّمُ إلَّا العلاقةَ بين الأفراد وعلاقاتِهم بالمجتمع مِنْ وجهةِ نظرِ جماعةٍ معيَّنةٍ، ونطاقُ حكمِها قاصرٌ على الأعمالِ الظَّاهرةِ فقط دون الباطنةِ، بمعنَى أنَّها تُهمِل المسائلَ الأخلاقيَّةَ والدِّينيَّة، وتتحيَّز إلى فِكرِ واضِعِيها وفارِضِيها مِنَ الأنظمَةِ الغربيَّةِ الَّتي هي نتيجةٌ لثقافةِ تلك الأنظمةِ وظروفها وأعرافها وتاريخها، فما كانت تلك الجماعةُ تعتبره حَسَنًا فَرَضُوه بقانونهم على غيرهم ولو كان هو القُبحَ بعينه وعارضه غيرُهم.
٣ ـ مِنْ حيث الجزاء:
نطاقُ الجزاءِ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةَ بقواعدها الفقهيَّةِ أَوسَعُ مجالًا، لأنَّها مقرونةٌ بجزاءٍ يُوقَعُ على المخالف في الدُّنيا والآخرة مِنَ الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن وليِّ الأمر في الدُّنيا الَّذي عليه أَنْ يُقيمَ الحدَّ أو العقوبةَ أو التَّعزيرَ الَّذي يَلْزَمُه شرعًا؛ بخلاف القاعدة القانونيَّة فهي مقرونةٌ بجزاءٍ دنيويٍّ تُوقِعُه الدَّولةُ فقط لعدمِ شُموليَّتِها للمسائل الدِّينيَّة والأخلاقيَّة على ما تقدَّم؛ إلَّا مِنْ وجهةِ نظرِها الضَّيِّقة وتصوُّرِها المدخول(٣).
هذا، ويجدُرُ التَّنبيهُ إلى أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ هي مِنْ عندِ الله ـ كما تقدَّم ـ وليست مِنْ صُنعِ الجماعةِ، وإنَّما الشَّريعةُ هي مَنْ جعلت الجماعةَ تستقيم على تشريعها، وهذا بخلاف الأصلِ في القانون الوضعيِّ ـ منذ يومِ وجوده ـ فهو نتيجةٌ لتطوُّرِ الجماعة وتَفاعُلِها، فهو مِنْ صُنعِ الجماعةِ لا العكس، إذ تأسيسُ القانونِ في تقنينه إنَّما يكونُ على طابع العُرف والعادة والتَّاريخِ، فكان الفَرَضُ الذِّهنيُّ يقتضي أَنْ يكون القانونُ متأخِّرًا عن الجماعةِ وتابعًا لتطوُّرِها، الأمرُ الذي يجعل الغرضَ مِنَ القانون ـ الموضوعِ في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ـ منقولًا إلى وضعٍ آخَرَ وهو: توجيهُ الجماعة وَفْقَ نظرةِ واضِعِه، لذلك نجد الأنظمةَ الجديدةَ أو كثيرًا منها تستخدم القانونَ لا لتنظيم شؤون الجماعة، ولكِنْ لتنفيذِ أغراضٍ معيَّنةٍ، وتوجيهِ الشعوب وفقَ أهواءِ واضعيها، لا وَفْقَ ما تقتضيه مصلحتُها؛ وإذا تطوَّرَتِ الجماعةُ أو تغيَّرَتْ ظروفُها ظهرَتْ عيوبُ القانونِ ونقائصُه، فلَزِمَ تغييرُ القانونِ أو بعضِ ما لا يتلاءم منه مع مُقتضَيَاتِ ظروف الجماعة الحاليَّة.
هذا، والمقصودُ مِن وضعِ الشَّريعة الإسلاميَّة ـ في جُمْلَتِها ـ ليس قاصرًا على تنظيم شؤون الجماعة فقط، بل يَشمَلُ إقامةَ الجماعةِ الصالحة المُوحِّدةِ وتهذيبَ سلوكِ الإنسان مع خالِقِه محبَّةً وتعظيمًا وعبادةً وتوحيدًا، ومع الأفراد والجماعة سلوكًا وأخلاقًا وآدابًا وحُسْنَ معاملةٍ، وتسعى لإيجاد الدَّولة القائمة على الحقِّ والعدل الَّذي لا يكون كاملًا إلَّا وفق الشَّرع، لذلك جاءت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ومَبادِئُها الكُلِّيَّةُ في قَدْرِها وسُمُوِّها ـ مِنْ وقت نزولها إلى أيَّامِنا ـ أرفعَ مستوًى لا يُضاهيها ما عليه الفلسفاتُ والنَّواميسُ والقوانينُ الوضعيَّةُ ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ فهي صالحةٌ مُصلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ(٤)، لا تفتقر إلى استكمالٍ ولا استدراكٍ؛ لأنَّ الاجتهادَ في استنباطِ أحكام المُستجِدَّاتِ مضبوطٌ بقواعدِ الشَّريعةِ العامَّةِ الَّتي لا يأتيها الباطلُ مِنْ بين يدَيْها ولا مِنْ خلفِها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ
المُــــوافـــــق ﻟ: ٠٩ مايــو ٢٠٢٤م
(١) «أصول القانون» للسنهوري وأبو ستيت (١٣)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٠.
(٢) حريٌّ بالبيانِ ـ في هذا المَقامِ ـ أنَّ الأحكامَ فيها ما هو تعبُّديٌّ [أي غيرُ معقولِ المعنَى] فهذا لا يقبَلُ التَّغييرَ أبدًا لكونِه مبنيًّا على النَّصِّ، والنَّصُّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وفيها قسمٌ مِنَ الأحكامِ معلَّلٌ [أي: معقولُ المعنى]؛ فهو على نوعينِ مِنْ جهةِ العلَّةِ: إمَّا علَّةٌ لا تقبلُ التَّبدُّلَ والتَّغيُّرَ مِثلَ تحريمِ الخمرِ بعلَّةِ الإسكارِ، وتحريمِ القِمارِ بعلَّة الغررِ، فإنَّ العلَّةَ فيها ثابتةٌ لا تتغيَّر، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها، عملًا بقاعِدة: «الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا».
وإمَّا أحكامٌ معلَّلةٌ بعلَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر، وهي الأحكامُ الاجتهاديَّة المبنيَّةُ على المصلحةِ أو على العرفِ أو العادةِ؛ فهذه يتغيَّرُ الحكمُ فيها بتغيُّر عِلَّتِه باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها وينتفي بانتفائِها لدورانه مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا.
وعليه، فالحكمُ إِنْ كانَ نصِّيًّا تعبُّديًّا أو كان معلَّلًّا بعلَّةٍ ثابتةٍ فإنَّه لا يقبلُ التَّغيُّرَ والتَّبدُّلَ قولًا واحدًا، وأمَّا إِنْ كان معلَّلًا بعلَّةٍ متغيِّرةٍ فإنَّه يقبل التَّغيُّرَ تبعًا لها؛ [انظر: «المدخل الفقهي» (القواعد الكُلِّيَّة) للكُردي (٦٢) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّيَّة» للبورنو(٢٥٤)، والفتوى رقم: (914) الموسومة ﺑ «في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابتَ ومتغيِّرات» على موقعي الرسميِّ].
(٣) انظر: «المدخل لدراسة الشَّريعة» لزيدان (٣٩، ٤٤، ٤٦)، «الشَّريعة» لبدران (٧٤، ٧٥، ٧٩)، «التَّشريع والفقه» لقطَّان (٢١، ٢٢).
(٤) انظر الفتوى رقم: (650)، الموسومة بعنوان: «حكم عبارةِ: الشَّريعة صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكان» على الموقع الرَّسمي.
- قرئت 24552 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)