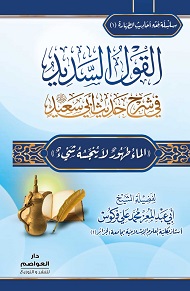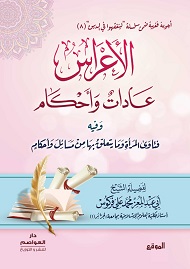- التبويب الفقهي للفتاوى:
ذكرتم ـ حَفِظكم الله ـ في الفتوى رقم: (1354) الموسومة ﺑ «حكم زراعةِ صِمَامِ قلبِ خنزيرٍ في جسم المسلم» بأنه «يجوز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ عند تعذُّر... للمزيد
الفتوى رقم: ١٣٦٣
الصنف: فتاوى طبِّيَّة
في الجواب عن الاعتراض
على جواز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ
السؤال:
ذكرتم ـ حَفِظكم الله ـ في الفتوى رقم: (1354) الموسومة ﺑ «حكم زراعةِ صِمَامِ قلبِ خنزيرٍ في جسم المسلم» بأنه «يجوز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ عند تعذُّر تحقُّقِ الشِّفاءِ بدعوةٍ صادقةٍ أو رُقيةٍ نافعةٍ أو بقوَّةِ للقلبِ وحُسنِ التَّوكُّل إلى غير ذلك مِنَ الأسباب الكثيرة غيرِ الدَّواء، وعند تعذُّرِ وجود البديل مِنَ الدَّواءِ المُباحِ أو ما هو دونه في الحُرمة، أمَّا إذا قُدِر على بديلٍ مِنَ المُباح أو ما هو دونه في الحُرمةِ فإنه لا يُصارُ إلى الأشدِّ حرمةً مع القدرة على البديل، لأنَّ «الضرورةَ تُقدَّرُ بقَدْرِها»»، غير أنَّ ما نصَّ عليه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في شأن التَّداوي: أنه ليس بضرورةٍ، وذكَرَ ـ في ذلك ـ وجوهًا متعدِّدةً أنقلها لكم لأهمِّيَّتِها بطولها وفِقهِها، ومعذرةً.. حيث قال ـ رحمه الله ـ: «... أمَّا إباحتُها للضرورة فحقٌّ، وليس التداوي بضرورةٍ لوجوهٍ: أحَدُها: أنَّ كثيرًا مِنَ المرضى أو أكثرَ المرضى يُشفَوْن بلا تداوٍ لا سيَّما في أهلِ الوبر والقُرى والساكنين في نواحي الأرض، يَشفِيهم اللهُ بما خلَقَ فيهم مِنَ القُوى المطبوعةِ في أبدانهم الرَّافعةِ للمرض وفيما يُيسِّرُه لهم مِنْ نوعِ حركةٍ وعملٍ أو دعوةٍ مستجابةٍ أو رُقيةٍ نافعةٍ أو قوَّةٍ للقلب وحُسنِ التَّوكُّل إلى غيرِ ذلك مِنَ الأسباب الكثيرة غيرِ الدواء؛ وأمَّا الأكلُ فهو ضروريٌّ، ولم يجعل اللهُ أبدانَ الحيوانِ تقوم إلَّا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لَمَاتَ؛ فثبَتَ بهذا أنَّ التَّداوِيَ ليس مِنَ الضرورة في شيءٍ.
وثانيها: أنَّ الأكل عند الضرورة واجبٌ؛ قال مسروقٌ: «مَنِ اضطُرَّ إلى المَيْتة فلم يأكل فمات دخَلَ النَّارَ»؛ والتَّداوي غيرُ واجبٍ؛ ومَنْ نازع فيه خصَمَتْه السُّنَّةُ في المرأة السوداء التي خيَّرها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين الصبر على البلاء ودخولِ الجنَّة وبين الدُّعاء بالعافية، فاختارت البلاءَ والجَنَّة؛ ولو كان رفعُ المرضِ واجبًا لم يكن للتخيير موضعٌ كدفعِ الجوع؛ وفي دعائه لأُبَيٍّ بالحُمَّى، وفي اختياره الحُمَّى لأهل قُباءٍ، وفي دعائه بفَناءِ أُمَّتِه بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار مِنَ الطاعون؛ وخصَمَه حالُ أنبياءِ الله المُبتَلَيْن الصابرين على البلاء حين لم يتعاطَوُا الأسبابَ الدافعةَ له: مثل أيُّوبَ عليه السلامُ وغيرِه؛ وخصَمَه حالُ السَّلفِ الصَّالح: فإنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه حين قالوا له: «ألَا ندعو لك الطبيبَ؟» قال: «قد رآني» قالوا: «فما قال لك؟» قال: «إِنِّي فعَّالٌ لِمَا أُريدُ»؛ ومثلُ هذا ونحوُه يُروى عن الربيع بنِ خُثَيْمٍ المُخبِت المُنيب الذي هو أفضلُ الكوفيِّين أو كأفضلِهم، وعمرَ بنِ عبد العزيز الخليفةِ الراشد الهادي المهديِّ وخَلْقٍ كثيرٍ لا يُحصَوْن عددًا؛ ولستُ أَعلَمُ سالفًا أَوجبَ التَّداويَ، وإنما كان كثيرٌ مِنْ أهل الفضل والمعرفة يُفضِّلُ تَرْكَه تفضُّلًا واختيارًا لِمَا اختارَ اللهُ ورضًى به وتسليمًا له؛ وهذا المنصوصُ عن أحمدَ، وإِنْ كان مِنْ أصحابه مَنْ يُوجِبُه ومنهم مَنْ يَستحِبُّه ويرجِّحُه كطريقةِ كثيرٍ مِنَ السلف، استمساكًا لِمَا خلَقَه اللهُ مِنَ الأسباب وجعَلَه مِنْ سُنَّتِه في عِبادِه.
وثالثُها: أنَّ الدواء لا يُستيقَنُ، بل وفي كثيرٍ مِنَ الأمراض لا يُظَنُّ دفعُه للمرض؛ إذ لو اطَّرَد ذلك لم يَمُتْ أحَدٌ، بخلافِ دفعِ الطَّعام للمسغبة والمجاعة فإنه مُستيقَنٌ بحكمِ سُنَّةِ الله في عباده وخلقِه.
ورابعُها: أنَّ المرض يكون له أدويةٌ شتَّى، فإذا لم يندفع بالمحرَّم انتقل إلى المحلَّل؛ ومُحالٌ أَنْ لا يكون له في الحلال شِفاءٌ أو دواءٌ؛ والذي أَنزلَ الداءَ أَنزلَ لكُلِّ داءٍ دواءً إلَّا الموت، ولا يجوز أَنْ يكون أدويةُ الأدواءِ في القسم المحرَّم وهو سبحانه الرءوفُ الرحيمُ؛ وإلى هذا الإشارةُ بالحديث المرويِّ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا»(١)؛ بخلافِ المَسغَبة فإنها وإِنِ اندفعَتْ بأيِّ طعامٍ اتَّفَق إلَّا أنَّ الخبيثَ إنما يُباحُ عند فقدِ غيرِه، فإِنْ صوَّرْتَ مِثلَ هذا في الدَّواء فتلك صورةٌ نادرةٌ؛ لأنَّ المرض أندرُ مِنَ الجوع بكثيرٍ، وتَعيُّنُ الدَّواءِ المُعيَّنِ وعدمُ غيرِه نادرٌ فلا ينتقض هذا؛ على أنَّ في الأوجُهِ السالفة غنًى.
وخامسُها: وفيه فقهُ الباب: أنَّ الله تعالى جعَلَ خَلْقَه مُفتقِرِين إلى الطعام، والغذاءُ لا تندفع مجاعتُهم ومَسغَبتُهم إلَّا بنوعِ الطعام وصنفِه، فقَدْ هدانا وعلَّمَنا النوعَ الكاشفَ للمَسغَبةِ المُزِيلَ للمَخمَصة؛ وأمَّا المرض فإنه يُزيلُه بأنواعٍ كثيرةٍ مِنَ الأسباب ـ ظاهرةٍ وباطنةٍ، روحانيَّةٍ وجسمانيَّةٍ ـ، فلم يتعيَّنِ الدواءُ مُزيلًا؛ ثمَّ الدواء بنوعه لم يتعيَّنْ لنوعٍ مِنْ أنواع الأجسام في إزالةِ الدَّاء المعيَّن، ثمَّ ذلك النوعُ المعيَّن يخفى على أكثر الناس بل على عامَّتِهم دركُه ومعرفتُه، الخاصَّة المُزاوِلون منهم هذا الفنَّ أُولُو الأفهامِ والعقولِ يكون الرَّجلُ منهم قد أفنى كثيرًا مِنْ عُمره في معرفته ذلك ثمَّ يخفى عليه نوعُ المرضِ وحقيقتُه ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه؛ ففارقت الأسبابُ المُزيلةُ للمرضِ الأسبابَ المُزيلةَ للمَخمَصة في هذه الحقائقِ البيِّنةِ وغيرِها، فكذلك افترقت أحكامُها كما ذكَرْنا.
وبهذا ظهَرَ الجوابُ عن الأقيسة المذكورة، والقولُ الجامعُ فيها [كذا، ولعلَّ الصواب: فيما] يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضَرَني الآنَ: ..وأيضًا فإنَّ تَرْكَ المأمورِ به أيسرُ مِنْ فعل المنهيِّ عنه؛ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٢)؛ فانظُرْ كيف أَوجبَ الاجتنابَ عن كُلِّ منهيٍّ عنه، وفرَّق في المأمور به بين المستطاعِ وغيرِه؛ وهذا يكاد يكون دليلًا مُستقِلًّا في المسألة..»، ثُمَّ فصَّل ـ رحمه الله ـ الجوابَ في وجوهٍ سِتَّةٍ عن كُلِّ ما يُعارَض به في هذه المسألة، وختمَ ذلك بقوله: «ولولا أنِّي كتبتُ هذا مِنْ حفظي لَاسْتقصَيْتُ القولَ على وجهٍ يحيط بما دقَّ وجلَّ؛ واللهُ الهادي إلى سواء السبيل»(٣).
فما رأيُكم ـ حَفِظكم الله ـ في هذه الفتوى الماتعةِ لشيخ الإسلام ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ وهي على غيرِ ما رجَّحتم في جواز التداوي بالخنزير للضرورة؟
أفيدونا أَحسنَ اللهُ إليكم، وكتَبَ أجرَكم، وأعلى قَدْرَكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن الجوابُ ـ باختصارٍ ـ عمَّا علَّل به ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ مِنْ أنَّ التداويَ ليس بضرورةٍ مِنْ أجلِ حصولِ التَّعافي لكثيرٍ مِنَ المرضى دون تَداوٍ، بل بما جعَلَ اللهُ فيهم مِنْ قوَّةٍ طبيعيَّةٍ مُقاوِمةٍ للمرض أو حركةٍ كرياضةٍ وجهدٍ طارحٍ للأخلاط الفاسدة والسمومِ مِنَ الجسم، وعملٍ صالحٍ كصدقةٍ أو دعوةٍ مستجابةٍ أو رُقيةٍ نافعةٍ أو حُسنِ توكُّلٍ، فلا خلافَ بين العلماء في أنَّ الأكلَ ضروريٌّ في باب الأطعمة، وهو الأصلُ المقيسُ عليه وهو متَّفَقٌ عليه بين المتنازعَيْن، فلا داعيَ لاستظهاره للعلم به، لكنَّ المعنيَّ بالفتوى والاختلافِ فيها هو الفرع المَقيسُ وهو التَّداوي في باب الطِّبِّ؛ والنَّظر في إمكانيَّةِ إلحاقِ الضرورةِ فيه بالأصل المَقيسِ عليه بجامعِ حفظ النفس والبدن مِنَ الأذى والضرر والهلاك، علمًا أنَّ ما ذكَرَه ـ رحمه الله ـ في الوجهِ الأوَّلِ إنَّما هو خاصٌّ بفئةٍ مِنَ المرضى أودعَ اللهُ فيهم قوَّةً لمقاومةِ المَرضِ يُشفَوْن بلا تداوٍ، وحَصانةً في أجسامِهم تجعلها غيرَ قابلةٍ لمرضٍ مِنَ الأمراضِ المعتادة، ومتانةً في بُنيَتِهم بما خلَقَ اللهُ فيهم مِنَ القُوى المطبوعة في أبدانهم الرافعةِ للمَرض وهو قريبٌ ممَّا يُعرَف في الطبِّ الحديثِ بالمناعة الطَّبيعيَّة، أو بالأسباب الكثيرة غيرِ الدواء مِنَ الحركة والرياضةِ الطارحةِ للسُّموم مِنَ البدن، أو العملِ الصالح كالصَّدَقة أو الدعاءِ أو الرُّقية وقوَّةِ التَّوكُّل وحُسنِ الظنِّ بالله، وهؤلاء ـ في أكثر الأحوالِ ـ لم يبلغوا حدَّ المَهلَكةِ بدون التَّداوي، وإِنْ حصلت لهم لم يتعذَّرْ تحقُّقُ الشِّفاءِ لأخذِهم بالوسائل المُباحة الأخرى للتداوي بها ونجاعتِها فيهم غالبًا؛ فالتداوي بالدواء ـ إذن ـ سبيلٌ واحدٌ مِنْ جملة السُّبُل لتحقيق الأمنِ الصِّحِّيِّ، لِمَا فيه مِنْ تخفيفٍ للآلامِ وعلاجٍ للأسقامِ، ودفعٍ للمضارِّ وجلبٍ للمنافعِ، فإِنْ كان الأمنُ الصِّحِّيُّ يحقِّقُ الغايةَ المرجوَّةَ لعامَّةِ المرضى وأصحابِ العِلَل والبلايا بالمناعةِ الطبيعيَّةِ فلا حاجةَ لهم في الأخذِ بأسبابِ التَّداوي سواءٌ كان بالمُباح أو بالمحرَّم، أو كان لضرورةٍ أو بدونها.
لكِنْ لا يَلزَمُ مِنْ تحقُّقِ الأمنِ الصِّحِّيِّ أو الشِّفاء لهذه الفئةِ القليلةِ في الأمَّةِ غالبًا أَنْ يتحقَّقَ ذلك لهم دائمًا في كُلِّ مرضٍ، فكثيرًا ما يتخلَّفُ الشِّفاءُ عنهم أو يتأخَّر رغمَ أخذِهم بالأسباب الأخرى كما يتخلَّف عن غيرهم ممَّنْ أخذ بالتَّداوي؛ ولا يَلْزَمُ ـ أيضًا ـ أَنْ يحصلَ الأمنُ الصِّحِّيُّ لأكثرِ الأمَّةِ ممَّنْ ليست لهم تلك القُوى المطبوعةُ في أبدانهم ولا القوَّةُ الإيمانيَّة التي يُرجى معها الشِّفاءُ مِنْ دعاءٍ مُستجابٍ ورُقيةٍ نافعةٍ وقوَّةِ قلبٍ وحُسنِ توكُّلٍ وغيرِها مِنَ الأسباب، وهؤلاء ـ وهُم أكثرُ الأُمَّة عددًا ـ قد يَبلغُ بهم تفاقُمُ المرضِ ونزولُ الضَّررِ وحصولُ الآلامِ والأوجاعِ إلى حدِّ التَّهلكةِ؛ وتراهم يتشبَّثونَ بكُلِّ سببٍ علاجيٍّ قد يُعيدُ العافيةَ والسَّلامةَ لأبدانِهم.
وعليه، فإنَّ ظاهرَ كلامِ ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ خاصٌّ بالفئةِ الأُولى وهي الأقلُّ عددًا مقارنةً بالفئةِ الغالبةِ التي ليس لها مِنْ سبيلٍ لقِوامِ بدنِها واستردادِ صِحَّتِها وإبعادِ الخطرِ عن نفسِها إلَّا هذه الوسائل الضروريَّة المُتاحةُ، لا سيَّما أنَّ كلامَه رحمه الله ـ في الجملةِ ـ لا يَصدُقُ على كُلِّ الأمراض، وخاصةً مع كثرةِ الأمراضِ المختلفةِ والمُستعصيةِ والأوبئةِ الحادثةِ في زماننا بسببِ الأغذيةِ الصناعيَّةِ المُركَّبة والمعلَّبةِ والكيماويَّة وغيرها ممَّا لا تَقبلُ المعالجةَ بالأدويةِ البسيطةِ ولا بالعقاقيرِ الطبيعيَّة، والتي يحتاج فيها المريضُ إلى نوعٍ مِنَ العلاجاتِ المسكِّنة والأدويةِ المركَّزةِ، وإلَّا تَفاقمَ أمرُه وأفضى به إلى خطرِ الموتِ أو الهلاكِ حتمًا، فضلًا عمَّا قد يخدش في صبره مِنَ التَّسخُّط والجزع.
• هذا، وأمَّا كلامُ مسروقٍ ـ رحمه الله ـ فإنَّ الضَّرورةَ فيه محمولةٌ على ضرورةِ الأكلِ للمخمصة المتَّفَقِ عليها، ولا تتعلَّق بضرورةِ التَّداوي ولا تَنفيهِ ـ أيضًا ـ، لأنَّ التَّداويَ ـ في الجملةِ ـ ليس بواجبٍ ولو بالمُباحِ وهو مذهبُ السَّلفِ وأكثرِ العلماءِ؛ فكيف بالحرامِ؟! سواءٌ اضطُرَّ إليه فلم يُعرَف دواءٌ غيرُه أو لم يُقدَر عليه، أم لم يُضطَرَّ إليه؛ وقد بيَّن ابنُ عبدِ البَرِّ ـ رحمه الله ـ حالَ بعضِ السلف مع التداوي وحُكْمَه عند جمهورِ الفُقهاءِ بقولهِ: «قد كان مِنْ خيارِ هذه الأمَّةِ وسَلَفِها وعُلَمائِها قومٌ يصبرون على الأمراض حتَّى يكشفها اللهُ، ومعهم الأطبَّاءُ، فلم يُعابوا بترك المعالجة؛ ولو كانت المعالجةُ سُنَّةً مِنَ السُّنَنِ الواجبةِ لكان الذمُّ قد لَحِقَ مَنْ ترَكَ الاسترقاءَ والتداويَ، وهذا لا نعلم أحدًا قالَهُ؛ ولكان أهلُ البادية والمواضعِ النائية عن الأطبَّاءِ قد دخَلَ عليهم النَّقصُ في دِينهم لِتركِهم ذلك؛ وإنَّما التَّداوي ـ واللهُ أعلمُ ـ إباحةٌ على ما قدَّمْنا، لميلِ النفوس إليه وسكونِها نحوَه، و﴿لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨﴾ [الرعد]، لا أنه سُنَّةٌ ولا أنه واجبٌ، ولا أنَّ العلم بذلك علمٌ موثوقٌ به لا يُخالَف، بل هو خَطَرٌ(٤) وتجربةٌ موقوفةٌ على القَدَر؛ واللهُ نسأله العصمةَ والتوفيقَ؛ وعلى إباحةِ التَّداوي والاسترقاءِ جمهورُ العلماء»(٥)؛ وقال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال؛ وتنازعوا: هل الأفضلُ فعلُه، أو تركُه على طريق التَّوكُّل؟»(٦)؛ وإِنْ كان الذي أعتقده راجحًا في حكم مسألة التَّداوي يعود تقريرُه إلى دركِ حجم الضَّررِ المترتِّب عن تركِ التَّداوي وإفضائه إلى الهلاك أوَّلًا، وإلى نفعِ الدَّواءِ ونجوعهِ وظهورِ أثرهِ ثانيًا، وإلى مقدارِ الدَّواء الناجعِ المُعطى للمريضِ ومعدَّلِ نجاحِه ثالثًا، وإلى القدرة على بديلٍ له رابعًا، وهذه الحالات يختلفُ حكمُها باختلاف حال المريضِ ومدى ملاءمتها له، تحقيقًا للأمن الصِّحِّيِّ المتمثِّل في دفع المَضارِّ وجلبِ المنافع، وتخفيفِ الآلام والأوجاع، وعلاجِ العِلَل والأسقام، لذلك كان حكمُ التَّداوي ـ في حدِّ ذاته ـ تعتريه الأحكامُ الخمسة مِنْ: إباحةٍ، واستحبابٍ، ووجوبٍ، وحرمةٍ، وكراهةٍ.
• وأمَّا استدلالُ ابنِ تيميةَ رحمه الله ـ على عدمِ وجوب التَّداوي ـ بحديث المرأة السَّوداء فلا يخفى أنَّ حكم التَّداوي للصَّرعِ الذي كان يسبِّب لها حرجًا ولا يُخشى مع مثله الهلاكُ غالبًا إنَّما يدخل في ضمن حيِّزِ التداوي في الأحوال العادية الذي يصدُقُ عليها استدلاله؛ دون شموله للأحوال الضرورية، التي هي محلُّ النِّزاع.
والمعلومُ أنَّ رعايةَ المصلحةِ في محلِّ الضرورةِ تتضمَّن حِفظَ مقصودٍ مِنَ المقاصد الخمسة مِنْ حفظ الدِّين، والنفس، والعقل، والنَّسَب (النَّسل)، والمال؛ فكما أنه يتحقَّق حفظُ مصلحةِ النفس في باب الأكل فإنَّه يتحقَّق ـ أيضًا ـ في باب التَّداوي، إذ لا تَلازُمَ بين الضَّرورةِ وبين أحكامِ الشَّرعِ بما فيها حكم الوجوبِ أو التَّحريم، ذلك لأنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ الاضطراريَّةَ استثنائيَّةٌ وليست أصليَّةً، فالضَّرورةُ لا تَرفعُ التَّحريمَ والخَبَثَ مُطلَقًا، وإنَّما غايتُها رَفعُ الحرجِ دون اقتضاءِ إيجابٍ أو عدمِه بمجرَّد ذلك؛ واستَوى في ذلك الأَكلُ والتَّداوي إلَّا لدليلٍ خارجيٍّ.
• أمَّا التعليلات الأخرى مثل قوله ـ رحمه الله ـ: «وثالثها: أنَّ الدَّواءَ لا يُستيقَنُ، بل وفي كثيرٍ مِنَ الأمراض لا يُظَنُّ دفعُه للمرض»(٧).
فأقولُ وباللهِ التَّوفيقُ والتَّسديدُ:
لعلَّ عدمَ استيقانِ نجاعةِ الدَّواءِ في دفعِ المرضِ إنَّما كان ذلك في عصرِ المتقدِّمين والمتأخِّرين حيث تشتبه بعضُ الأمراض بسببِ تَشابُهِ الأعراض إذا لم يستقصِ الطبيبُ البحثَ عنها، وأمَّا الاستشفاءُ الحاليُّ والعمليَّاتُ الجِراحيَّةُ المعاصرةُ فلا يَشرَعُ المريضُ في التَّداوي والعِلاجِ والجراحةِ إلَّا بعد فحصٍ معمَّقٍ وتشخيصٍ دقيقٍ ودراسةِ حالة المريضِ وما عنده مِنْ حساسيةٍ لبعض المركَّبات أو أمراضٍ أخرى تمنع تَلَقِّيَ بعضِ الأدوية وَفقَ معاييرَ طبِّيَّةٍ مُرفَقةٍ بجملةٍ مِنْ شروط الملاءَمة وحزمةٍ مِنَ التَّحاليل والأشعَّةِ وغيرِها ممَّا تمكِّن الطَّبيبَ المعالجَ مِنْ تشخيصِ المرض بدِقَّةٍ عاليةٍ وتمييزِه ممَّا قد يشتبه به في الأعراض، فضلًا عن اختيارِ الدواء المناسبِ الأكثرِ نجاعةً للحالة المَرَضِيَّةِ غالبًا، لا سيَّما في الأمراض والحالات المعهودة، فيحصل الشِّفاءُ ـ بإذن الله ـ يقينًا أو غالبًا، بل بعض الأدوية المركَّبة مِنْ شحمِ الخنزير ثبَتَ نجاعتُها يقينًا كالأنسولين لِمَرضى السُّكَّرِي وزارعة الشَّرايين والكُلى وغيرهما.
علمًا أنَّه لو سُلِّم أنَّ الدَّواءَ قد يخفى ولا يظهر، أو لا يُستيقَنُ في نوعٍ مِنَ الأمراض أو لا يَعلَمُ كثيرٌ مِنَ الأطبَّاءِ علاجًا لها، فلا يعني ذلك خفاءَ ذلك في كُلِّ الأمراضِ بأنواعها وعدمَ استيقانِ جميعِ حالاتها على كُلِّ طبيبٍ، لأنَّ الطبيبَ المختصَّ ـ مثلًا ـ إذا تيقَّن بأنَّ في شيءٍ مِنَ الحرام شفاءً للمريضِ المضطَّرِ أو علاجًا له مِنْ جهةٍ، ولم يُعلَم ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لا عنده ولا عند غيره مِنَ الأطبَّاء الذين يُمكنه التواصلُ معهم دواؤُه أو علاجُه مِنَ الحلال الذي يُغنيه عن الحرام لتلك الحالة، تَعيَّن ـ والحالُ هذه ـ علاجُه به، وتُيُقِّنَ تحسُّنُ حالِه به، كالذي تَعيَّن في حالته أنه لا ينفعه أخذُ دواءِ السُّكَّريِّ إلَّا بالأنسولين الذي تدخله أجزاءُ الخنزير بالنظر إلى عدمِ وجودِ البديل المُباح النافعِ في حالته وإِنْ نفَعَ غيرَه؛ وكانت تلك مصلحةً تَرْجَحُ على مفسدةِ أكلِ ما فيه أجزاءُ الخنزير وتأثيرِه على طباعِ آكله، فيكون أَشبَهَ بأكلِه اضطرارًا للمَخمَصة؛ فإذا كان عدمُ أخذِ مريضِ السُّكَّريِّ لدواء الأنسولين يُفضي إلى هلاكِه يقينًا، وأخذُه يخفض نسبةَ السُّكَّرِ عنده يقينًا، ولا يقتدر على علاجه بغيره في الوضع الحاليِّ يقينًا؛ فخالفت هذه الحالةُ وأمثالُهَا الحكمَ الأصليَّ الذي ذكَرَه ابنُ تيميَّة.
• وأمَّا قوله ـ رحمه الله ـ في التعليل الرابع: «أنَّ المرضَ يكون له أدويةٌ شتَّى، فإذا لم يندفع بالمحرَّم انتقل إلى المحلَّل؛ ومُحالٌ أَنْ لا يكون له في الحلال شِفاءٌ أو دواءٌ؛ والذي أَنزلَ الداءَ أَنزلَ لكُلِّ داءٍ دواءً إلَّا الموت، ولا يجوز أَنْ يكون أدويةُ الأدواءِ في القسم المحرَّم وهو سبحانه الرءوفُ الرحيمُ..».
فجوابه:
أنَّ ما ذكَرَه ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في هذا التعليلَ إنَّما هو تقريرٌ لِمَا جاء في الحديث مِنْ حيث المبدأ العامُّ مِنْ أنَّ لكُلِّ داءٍ دواءً في الحلال الجائز، لكِنْ قد يستشكل أمرُه مِنْ جهةِ تفاصيلِ حِلِّيَّةِ الدَّواءِ الملائمِ للدَّاء:
ـ هل هو ـ في حدِّ ذاته وفي نجاعته وظهورِ أثره ومعدَّلِ نجاحه ـ معلومٌ عند أهل الاختصاص في الطِّبِّ، ومقدورٌ عليه أم لا؟
ـ فضلًا عن أنَّ الأدلَّةَ المسوقةَ للاستدلالِ إنَّما هي محمولةٌ على الأحوالِ العاديَّةِ دون حالةِ الاضطرارِ إلى المحرَّم، ولا يخفى ـ كما تقدَّم في الفتوى ـ أنَّ المريضَ لا يكون مُضطرًّا إلى شيءٍ مِنَ الدواء المحرَّمِ إذا كان قادرًا على الاستشفاءِ بالدواء الحلال المُباح، وهذا خارجٌ ـ بالتأكيد ـ عن محلِّ النِّزاعِ.
فبناءً على هذا المعنى، يمكن أَنْ يقال: إنه ـ كما أنَّ الله لم يجعل شفاءَنا فيما حرَّم علينا ـ لم يجعل طعامَنا ولا شرابَنا ـ أيضًا ـ فيما حرَّم علينا، فإذا كُنَّا نستثني مِنْ هذا ما اضطُرِرْنا إليه حالَ العجز عن غيره في الطعام والشراب للمَخمَصة والغُلَّةِ [العطش] للضرورة، فكذلك ينبغي أَنْ لا يَخرِمَ التداوي بالحرام عند الاضطرار إليه أنَّه سبحانه لم يجعل شفاءَنا وتَداوِيَنا فيما حرَّم علينا.
وإضافةً إلى ما تقدَّم، فإِنْ قُدِّر ـ فرَضًا ـ أنَّ للمريضِ أدويةً شتَّى مِنَ الحلال ـ وهو كذلك كما هو الواقع ـ فإنَّه لا يعني أنها معلومةُ النَّفعِ ومقدورٌ عليها وظاهرةُ التأثيرِ له ولغيرهِ، فإنَّه كما لا يَلزَمُ مِنْ أَنْ تنفعَ الأدويةُ الموصوفةُ للمريضِ الفلانيِّ مِنَ الحلالِ حالَمَا جرَّبَها في حالته: أَنْ تنفع ـ في المقابل ـ غيرَه مِنَ المرضى، لأنَّ العلاجَ عمومًا مِنْ جملة الأسباب الكونيَّةِ المخلوقة، لا يَستقِلُّ سببٌ بنفسه في إحداثِ شيءٍ أو تحقُّقِ مُسبَّبه إلَّا بانضمامِ سببٍ آخَرَ، فالشفاءُ متوقِّفٌ بعد التداوي على تحقيقِ شرطه وانتفاءِ موانعه، ومِنْ جملة الشروطِ قبولُ المحلِّ، فمثلُ الرُّقيةِ أو التَّوكُّلِ أو الصَّدَقة أو الأدوية الطبيعيَّةِ ونحوِها التي أشار إليها ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ، فإنَّ العلاجَ بها يتوقَّفُ على مصادفةِ محلٍّ قابلٍ للشِّفاءِ بشرطهِ مع انتفاء الموانعِ التي تحول دون تحقُّقه، هذا مِنْ جهةٍ.
ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الأحاديثَ العامَّةَ الواردةَ في نفي الشِّفاءِ فيما حرَّمه اللهُ ورسولُه متضمِّنةٌ لشفاء الغليل بالشَّرابِ، وشفاءِ الجوعِ بالطَّعامِ، وشفاءِ النفس بموافقة الغرض والهوى، ومع ذلك يدخل الاستثناءُ في الغُلَّة والمخمصة بل وفي إساغة الغُصَّة بالاضطرار وبقدرِ الضرورة دون مجاوزةٍ لمَحَلِّها كسائرِ ما يُضطَرُّ إليه العبدُ، وقد اتَّفق العلماءُ على إباحةِ شُربِ الخمر ـ وهي محرَّمةُ العين ـ لدفعِ غُصَّةٍ، ومثلُه إباحةُ أكلِ المَيْتة ـ وهي محرَّمةُ العين أيضًا ـ في حال المخمصَةِ، طلبًا للسلامة ودفعًا للضرر في كِلتَا الصورتين، حيث يكون دفعُ الهلاكِ بأخذها محقَّقًا ويُمنَع مِنْ أحدهما حيث لا يندفع الهلاكُ، قال عبدُ الرَّحمن بنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «فأمَّا شُربُها [أي الخمر] لدفعِ الغُصَّةِ فيجوز، كما يجوز أكلُ المَيْتة في حال المخمصة، ولا نعلم في ذلك خلافًا»(٨)؛ وقال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «وكذلك الخمرُ يباحُ لدفعِ الغُصَّةِ بالاتِّفاق، ويُباحُ لدفعِ العطش في أحد قولَيِ العلماء؛ ومَنْ لم يُبِحْها قال: إنَّها لا تدفع العطشَ؛ وهذا مأخذُ أحمد؛ فحينَئذٍ فالأمرُ موقوفٌ على دفع العطش بها؛ فإِنْ عُلِم أنها تدفعه أُبِيحَتْ بلا ريبٍ كما يُباحُ لحمُ الخنزير لدفعِ المجاعة؛ وضرورةُ العطشِ الذي يرى أنه يُهلِكُه أعظمُ مِنْ ضرورة الجوع؛ ولهذا يُباحُ شُربُ النجاسات عند العطش بلا نزاعٍ؛ فإِنِ اندفع العطشُ وإلَّا فلا إباحةَ في شيءٍ مِنْ ذلك»(٩)؛ ومعنى ذلك: أنَّ الإنسانَ إذا غصَّ بلقمةٍ في حلقه ولم يسَعْه بلعُها ولا إخراجُها إلَّا بشُرب الخمر المحرَّمة، وكان خروجُها به محقَّقًا أو راجحًا، فيجوز له شربُها بقَدْرِ ما تندفِعُ به غُصَّتُه المُفضِيةُ إلى التهلُكةِ، مع أنَّ دَفْعَ الغُصَّة ليس مِنَ المَخمَصة والمَسغَبة ولا دفعِ الغُلَّة ولا هو في معناهما.
وعليه، يتبيَّن أنه لا فَرْقَ في الضرورة بين الأكلِ مِنَ المَيْتة والشُّربِ مِنَ المحرَّم كالبول وما في معناهما في المخمصة والغُلَّة للضرورة، وبين ما كان لغير ذلك كدفع الغُصَّة بالخمر؛ فإنه وإِنْ أُجمِعَ عليه فليس مِنْ باب الضرورة للمخمصة، بل هو مِنَ العلاج وإِنْ لم يكن لمرضٍ فلِضَررٍ يُفضي إلى هَلَكةٍ.
ولا شكَّ أنَّ كُلَّ هذه الصُّوَرِ المذكورة إنما تجوز عملًا بقاعدةِ: «جوازِ ارتكابِ أخفِّ الضررين وأهونِ الشَّرَّيْن لإذهابِ أشدِّهما»، أو «دفعِ أشدِّ المفسدتين بأخفِّهما».
• وأمَّا قوله ـ رحمه الله ـ: «..إنَّ تَرْكَ المأمورِ به أيسرُ مِنْ فعل المنهيِّ عنه؛ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ؛ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ فانظُرْ كيف أَوجبَ الاجتنابَ عن كُلِّ منهيٍّ عنه، وفرَّق في المأمور به بين المستطاعِ وغيرِه؛ وهذا يكاد يكون دليلًا مُستقِلًّا في المسألة».
فجوابه: أنَّ الحديثَ المسوقَ للاحتجاج به على أنَّ الأمرَ مِنَ المقدور يكون امتثالُه بالمستطاع، والنهيَ يكون امتثالُه باجتناب كُلِّ المحظور عنه جملةً؛ فليس ذلك على إطلاقِهِ في النهيِ؛ لأنَّ النهيَ أشدُّ مِنَ الأمر، فيُترخَّص في الأمر حيث لا يُترخَّص لمِثله في النهي، وإِنْ كان يُترخَّصُ للنهيِ في حالٍ أشدَّ منه، وإلَّا فإنَّه «لا واجِبَ مع عجزٍ، ولا محرَّمَ مع اضطرارٍ»، لأنَّ صيغةَ النهيِ ظاهرةٌ في التحريم، وأدنى مراتِبِها الكراهةُ، ولم تَرِدْ صيغةُ النهيِ للإباحة، بخلافِ صيغة الأمرِ، فافترقا، ويمتنعُ قياسُ أحدِهمَا على الآخَرِ؛ كما أنَّ النهيَ يقتضي دوامَ الترك واختُلِف في الأمر: هل يقتضي التَّكرارَ؟، فناسب ذلك أَنْ يكون تركُ المنهيِّ جملةً، وأَنْ يكون فعلُ المأمورِ بما يُستطاعُ منه؛ ولأنَّ النهيَ يدلُّ على دفعِ المفاسدِ أو رفعها، والأمرَ يدلُّ على جلبِ المصالح أو تكميلها، واعتناءُ الشارعِ بدفعِ المفاسدِ أكبرُ مِنِ اعتنائه بجلبِ المصالح، فتبيَّن أنَّ كونَ النَّهيِ للتَّحريمِ مقدَّمٌ على كونِ الأمر للوجوب، فيُقدَّم على غيره مِنَ الأحكام الأخرى مِنَ: النَّدب، والكراهة، والإباحة مِنْ بابٍ أَوْلى؛ ولأنَّه قد يَرِدُ النَّهيُ باجتنابِ المحظورِ ـ أيضًا ـ.
لكِنْ يُستثنى مِنَ المحرَّم لذاته ما يدخلُ في باب الاضطرارِ كما هو الحال في المَسغَبة والمَخمَصة والمُكرَهِ ونحوِ ذلك لِتَعلُّقه بالمقاصدِ؛ وتُراعى مراتبُ المحرَّماتِ مِنْ حيث الشِّدَّةُ وعدمُ القدرةِ على ما دونها خِفَّةً مِثل الدواء والعلاج بالاستعمال الخارجيِّ فإنه ـ غالبًا ـ ما يكون مِنَ المحرَّم لغيره فيُباحُ مِنْ باب الحاجةِ لِتَعلُّقه بالوسائلِ، كاتِّخاذِ أنفٍ مِنْ ذهبٍ، ولُبسِ الحرير للحكَّةِ والجَرَب، أو نظرِ الطبيبِ إلى عورة المريض أو لمسِها قَصْدَ المعالجة، أو تَعالُجِ المرأةِ وتكشُّفِها عند طبيبٍ رجلٍ حالَ عدمِ القدرة على طبيبةٍ بصيرةٍ بحالتها وما إلى ذلك، بخلافِ الجراحة والأكلِ والاستعمال الداخليِّ عمومًا، فمَناطُ التَّداوي بالمحرَّمِ بهذه الطريقِ عند تعذُّرِ البديلِ المبيحِ إنَّما هو الضرورةُ بشرطِها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ نـوفمبر ٢٠٢٣م
(١) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم موقوفًا على ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه في «الأشربة» (١٠/ ٧٨) بابُ شرابِ الحلواء والعسل؛ وقال الزُّهريُّ: لا يَحِلُّ شُربُ بولِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تنزل لأنه رجسٌ؛ قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المائدة: ٤، ٥]، وقال ابنُ مسعودٍ في السَّكَر: إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم، وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ٧٩)، و«تغليق التعليق» (٥/ ٢٩) كلاهما لابن حجر، و«السِّلسلة الصَّحيحة» للألباني (٤/ ١٧٥).
وأخرجه ابنُ حِبَّان في «صحيحه» (١٣٩١) والبيهقيُّ في «سُنَنه الكبرى» (١٩٦٧٩) مرفوعًا مِنْ حديثِ أمِّ المؤمنين أمِّ سَلَمةَ هند بنتِ أبي أُمَيَّةَ المخزوميَّةِ رضي الله عنها قالت: اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ: «إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا»، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ». قال الألبانيُّ في «التعليقات الحِسان» (١٣٨٨): «حسنٌ لغيره».
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» باب الاقتداء بسُنَنِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢١/ ٥٦٣ ـ ٥٦٦، ٥٧٢).
(٤) الخطَرَ ـ محرَّكة ـ أي: حظٌّ ونصيبٌ؛ [انظر: «تاج العروس» للزَّبيدي (١١/ ٢٠٣) مادَّة (خطر)، والمراد: أنَّ أمر التداوي إنما هو مرهونٌ بالقَدَر بما فيه مِنْ توفيقٍ وعكسِه].
(٥) «التمهيد» لابن عبد البَرِّ (٥/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).
(٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٤/ ٢٧٥).
(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢١/ ٥٦٥).
(٨) «الشرح الكبير على المقنع» لأبي الفرج بنِ قدامة (١٠/ ٣٣٠).
(٩) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٤/ ٤٧١).
- قرئت 32418 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)