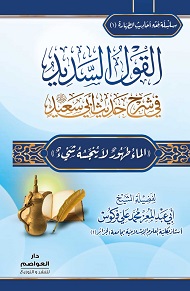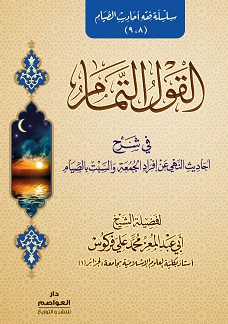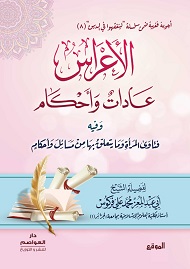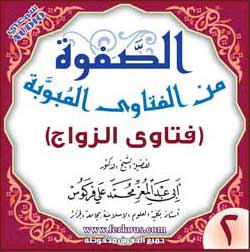الكلمةُ الشَّهريةُ رقمُ: ١٥٨

[الحلقةُ الحاديةَ والعشرونَ]
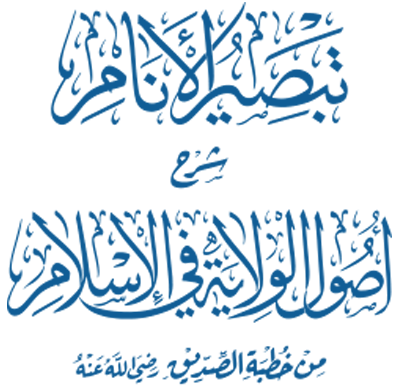
[الجزءُ العاشِرُ]
قالَ الشَّيخُ عبدُ الحَميدِ بنُ بَاديسَ ـ رحمهُ اللهُ ـ:
«الأصلُ العاشر
[إقامة العدل والإنصاف بين الناس]
النَّاسُ كُلُّهُمْ ـ أَمَامَ القَانُونِ(١) ـ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوِيِّهِمْ وَضَعِيفِهِمْ؛ فَيُطَبَّقُ عَلَى القَوِيِّ دُونَ رَهْبَةٍ لِقُوَّتِهِ، وَعَلَى الضَّعِيفِ دُونَ رِقَّةٍ لِضَعْفِهِ(٢).
الأصلُ الحادِي عَشَرَ
[صَوْنُ حُقُوقِ الأَفْرَادِ وَالجماعاتِ]
صَوْنُ الحُقُوقِ: حُقُوقِ الأَفْرَادِ وَحُقُوقِ الجَمَاعَاتِ؛ فَلَا يَضِيعُ حَقُّ ضَعِيفٍ لِضَعْفِهِ، وَلَا يَذْهَبُ قَوِيٌّ بِحَقِّ أَحَدٍ لِقُوَّتِهِ عَلَيْهِ(٣)».
ـ يُتبَع ـ
(١) تقدَّم معنى «القانون» ومفهومُهُ الذي عناه المُصنِّفُ ـ رحمه الله ـ في الأصلِ السَّابِقِ مع التَّنبيهِ على حظرِ إطلاقِ هذا الاسمِ على التَّشريعِ الإسلاميِّ.
(٢) لا يخفى أنَّ الأُمَّةَ تحتاجُ إلى روابطَ يقومُ عليها تجمُّعُها، ومبادئَ تحدِّدُ علاقاتِها، وتحفظُ حقوقَ أفرادِها؛ لأنَّ الاجتماعَ الإنسانيَّ ضروريٌّ، ولا يتمُّ المُحافظةُ عليه إلَّا بنظامٍ يَحكمُ سُلُوكَ الأُمَّةِ ويُنظِّمُ شُؤونَهَا، وضوابطَ تُقِيمُ هذه العلائقَ على العدلِ والإنصافِ والمُساواةِ.
والالتزامُ التامُّ بالعدلِ والإنصافِ في إدارةِ شؤونِ النَّاسِ، وعدمُ الحَيدَةِ عنه هو ما تقدَّمَ بيانُهُ مَظهَرًا مِنْ مَظاهِرِ سياسةِ الدُّنيا بالدِّينِ؛ لأنَّ الإنسانَ جُبِلَ على الأَثَرَةِ وحُبِّ الذَّاتِ، وانْطَوَتْ نفسُهُ على غرائزَ عديدةٍ ومختلفَةٍ تحتاجُ إلى تقويمٍ وتهذيبٍ حتَّى لا يَطغَى ويَؤُولَ أَمرُ الأُمَّةِ ـ بسببِ هذا الطُّغيانِ ـ إلى الفوضى والاضطرابِ، فلا بُدَّ ـ إذن ـ مِن إقامةِ العدلِ بين النَّاسِ ـ الذي هو أساسُ نظامِ الحُكمِ الإسلاميِّ وغايتُهُ المَقصودَةُ ـ وإنصافُهُم إنَّما يكون بتنفيذِ حُكمِ اللهِ حَتَّى يستقيمَ بِهِ حَالُ الرَّعيَّةِ، فيُطبَّقُ على الشَّديدِ دونَ خوفٍ لقُوَّتِهِ ولا خشيةٍ لِمَكانتِهِ، كما يُنفَّذُ الحُكمُ على الضَّعيفِ دون رِقَّةٍ لضَعفِهِ، وبذلك تَنتظِمُ أُمورُ الولايةِ والسُّلطانِ؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥﴾ [النساء]، إذ «لا ثباتَ لدَولةٍ لا يتنَاصفُ أهلُها ويغلِبُ جَورُها على عَدلِهَا»؛ [«تسهيل النَّظر» للماوردي (١٨٢)]، ولهذا كانت صِفةُ العدلِ والإنصافِ المَبنيَّةُ على شرعِ اللهِ أساسِيَّةً في صِيغةِ البَيعةِ للإمامِ، وهي: «بَايَعْنَاكَ بَيْعَةَ رِضًى على إقامَةِ العَدْلِ والإنصافِ والقِيامِ بفروضِ الإمامةِ»؛ [«الأحكام السُّلطانيَّة» لأبي يعلى (٢٥)].
فالعدلُ ـ إذن ـ يتطلَّب التَّسويَةَ بين النَّاسِ بتنفيذِ شرعِ اللهِ عليهم على قَدَمِ المُساوَاةِ قيامًا بالقسط لله لا فَرْقَ بين قَوِيٍّ وضعيفٍ أو شريفٍ وَوضيعٍ، فكلُّ النَّاسِ خاضعون لشرع الله سواءٌ في المُعاملَةِ والقضاءِ والحقوقِ ومِلكيَّاتِ الأموالِ وفي شؤونِ المَسؤوليَّةِ، وحتَّى بين الرَّجلِ والمَرأةِ فقد سَاوَى الإسلامُ بينهما في الحُدودِ والعُقوباتِ وأَنصفَ بينهُما، ويَدُلُّ على ذلك ما سبق في قِصَّةِ المَخزُوميَّةِ مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: «وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَقَالُوا: «وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»؛ [مُتَّفَقٌ عليه: سبق تخريجه، في «الأصل السَّابع»]، فقد أبطلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم محاولاتِ التَّمييزِ بين النَّاسِ بالمحاباةِ والهوى والعاطفةِ أمامَ القضاءِ والشَّريعَةِ، وذَمَّ صَنِيعَ مَنْ يَشفَعُ لِمُجرمٍ في حدودِ اللهِ قَصْدَ إسقاطِ الحدِّ عنه، وأخبرَ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّ المُحاباةَ في عدمِ تنفيذِ العُقوباتِ ودَرْءِ الحدود والتَّمييزَ بين الشَّريف والوضيعِ والقويِّ والضَّعيفِ سببٌ لهلاكِ الأُمَّةِ.
والحكمُ بالقسط والمُساواةِ بين النَّاسِ أمامَ سُلطَةِ الشَّرعِ في المَجالات السَّابقةِ هي التِي عناها أبو بكرٍ رضي الله عنه بقوله: «إِنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ الحَقَّ لَهُ، وَأَضْعَفَكُمْ عِنْدِي القَوِيُّ حَتَّى آخُذَ الحَقَّ مِنْهُ»؛ [تقدَّم تخريجه، انظر: الجزء الأول]، ويتجلَّى هذا المعنى ـ أيضًا ـ في رسالةِ عمرَ بنِ الخَطَّابِ المَشهورةِ إلى أبي مُوسى الأَشعَرِيِّ رضي الله عنهما حين وَلَّاهُ القضاءَ حيث قال رضي الله عنه: «آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ»؛ [أخرجه الدَّارقطنيُّ في «سُنَنِهِ» (٥/ ٣٦٩)، والبيهقيُّ في «السُّنَنِ الكُبرى» (١٠/ ٢٥٢)، وصَحَّحهُ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٢٦١٩)]، والمراد ﺑ: «آسِ بَيْنَ النَّاسِ» أي: سوِّ بينهم واجعل كلَّ واحدٍ منهم إسوةَ خصمِهِ؛ [انظر: «النِّهاية» لابن الأثير (١/ ٥٠)، «لسان العرب» لابن منظور (١٤/ ٣٥)].
(٣) يندرجُ صَوْنُ حقوقِ الأفرادِ والجماعاتِ والحفاظُ عليها في بابِ إقامة العدلِ والإنصافِ بين النَّاس، وهو داخلٌ في سياسةِ الدُّنيا بالدِّينِ، عِلمًا أنَّ الحقوقَ إنَّما تُصانُ بتنفيذِ الحُكمِ الشَّرعيِّ للفصلِ بين المُتشاجرين، وقطعِ الخصومةِ بين المُتنازعين: إمَّا بصلحٍ عن تراضٍ، أو بإجبارٍ على حكمٍ نافذٍ قائمٍ على العدلِ، بحيث لا يُترَكُ الظَّالمُ على التَّعدِّي ولا يُقَرُّ القويُّ على الظُّلم فيذهبَ بحقِّ غيرِه لقُوَّتِهِ وتَعدِّيهِ وسَطوتِهِ عليه، ولا يُمنَعُ الضَّعيفُ المَظلومُ مِنَ الإنصافِ والاستيفاءِ ورفعِ المَظلَمةِ فيَضِيعَ حَقُّهُ لضَعفِهِ، وفي هذا المعنى قال ابن تيميَّة ـ رحمه الله ـ [في «الجواب الصحيح» (٢/ ١٠٦)]: «وَلَوْ وَجَبَ لِبَعضِ الرَّعِيَّةِ حقٌّ على بعضٍ أو ظلَمَ بعضُهم بعضًا لَوجب على المَلِك أَنْ يُنصِفَ المظلومَ، ويُرسِلَ إلى الظَّالمِ مَن يأمرُهُ بالعدلِ وَالإنصافِ، وَيُعاقِبهُ إذا لم يُنصِفْ إذا كان الظَّالمُ مُتمَكِّنًا مِنْ مَعرِفةِ أَمرِ المَلِك بالتَّرجمةِ أو غيرها، وهذا هو العدلُ، لَيسَ العدلُ أَنْ يُتركَ النَّاس ظالمين في حقِّ الله وحقِّ عبادِهِ، وَاللهُ تعالى أَرسلَ رُسُلَهُ وأَنزلَ كُتُبَهُ لِيقومَ النَّاسُ بالقِسطِ كَمَا قال تعالَى: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ﴾ [الحديد: ٢٥]».
وللحدِّ مِنَ العُدوانِ والظُّلمِ على حقوقِ النَّاسِ وأموالِهِمْ ومُمتلَكاتِهم وغيرِها شرَعَ اللهُ تعالى على النَّاسِ الحُدودَ الشَّرعيَّةَ، وأقامَهَا بينهم لتُصانَ محارمُ اللهِ تعالى عن الانتهاك، وتُحفظَ حقوقُ النَّاسِ مِنَ الإتلافِ والإهلاكِ، فيُنصَرُ المَظلومُ، ويُقمَعُ الظَّالِمُ عن التَّعدِّي، ويُعطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ دون ظلمٍ ولا بخسٍ ولا هضمٍ.
والمَعلومُ أنَّ إحقاقَ الحقِّ وإبطالَ الباطلِ بتنفيذِ الحُكمِ الشَّرعيِّ إنَّما هو مِنْ مَهامِّ القاضِي، يتولَّاه نيابةً عن الإمامِ الأعظمِ بعد تحاكمِ المُتنازعَيْنِ أو أحدِهما إليه؛ لأنَّ القضاءَ وسيلةٌ إلى الحقِّ، وحقُّ الإنسانِ لا يُستوفَى إلَّا بطَلبه.
هذا، ولم يَقتصِرِ الشَّرعُ على الأمرِ بالعدلِ والإنصافِ مِنْ جهةِ المُطالبةِ بإعطاءِ كُلِّ ذِي حقٍّ حَقَّهُ، بل حَرَّمَ ما يُقابِلُهُ وهو جِهة الظُّلمِ، وأمر بالأخذِ على يَدِ الظَّالمِ وكَفِّهِ عنِ الاعتداءِ والطُّغيانِ بالوسائلِ الرَّدعيَّةِ، إذ لا يخفَى أَنَّ الظُّلمَ طريقُ خرابِ المَدَنِيَّاتِ، وسببُ زوالِ المُلكِ، وأدلَّةُ تحريمِهِ أكثرُ مِنْ أَنْ تُضبَطَ أو تُحصَى، وضِمْنَ هذا المعنى قال ابنُ خلدون ـ رحمه الله ـ [في «تاريخه» (١/ ٣٥٥)]: «ولا تحسبنَّ الظُّلمَ إنَّما هو أخذُ المَالِ أو المِلكِ مِنْ يَدِ مالكِهِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ ولا سَبَبٍ كما هو المَشهورُ، بلِ الظُّلمُ أَعَمُّ مِنْ ذلك، وكلُّ مَنْ أَخَذَ مِلكَ أَحَدٍ أو غَصَبَهُ في عملِهِ أو طَالَبَهُ بغيرِ حَقٍّ، أو فَرَضَ عليهِ حَقًّا لم يَفرِضْهُ الشَّرعُ فقد ظَلَمَهُ، فَجُبَاةُ الأموالِ بغيرِ حَقِّها ظَلَمَةٌ، والمُعتدونَ عليها ظَلَمَةٌ، والمُنتهِبونَ لها ظَلَمَةٌ، والمَانعون لحقوقِ النَّاسِ ظَلَمَةٌ، وغُصَّابُ الأملاكِ على العموم ظَلَمَةٌ، ووَبَالُ ذلك كُلِّهُ عائدٌ على الدَّوْلَةِ بخرابِ العُمرانِ الذي هو مادَّتُها، لإذهابِهِ الآمالَ مِنْ أهلِهِ، واعلَمْ أنَّ هذه هي الحِكمةُ المَقصودَةُ للشَّارعِ في تحريمِ الظُّلمِ، وهو ما ينشأُ عنه مِنْ فسادِ العُمرانِ وخَرابِهِ، وذلك مُؤْذِنٌ بانقطاعِ النَّوعِ البَشَريِّ، وهي الحكمةُ العَامَّةُ المُراعيَةُ للشَّرعِ في جميعِ مقاصدِهِ الضَّروريَّةِ الخمسةِ مِنْ حفظِ الدِّينِ والنَّفْسِ والعقلِ والنَّسلِ والمَالِ؛ فلمَّا كان الظُّلمُ ـ كما رأيتَ ـ مُؤْذِنًا بانقطاعِ النَّوعِ لِمَا أَدَّى إليه مِنْ تخريبِ العُمرانِ، كانت حِكمةُ الحَظْرِ فيه موجودةً، فكان تحريمُه مُهمًّا، وأدلَّتُهُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ كثيرٌ؛ أكثرَ مِنْ أَنْ يَأخذَهَا قانونُ الضَّبطِ والحَصْرِ».
- قرئت 18486 مرة
 نسخة للطباعة
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق
| الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)